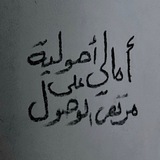قال ابن عاصم:
مع كونه لم يأت في الأحكام*فيُطلبَ البيان في الإعلام.
ألا ترى ما قال في الأبِّ عُمر*وما به في عدم البحث اعتذر.
فحكم ذا للراسخين يُعتبر*منزَّلا منزل أبٍّ لعمر.
والقول في الآية باشتمال*معْ ذا على تشابه الإجمال.
مرتَكَبٌ صعب ومما يَلزم*عليه أن يَقِلَّ فيه المحكم.
في هذه الأبيات يستدرك الناظم على القسمة الأصولية -التي نقلها في أول الأبيات- وهي تقسيم التشابه إلى حقيقي وعارض باستدراكين:
الأول: أن التشابه الحقيقي لا يقع في الأحكام، يقصد أحكام الحلال والحرام، ولكن قد يعرض لها صفة اشتباه بسبب عموم مخصوص أوإجمال أونسخ أواشتراك ونحوه، لكن هذا الاشتباه ليس عارضا من أصل الشريعة؛ لأن الشريعة وضحت المخصص، وبينت المجمل، وأظهرت الناسخ، (وإنما عرض لتقصير في البحث، أو زيع عن طريق البيان اتباعا للهوى) -كما قال الشاطبي- ثم يستدل الناظم على أن التشابه الحقيقي لا يقع في الأحكام بقصة عمر: وهي قصة رواها ابن أبي شيبة والحاكم وابن جرير الطبري والاسماعيلي في مستخرجه على البخاري -بأسانيد صححها ابن كثير وابن حجر- وكلهم رووها من طريق أنس أن عمر -رضي الله عنه- قرأ على المنبر: {فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا}، ثم قال: (كل هذا قد عرفناه، فما الأب؟ ثم رفع عصا كانت في يده، فقال: هذا لعمر الله هو التكلف، فما عليك أن لا تدري ما الأب، اتبعوا ما بين لكم من هذا الكتاب فاعملوا به، وما لم تعرفوه فكلوه إلى ربه)، ووجه استدلال الناظم بها: أن عمر اعتذر عن البحث عن معنى (الأب) بقوله: (هذا لعمر الله هو التكلف، فما عليك أن لا تدري ما الأب)، فعده من التكلف؛ لأنه علم لا يثمر عملا، ولا يخفى بجهله معنى الآية، ويكفي فيه الإيمان بأنه من القرآن وأنه من عند الله وأن يوكل علمه إلى الله، فعلمنا من هذا -بطريق المفهوم- أن ما يضر جهله لتوقف العمل على معرفته -وهو الأحكام التكليفية- أنه لا عذر في ترك البحث عن معناه، وهذا يقتضي أن له معنى، وهذا يدل على أن التشابه الحقيقي لا يقع فيه.
الثاني: أن آية المحكم والمتشابه لا يدخل فيها التشابه العارض وهو تشابه الإجمال، وهذا يعني أن المتشابه العارض -أو تشابه الإجمال كما عبر الناظم- لا يختص الله بمعرفته بل قد يعرفه الراسخون، ولا يمدح من اكتفى بتفويض علمه لله جل وعلا، ولا يذم من تتبع معناه وبحث فيه، ويستدل الناظم على ذلك: بأن التشابه العارض يقع كثيرا للناظر في كتاب الله، فلو كان داخلا في التشابه المذكور في الآية للزم من ذلك أن يكون المتشابه في القرآن أكثر من المحكم، وأن يكون أكثر القرآن مما اختص الله بعلمه، وأن الراسخون في العلم لا يعلمون أكثره، وهذا (مرتكب صعب)؛ لأن الله أخبرنا أن أصل الكتاب ومعظمه هو المحكم، وأمرنا بتدبره، وأخبرنا أنه شفاء لما في الصدور، وأنه هدى ورحمة للمؤمنين، وهذا كله لا يكون إلا إذا كان أكثره متضح غير متشابه، هذا هو مقصود الناظم فيما يظهر، وبالله التوفيق.
مع كونه لم يأت في الأحكام*فيُطلبَ البيان في الإعلام.
ألا ترى ما قال في الأبِّ عُمر*وما به في عدم البحث اعتذر.
فحكم ذا للراسخين يُعتبر*منزَّلا منزل أبٍّ لعمر.
والقول في الآية باشتمال*معْ ذا على تشابه الإجمال.
مرتَكَبٌ صعب ومما يَلزم*عليه أن يَقِلَّ فيه المحكم.
في هذه الأبيات يستدرك الناظم على القسمة الأصولية -التي نقلها في أول الأبيات- وهي تقسيم التشابه إلى حقيقي وعارض باستدراكين:
الأول: أن التشابه الحقيقي لا يقع في الأحكام، يقصد أحكام الحلال والحرام، ولكن قد يعرض لها صفة اشتباه بسبب عموم مخصوص أوإجمال أونسخ أواشتراك ونحوه، لكن هذا الاشتباه ليس عارضا من أصل الشريعة؛ لأن الشريعة وضحت المخصص، وبينت المجمل، وأظهرت الناسخ، (وإنما عرض لتقصير في البحث، أو زيع عن طريق البيان اتباعا للهوى) -كما قال الشاطبي- ثم يستدل الناظم على أن التشابه الحقيقي لا يقع في الأحكام بقصة عمر: وهي قصة رواها ابن أبي شيبة والحاكم وابن جرير الطبري والاسماعيلي في مستخرجه على البخاري -بأسانيد صححها ابن كثير وابن حجر- وكلهم رووها من طريق أنس أن عمر -رضي الله عنه- قرأ على المنبر: {فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا}، ثم قال: (كل هذا قد عرفناه، فما الأب؟ ثم رفع عصا كانت في يده، فقال: هذا لعمر الله هو التكلف، فما عليك أن لا تدري ما الأب، اتبعوا ما بين لكم من هذا الكتاب فاعملوا به، وما لم تعرفوه فكلوه إلى ربه)، ووجه استدلال الناظم بها: أن عمر اعتذر عن البحث عن معنى (الأب) بقوله: (هذا لعمر الله هو التكلف، فما عليك أن لا تدري ما الأب)، فعده من التكلف؛ لأنه علم لا يثمر عملا، ولا يخفى بجهله معنى الآية، ويكفي فيه الإيمان بأنه من القرآن وأنه من عند الله وأن يوكل علمه إلى الله، فعلمنا من هذا -بطريق المفهوم- أن ما يضر جهله لتوقف العمل على معرفته -وهو الأحكام التكليفية- أنه لا عذر في ترك البحث عن معناه، وهذا يقتضي أن له معنى، وهذا يدل على أن التشابه الحقيقي لا يقع فيه.
الثاني: أن آية المحكم والمتشابه لا يدخل فيها التشابه العارض وهو تشابه الإجمال، وهذا يعني أن المتشابه العارض -أو تشابه الإجمال كما عبر الناظم- لا يختص الله بمعرفته بل قد يعرفه الراسخون، ولا يمدح من اكتفى بتفويض علمه لله جل وعلا، ولا يذم من تتبع معناه وبحث فيه، ويستدل الناظم على ذلك: بأن التشابه العارض يقع كثيرا للناظر في كتاب الله، فلو كان داخلا في التشابه المذكور في الآية للزم من ذلك أن يكون المتشابه في القرآن أكثر من المحكم، وأن يكون أكثر القرآن مما اختص الله بعلمه، وأن الراسخون في العلم لا يعلمون أكثره، وهذا (مرتكب صعب)؛ لأن الله أخبرنا أن أصل الكتاب ومعظمه هو المحكم، وأمرنا بتدبره، وأخبرنا أنه شفاء لما في الصدور، وأنه هدى ورحمة للمؤمنين، وهذا كله لا يكون إلا إذا كان أكثره متضح غير متشابه، هذا هو مقصود الناظم فيما يظهر، وبالله التوفيق.
قال ابن عاصم:
(فصل في المبين والمجمل والظاهر والمؤول)
يذكر المصنف هنا: المبين، والمجمل، والظاهر، والمؤول، وقد ذكر في الفصل السابق: المحكم، والمتشابه، وسيذكر لاحقا: العام، والخاص، والمطلق، والمقيد، والأمر، والنهي، والنسخ، فما هي حقيقة هذه الأسماء؟ ولماذا ذكرت بعد الدليل الأول وهو الكتاب؟
هذه الأسماء -وإن شئت قل الأحكام- هي صفات تعرض للألفاظ، فاللفظ قد يكون عاما يشمل أفرادا لا حصر لها، وقد يكون مجملا لا يفيد معنى بعينه، وقد يكون متشابها، أو محكما، أو خاصا، أو أمرا، أو نهيا، أو غيرها من عوارض الألفاظ، فهي إذن صفات يوصف بها اللفظ، وإن شئت قل يحكم بها على اللفظ، فيحكم بأن هذا خاصا، وذاك مطلقا، وقد اصطلح أهل الأصول على تسميتها بعوارض الألفاظ، كأنهم أخذوها من معنى العارض في اللغة، وإن كان بعض المتكلمين يرجع هذا الاصطلاح إلى تقسيم من تقاسيم المنطق الأرسطي.
وأما ذكرها بعد الدليل الأول فقد يعتقد الناظر لأول وهلة أنه غريب؛ لأن المشهور من طريقة الناظم أنه يتابع ابن جزي أو الشاطبي، والناظم هنا خالفهما جميعا، ولا يخالفهما في الغالب إلا لمعنى يريده، فإن الشاطبي جعل الكلام على عوارض الألفاظ في مقدمات الكلام على الأدلة، وابن جزي جعلها في المقدمات اللغوية التي في أول الكتاب، والناظم هنا لم يجعلها في المقدمات اللغوية، ولم يذكرها قبل الأدلة، وفي ظني أن الناظم ذكرها هنا استطرادا، فإنه لما ذكر الكتاب وذكر أنه منه محكم ومتشابه، وهما من عوارض الألفاظ، فناسب أن يكمل بقية العوارض؛ كأنه رأى أنها تناسب التسلسل الذهني لمن يحفظ هذه المنظومة، فإن حافظ المنظومة لما عرف أن من الكتاب محكم ومتشابه كان من المناسب أن يعرف أنه منه عام وخاص، ومطلق ومقيد، وأمر ونهي، ومجمل ومبين، وهكذا، وهذا أجود للطالب من طريقة ابن جزي ومن طريقة الشاطبي، وأجود من طريقة الآمدي ومن معه ممن أخرها بعد الكتاب والسنة والإجماع، وعلى كلٍ فإن المهم هو معرفة أنها تختص بالكتاب والسنة دون بقية الأدلة، وبالله التوفيق.
(فصل في المبين والمجمل والظاهر والمؤول)
يذكر المصنف هنا: المبين، والمجمل، والظاهر، والمؤول، وقد ذكر في الفصل السابق: المحكم، والمتشابه، وسيذكر لاحقا: العام، والخاص، والمطلق، والمقيد، والأمر، والنهي، والنسخ، فما هي حقيقة هذه الأسماء؟ ولماذا ذكرت بعد الدليل الأول وهو الكتاب؟
هذه الأسماء -وإن شئت قل الأحكام- هي صفات تعرض للألفاظ، فاللفظ قد يكون عاما يشمل أفرادا لا حصر لها، وقد يكون مجملا لا يفيد معنى بعينه، وقد يكون متشابها، أو محكما، أو خاصا، أو أمرا، أو نهيا، أو غيرها من عوارض الألفاظ، فهي إذن صفات يوصف بها اللفظ، وإن شئت قل يحكم بها على اللفظ، فيحكم بأن هذا خاصا، وذاك مطلقا، وقد اصطلح أهل الأصول على تسميتها بعوارض الألفاظ، كأنهم أخذوها من معنى العارض في اللغة، وإن كان بعض المتكلمين يرجع هذا الاصطلاح إلى تقسيم من تقاسيم المنطق الأرسطي.
وأما ذكرها بعد الدليل الأول فقد يعتقد الناظر لأول وهلة أنه غريب؛ لأن المشهور من طريقة الناظم أنه يتابع ابن جزي أو الشاطبي، والناظم هنا خالفهما جميعا، ولا يخالفهما في الغالب إلا لمعنى يريده، فإن الشاطبي جعل الكلام على عوارض الألفاظ في مقدمات الكلام على الأدلة، وابن جزي جعلها في المقدمات اللغوية التي في أول الكتاب، والناظم هنا لم يجعلها في المقدمات اللغوية، ولم يذكرها قبل الأدلة، وفي ظني أن الناظم ذكرها هنا استطرادا، فإنه لما ذكر الكتاب وذكر أنه منه محكم ومتشابه، وهما من عوارض الألفاظ، فناسب أن يكمل بقية العوارض؛ كأنه رأى أنها تناسب التسلسل الذهني لمن يحفظ هذه المنظومة، فإن حافظ المنظومة لما عرف أن من الكتاب محكم ومتشابه كان من المناسب أن يعرف أنه منه عام وخاص، ومطلق ومقيد، وأمر ونهي، ومجمل ومبين، وهكذا، وهذا أجود للطالب من طريقة ابن جزي ومن طريقة الشاطبي، وأجود من طريقة الآمدي ومن معه ممن أخرها بعد الكتاب والسنة والإجماع، وعلى كلٍ فإن المهم هو معرفة أنها تختص بالكتاب والسنة دون بقية الأدلة، وبالله التوفيق.
وسيتم تعديل بعض المواضع أيضا، التي لابد من مراجعتها قبل الشروع في مسألة التأويل وما يحتف بها، وسيشار إليها بإذن الله، وبالله التوفيق
خاطرة:
يعتقد كثير من طالبي علم الأصول أن مرتقى الوصول متن متوسط، وأن المتون المتقدمة في أصول الفقه هي جمع ابن السبكي وما جرى مجراه من المتون التي قامت على تكثير المسائل وحك العبارات، وهذا بلا شك اعتقاد من اكتفى من الأصول بالشم، فابن عاصم في نظم المرتقى تجاوز تعظيم الحدود، وحك العبارات، وإغماض المعاني، وتكثير الفروع، إلى الغوص في أصول الأصول، بلغة مشرقة، وأسلوب واضح جلي، (فهي على تأصيله مقصورة* حاشيتها من لغة ومنطق*حرصا على إيضاح أهدى الطرق* إلا يسيرا من مقدمات*تنفع في مسائل ستأتي)، فكل مسألة ذكرها في المقدمات نفعت فيما بعدها من المسائل، ومن تأمل ما يكتب هنا على هذه النظم خلال هذه السنوات الثمان الفائتة، وتابع التنقيب عن مكنونات هذه المتن العجيب، فقد رأى ذلك رأي العين، فمسائل المنطق التي وردت في مقدمة النظم نفعت في جميع مسائل اشتراط القطع والظن، ومسائل الوضع وما يتبعه من فروع نفعت في مسائل الدلالة، وما ذكره في تعريف الأصول والأبيات الخمسة التي تلت ذلك، تراها في كل مسألة أصولية ذكرت بعد ذلك، وما ذكره في المقتضيات المحتملة نفع في مسائل المقاصد، ومسائل مراتب الدلالة، وما ذكره في لحن الخطاب ودليله وفحواه نفع في المسائل التي جاءت في مفتتح الأصل الأول، وهكذا، ثم إن ابن عاصم -خلافا لما يعتقده كثير من الطالبين- لم يسر في نظمه هذا مسيرة التقليد لمن تقدم من متكلمة الأصول، كما سار أصحاب المتون التي يعتقد كثير من الناس أنها متنهى الطالبين في علم الأصول، أو أنها جمعت الجوامع وضمت كل مفيد ونافع، انظر إلى ما قاله رحمه الله في خاتمة كلامه على مسألة شروط القراءة المقبولة، حيث قال: (ومذهب القُرّا بهذي المسألة*أقعد في الأمر كذا في البسمله*وذو الأصول حظُّه الأخذ لما*منه استمدّ عِلمه مسلِّما*والحق أن لا يُكْذب الرواة*في نقلهم لأنهم ثقات)، فهذا نقد مفتوح لعموم أهل الأصول، ثم انظر إلى إدخاله للكلام عن المقاصد بين (الأحكام التكليفية وما تتوقف عليه الأحكام) وبين مسائل (التكليف والحقوق وحكم الحيل)، وكيف جعل هذه الثلاث كالذيل والتكملة لمقاصد الشريعة في ترتيب لم يسبق إليه، لم يستمده من الشاطبي ولا ابن جزي ولا ممن سواهما، وراجع ما كتب على تلك المسائل، وانظر إلى إخراجه لدلالة الإقتضاء عن قسمة المنطوق والمفهوم، وكيف تخلص بذلك من مشكلة الإقتضاء وما حصل فيها من نزاع، ثم أخبرني عمن سبقه إلى هذا الصنيع، ثم اسمع كيف حل مشكلة الكعبي في المباح في بيت واحد عندما قال: (وباعتبارٍ "ما" انتقاله يُرى*عن أصله لُمقتضَى ما اعتُبرا)، وما وجهه إلى من أعجب برأي الكعبي من مناقشة في البيتين التي تلت هذا البيت، وهذا غيض من فيض، فيا من أردت امتلاك ملكة الأصول التي تولد الفقه الأصيل، كف عن تعظيم الرسوم، والإكتفاء بتحكيك العبارات، والإعجاب بكثرة ما خرج على الأصول الكلامية الباردة من المسائل والفروع، (ولو خالفت جل الناس، ولا تعتبر مكانة الكتب والرجال بالقياس)، واعقد على المرتقى بعقد وثيق، (مقللا للدروس، ومحكما للمدروس) والسلام.
https://t.me/mortgaalwsol
يعتقد كثير من طالبي علم الأصول أن مرتقى الوصول متن متوسط، وأن المتون المتقدمة في أصول الفقه هي جمع ابن السبكي وما جرى مجراه من المتون التي قامت على تكثير المسائل وحك العبارات، وهذا بلا شك اعتقاد من اكتفى من الأصول بالشم، فابن عاصم في نظم المرتقى تجاوز تعظيم الحدود، وحك العبارات، وإغماض المعاني، وتكثير الفروع، إلى الغوص في أصول الأصول، بلغة مشرقة، وأسلوب واضح جلي، (فهي على تأصيله مقصورة* حاشيتها من لغة ومنطق*حرصا على إيضاح أهدى الطرق* إلا يسيرا من مقدمات*تنفع في مسائل ستأتي)، فكل مسألة ذكرها في المقدمات نفعت فيما بعدها من المسائل، ومن تأمل ما يكتب هنا على هذه النظم خلال هذه السنوات الثمان الفائتة، وتابع التنقيب عن مكنونات هذه المتن العجيب، فقد رأى ذلك رأي العين، فمسائل المنطق التي وردت في مقدمة النظم نفعت في جميع مسائل اشتراط القطع والظن، ومسائل الوضع وما يتبعه من فروع نفعت في مسائل الدلالة، وما ذكره في تعريف الأصول والأبيات الخمسة التي تلت ذلك، تراها في كل مسألة أصولية ذكرت بعد ذلك، وما ذكره في المقتضيات المحتملة نفع في مسائل المقاصد، ومسائل مراتب الدلالة، وما ذكره في لحن الخطاب ودليله وفحواه نفع في المسائل التي جاءت في مفتتح الأصل الأول، وهكذا، ثم إن ابن عاصم -خلافا لما يعتقده كثير من الطالبين- لم يسر في نظمه هذا مسيرة التقليد لمن تقدم من متكلمة الأصول، كما سار أصحاب المتون التي يعتقد كثير من الناس أنها متنهى الطالبين في علم الأصول، أو أنها جمعت الجوامع وضمت كل مفيد ونافع، انظر إلى ما قاله رحمه الله في خاتمة كلامه على مسألة شروط القراءة المقبولة، حيث قال: (ومذهب القُرّا بهذي المسألة*أقعد في الأمر كذا في البسمله*وذو الأصول حظُّه الأخذ لما*منه استمدّ عِلمه مسلِّما*والحق أن لا يُكْذب الرواة*في نقلهم لأنهم ثقات)، فهذا نقد مفتوح لعموم أهل الأصول، ثم انظر إلى إدخاله للكلام عن المقاصد بين (الأحكام التكليفية وما تتوقف عليه الأحكام) وبين مسائل (التكليف والحقوق وحكم الحيل)، وكيف جعل هذه الثلاث كالذيل والتكملة لمقاصد الشريعة في ترتيب لم يسبق إليه، لم يستمده من الشاطبي ولا ابن جزي ولا ممن سواهما، وراجع ما كتب على تلك المسائل، وانظر إلى إخراجه لدلالة الإقتضاء عن قسمة المنطوق والمفهوم، وكيف تخلص بذلك من مشكلة الإقتضاء وما حصل فيها من نزاع، ثم أخبرني عمن سبقه إلى هذا الصنيع، ثم اسمع كيف حل مشكلة الكعبي في المباح في بيت واحد عندما قال: (وباعتبارٍ "ما" انتقاله يُرى*عن أصله لُمقتضَى ما اعتُبرا)، وما وجهه إلى من أعجب برأي الكعبي من مناقشة في البيتين التي تلت هذا البيت، وهذا غيض من فيض، فيا من أردت امتلاك ملكة الأصول التي تولد الفقه الأصيل، كف عن تعظيم الرسوم، والإكتفاء بتحكيك العبارات، والإعجاب بكثرة ما خرج على الأصول الكلامية الباردة من المسائل والفروع، (ولو خالفت جل الناس، ولا تعتبر مكانة الكتب والرجال بالقياس)، واعقد على المرتقى بعقد وثيق، (مقللا للدروس، ومحكما للمدروس) والسلام.
https://t.me/mortgaalwsol
Telegram
أمالي أصولية على مرتقى الوصول
نظم وافق بين موافقات الشاطبي وتقريب ابن جزي بلغة أشرقت بالمعنى وجنّبته غموض التركيب وضرورات الوزن والقافية (أصول الفقه)
بوت التواصل @mortgaalwsolbot
بوت التواصل @mortgaalwsolbot
الأصول الموهومة (1):
يشتغل كثير من طالبي الفقه بجمع الدلائل والترجيح في المسائل، وهذا بلا ريب من الفقه الأصيل، ولكن يغفل كثير منهم عن النظر في الأصول التي يستندون إليها في النظر الفقهي، فكثير من الدارسين يبحثون في حكم القراءة غير المتواترة في الصلاة، ويغفلون تمام الغفلة عن دراسة التواتر ذاته هل اشتراطه من أصول الشريعة، ويبحثون في مسائل الطلاق التي ينقل الإجماع فيها، ويغفلون عن بحث مهم من بحوث الإجماع، وهو هل وقع الإجماع في المسائل الإجتهادية التي لم تعلم من الدين بالضرورة، ويصفون بعض نصوص الشريعة بأنها مؤولة، أو بأنها مجاز، أو بأنها من المشترك، ويغفلون عن بحث فكرة الوضع الأول التي بنيت عليها هذه التقاسيم، هل هي صحيحة في ذاتها، ولماذا قيل بها في الأساس، وما علاقتها بمسألة هل الألفاظ المفردة عن سياقاتها تحمل المعاني، أم أن المعاني ترتبط بالمفردات إذا وضعت تلك المفردات داخل سياق كلامي مفيد، ويستدلون ببعض الدلالات التبعية، ويغفلون عن مقصد النص أو دلالته الأصلية، هل هي متفقة مع هذه الدلالة التبعية، أم أنها مخالفة لها، وهل يصح الاستدلال بها إذا كانت مخالفة لها، وهذا الأخير يقع كثيرا جدا من المتأخرين ممن اشتغلوا بالمعاملات المالية المعاصرة، وما يسمى بالفقه السياسي، فتجدهم يستدلون على نتائجهم التي انتهوا إليها بدلالات تبعية لبعض النصوص أو الوقائع، ويغفلون تمام الغفلة عن عرض هذا الاستدلال على الدلالة الأصلية للنص أو الواقعة المستدل بها، والكلام في هذا كثير تكفي اللبيب منه الإشارة، والسلام.
https://t.me/mortgaalwsol
يشتغل كثير من طالبي الفقه بجمع الدلائل والترجيح في المسائل، وهذا بلا ريب من الفقه الأصيل، ولكن يغفل كثير منهم عن النظر في الأصول التي يستندون إليها في النظر الفقهي، فكثير من الدارسين يبحثون في حكم القراءة غير المتواترة في الصلاة، ويغفلون تمام الغفلة عن دراسة التواتر ذاته هل اشتراطه من أصول الشريعة، ويبحثون في مسائل الطلاق التي ينقل الإجماع فيها، ويغفلون عن بحث مهم من بحوث الإجماع، وهو هل وقع الإجماع في المسائل الإجتهادية التي لم تعلم من الدين بالضرورة، ويصفون بعض نصوص الشريعة بأنها مؤولة، أو بأنها مجاز، أو بأنها من المشترك، ويغفلون عن بحث فكرة الوضع الأول التي بنيت عليها هذه التقاسيم، هل هي صحيحة في ذاتها، ولماذا قيل بها في الأساس، وما علاقتها بمسألة هل الألفاظ المفردة عن سياقاتها تحمل المعاني، أم أن المعاني ترتبط بالمفردات إذا وضعت تلك المفردات داخل سياق كلامي مفيد، ويستدلون ببعض الدلالات التبعية، ويغفلون عن مقصد النص أو دلالته الأصلية، هل هي متفقة مع هذه الدلالة التبعية، أم أنها مخالفة لها، وهل يصح الاستدلال بها إذا كانت مخالفة لها، وهذا الأخير يقع كثيرا جدا من المتأخرين ممن اشتغلوا بالمعاملات المالية المعاصرة، وما يسمى بالفقه السياسي، فتجدهم يستدلون على نتائجهم التي انتهوا إليها بدلالات تبعية لبعض النصوص أو الوقائع، ويغفلون تمام الغفلة عن عرض هذا الاستدلال على الدلالة الأصلية للنص أو الواقعة المستدل بها، والكلام في هذا كثير تكفي اللبيب منه الإشارة، والسلام.
https://t.me/mortgaalwsol
Telegram
أمالي أصولية على مرتقى الوصول
نظم وافق بين موافقات الشاطبي وتقريب ابن جزي بلغة أشرقت بالمعنى وجنّبته غموض التركيب وضرورات الوزن والقافية (أصول الفقه)
بوت التواصل @mortgaalwsolbot
بوت التواصل @mortgaalwsolbot
أمالي أصولية على مرتقى الوصول
يقودنا الكلام السابق إلى ما حكي عن الإمام اللغوي الكبير أبي العباس ثعلب بأنه لا يقول بوقوع المشترك في اللغة، وقد حاول جمهور القائلين بفكرة الوضع الأول تفسير رأيه هذا بتفاسير شتى، أقوها ما قيل بأنه يرى أن ما وقع في اللغة من ألفاظ تدل على معاني متعددة هي في…
التوجيه الأصولي لقول الإمام ثعلب في نفيه لوقوع المشترك.
أمالي أصولية على مرتقى الوصول
قال ابن عاصم: وقوع لفظ الاشتراك وضعا*في معنييه الخلف فيه وقعا. والحكم فيه إن أتى مجردا*توقف فيه بحيث وجدا. والشافعي حامل له على*ما يقتضيه الاشتراك ما علا. وحيثما احتفت به القرائن*فهو لتعيين المراد ضامن. وفي الكتاب منه بعض قد أتى*مثل قروء حكمه قد ثبتا. يذكر…
مسألة حمل المشترك على جميع معانيه، وإيضاح حقيقة القول المخرج للشافعي في هذه المسألة، ونقد ابن تيمية الحفيد -الذي نقله الزركشي- لهذا التخريج، وذكر لبعض النقود التي وجهها الزركشي والبرماوي وابن عاشور لبعض الأقوال المحكية في المسألة.
أمالي أصولية على مرتقى الوصول
قال ابن عاصم: مستعمل فيما له قد وضعا*حقيقة يدعى بحيث وقعا. وعكسها المجاز إن كان انتقل*وهو على عِلاقة قد اشتمل. انتقل الناظم إلى الكلام في انقسام الكلام إلى حقيقة ومجاز، فعرف الحقيقة بأنه اللفظ المستعمل فيما وضع له؛ كاستعمال لفظ الجمل في الدلالة على الحيوان…
بيان فكرة المجاز، وتوضيح لمبناها الذي بنيت عليه، وبيان أن هذا المبنى لا يُسلِم به -في بعض الأحيان- مَن ينتصر له ويقول بصحته.
أمالي أصولية على مرتقى الوصول
موجز الخلاف الواقع في المجاز: -ذهب كافة القائلين بفكرة الوضع الأول من الأصوليين واللغويين إلى وقوعه في اللغة والقران، وهو ظاهر كلام الناظم هنا. -وذهب الى منعه في اللغة والقرآن أبو علي الفارسي، نقله عنه ابن الصلاح في فوائد الرحلة، ومنذر بن سعيد البلوطي المفسر…
الخلاف في المجاز بين القائلين بفكرة الوضع الأول وبين القائلين بنظرية السياق، والكلام عن التفريق بين القرآن وبين سائر الكلام في وقوع المجاز، وتبيين الافتراض المتعدد الذي بنيت عليه فكرة الوضع الأول.
قال ابن عاصم:
قولٌ يرى مُعيِّنا مدلوله*بالوضع أو ضميمة تسمو له.
هو المبيَّن الذي قد شمَلا*النص والظاهر والمؤولا.
وعكسه المجمل وهْو ما افتقر*في مقتضاه لبيان ونظر.
والنص قول مفهِم معناه*من غير أن يقبل ما عداه.
وإن يكن لغيره يحتمل*معْه سَواءً فاسم ذا المحتمل.
والظاهر الذي مرجحا بدا*وعكسه مؤول إن عضدا.
وفي الكتاب قد أتت والسنه*لم يتخلف واحد مِنْهُنَّه.
في هذه الأبيات -وبأسلوب واضح لا يقل وضوحه عن جماله- ساق الناظم تقسيم الكلام إلى مجمل ومبين، وعدد أقسام المبين، وعرف هذا الأقسام جميعا، وإليك بيانها على طريقة الناظم -رحمه الله- :
ابتدأ ببيان أن الألفاظ تتقسم إلى ألفاظ مجملة وألفاظ مبينة:
ثم عرف الألفاظ المبينة: بأنها الألفاظ التي توضح مدلولاتها؛ إما بواسطة الوضع، أو بواسطة القرائن المصاحبة للّفظ.
وبين أن المجمل هو عكس المبين، وعرفه بأنه اللفظ الذي يفتقر لبيان معناه.
ثم ذكر أن المبين يشمل: النص، والظاهر، والمؤول.
وذكر أن النص هو: اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحد.
وأن المحتمل هو: الذي يحتمل أكثر من معنى ودلالته على معانيه كلها متساوية.
وأن الظاهر: الذي يحتمل أكثر من معنى لكن أحد معانيه أرجح من معانيه الأخرى.
وأن المؤول هو: اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى، أحدها أرجح من غيرها، ولكن عضد أحد المعاني المرجوحة الدليل، فأصبح يحمل عليه.
هذا حاصل ما ذكره الناظم في هذه الأبيات، وقد تلحظ فيها أن الناظم عرّف المحتمل، ولكنه لم يضفه إلى المجمل، ولم يعده من أقسام المبين، وقدم ذكره على الظاهر والمؤول، والذي يظهر من طريقة ابن عاصم التي يتبعها في نظمه هذا أنه يراعي ترتيب المسائل، فكأن ابن عاصم قسم دلالة اللفظ -في هذه الأبيات- بطريقتين:
طريقة إجمال اللفظ وبيانه،
وطريقة دلالته على المعاني التي يحتملها.
فذكر أن دلالة اللفظ إما:
أن تكون مجملة، أو مبينة، وهذه هي الطريقة الأولى.
ثم شرع في الثانية فذكر أن اللفظ إما:
أن يدل على معنى واحد لا يحتمل سواه وهو النص، أو يدل على عدة معاني محتملة، فإن تساوت دلالته على هذه المعاني فهو اللفظ المحتمل، وإن رجحت دلالته على إحدى معانيه فهو اللفظ الظاهر، وإن عضدت قرينة إحدى معانيه المرجوحة فهو اللفظ المؤول.
وقد ذكر قبل ذلك أن المبين يشمل: النص والظاهر والمؤول، وأن المجمل عكس المبين، وعلى هذا يكون المحتمل عنده من المجمل.
تنبيه:
تقسيم النص والظاهر والمحتمل هو بعينه التقسيم المنطقي الذي ذكره الناظم في مقدمات النظم؛ وهو تقسيم القطع والظن والشك، وذكر في أول الأبيات أن المقدمات تنفع في مسائل ستأتي، وها هي أتت،
إلا أنك إذا طبقت ذاك التقسيم على هذا التقسيم ستجد أن المؤول والظاهر لا يمكن التفريق بينهما؛ فكلاهما لفظ ترجحت إحدى معانيه على المعاني الأخرى، فما الفرق بين بين الظاهر والمؤول؟ هذا السؤال من معضلات علم الأصول، والجواب الذي يعتمده جمهور القائلين بفكرة الوضع الأول هو: أن المؤول ما رجح فيه المعنى بدليل خارجي، والظاهر ما رجح فيه المعنى من قبل كثرة استعمال اللفظ في ذلك المعنى، وأنه إذا تعارض معنيان أحدهما راجح من جهة الاستعمال، والآخر راجح بدليل خارجي، فإن المرجح بدليل خارجي يقدم على الراجح من جهة الاستعمال، ويسمون هذا التقديم بالتأويل، ويسمون اللفظ الذي ترجح معناه بدليل خارجي اللفظ المؤول.
وعلى هذا إذا ورد لفظ في سياق كلامي، وكان هذا اللفظ يحتمل أكثر من معنى، ولكنه يستعمل في أحد معانيه أكثر من استعماله في المعاني الأخرى، إلا أن السياق الكلامي يأبى هذا المعنى، أو تأباه سياقات المتكلم الأخرى، ويصبح تفسير الكلام عموما بالمعنى الظاهر مشكل، ويكون أحد معانيه الأخرى أكثر ملائمة للسياق الكلامي أو سياقات المتكلم الأخرى، فيتم صرف هذا اللفظ عن معناه الظاهر، إلى معناه الملائم للسياق الذي ورد فيه، أو الملائم لسياقات المتكلم الأخرى، ويسمى هذا الصرف بالتأويل، ويسمى اللفظ بالمؤول.
وهذا يوضح لك أن موضوع التأويل كله إنما وجد لتصحيح فكرة الوضع الأول، وأننا لو قلنا أن اللفظ إنما يدل على معناه بواسطة السياق فإن التأويل سيصبح بلا معنى ولا هدف؛ لأننا سنفسر اللفظ بمعناه الذي دل عليه السياق، وبهذا تعرف سبب موقف ابن تيمية الحفيد -وغيره من القائلين بالنظرية السياقية- من التأويل، وستعرف سبب قول أبي المظفر السمعاني: (أن التأويل ليس من أصول الفقه)، وستعرف سبب التشويش الحاصل في الفرق بين التحريف والتأويل، الذي جعل عامة من كتب في أصول الفقه يُحذرون مما يسمونه بالتأويل الفاسد، فالتأويل علاج للخلل الناتج من فكرة الوضع الأول، وهو في نفسه بحاجة إلى علاج يمنع استخدامه في تحريف الكلم عن مواضعه، وتسلسل معالجة الأفكار دليل على فسادها، وسيشير الناظم فيما يأتي من أبيات إلى التقسيمات التي حاول القائلون بفكرة الوضع الأول أن يعالجوا بها مشاكل التأويل، وبالله التوفيق.
قولٌ يرى مُعيِّنا مدلوله*بالوضع أو ضميمة تسمو له.
هو المبيَّن الذي قد شمَلا*النص والظاهر والمؤولا.
وعكسه المجمل وهْو ما افتقر*في مقتضاه لبيان ونظر.
والنص قول مفهِم معناه*من غير أن يقبل ما عداه.
وإن يكن لغيره يحتمل*معْه سَواءً فاسم ذا المحتمل.
والظاهر الذي مرجحا بدا*وعكسه مؤول إن عضدا.
وفي الكتاب قد أتت والسنه*لم يتخلف واحد مِنْهُنَّه.
في هذه الأبيات -وبأسلوب واضح لا يقل وضوحه عن جماله- ساق الناظم تقسيم الكلام إلى مجمل ومبين، وعدد أقسام المبين، وعرف هذا الأقسام جميعا، وإليك بيانها على طريقة الناظم -رحمه الله- :
ابتدأ ببيان أن الألفاظ تتقسم إلى ألفاظ مجملة وألفاظ مبينة:
ثم عرف الألفاظ المبينة: بأنها الألفاظ التي توضح مدلولاتها؛ إما بواسطة الوضع، أو بواسطة القرائن المصاحبة للّفظ.
وبين أن المجمل هو عكس المبين، وعرفه بأنه اللفظ الذي يفتقر لبيان معناه.
ثم ذكر أن المبين يشمل: النص، والظاهر، والمؤول.
وذكر أن النص هو: اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحد.
وأن المحتمل هو: الذي يحتمل أكثر من معنى ودلالته على معانيه كلها متساوية.
وأن الظاهر: الذي يحتمل أكثر من معنى لكن أحد معانيه أرجح من معانيه الأخرى.
وأن المؤول هو: اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى، أحدها أرجح من غيرها، ولكن عضد أحد المعاني المرجوحة الدليل، فأصبح يحمل عليه.
هذا حاصل ما ذكره الناظم في هذه الأبيات، وقد تلحظ فيها أن الناظم عرّف المحتمل، ولكنه لم يضفه إلى المجمل، ولم يعده من أقسام المبين، وقدم ذكره على الظاهر والمؤول، والذي يظهر من طريقة ابن عاصم التي يتبعها في نظمه هذا أنه يراعي ترتيب المسائل، فكأن ابن عاصم قسم دلالة اللفظ -في هذه الأبيات- بطريقتين:
طريقة إجمال اللفظ وبيانه،
وطريقة دلالته على المعاني التي يحتملها.
فذكر أن دلالة اللفظ إما:
أن تكون مجملة، أو مبينة، وهذه هي الطريقة الأولى.
ثم شرع في الثانية فذكر أن اللفظ إما:
أن يدل على معنى واحد لا يحتمل سواه وهو النص، أو يدل على عدة معاني محتملة، فإن تساوت دلالته على هذه المعاني فهو اللفظ المحتمل، وإن رجحت دلالته على إحدى معانيه فهو اللفظ الظاهر، وإن عضدت قرينة إحدى معانيه المرجوحة فهو اللفظ المؤول.
وقد ذكر قبل ذلك أن المبين يشمل: النص والظاهر والمؤول، وأن المجمل عكس المبين، وعلى هذا يكون المحتمل عنده من المجمل.
تنبيه:
تقسيم النص والظاهر والمحتمل هو بعينه التقسيم المنطقي الذي ذكره الناظم في مقدمات النظم؛ وهو تقسيم القطع والظن والشك، وذكر في أول الأبيات أن المقدمات تنفع في مسائل ستأتي، وها هي أتت،
إلا أنك إذا طبقت ذاك التقسيم على هذا التقسيم ستجد أن المؤول والظاهر لا يمكن التفريق بينهما؛ فكلاهما لفظ ترجحت إحدى معانيه على المعاني الأخرى، فما الفرق بين بين الظاهر والمؤول؟ هذا السؤال من معضلات علم الأصول، والجواب الذي يعتمده جمهور القائلين بفكرة الوضع الأول هو: أن المؤول ما رجح فيه المعنى بدليل خارجي، والظاهر ما رجح فيه المعنى من قبل كثرة استعمال اللفظ في ذلك المعنى، وأنه إذا تعارض معنيان أحدهما راجح من جهة الاستعمال، والآخر راجح بدليل خارجي، فإن المرجح بدليل خارجي يقدم على الراجح من جهة الاستعمال، ويسمون هذا التقديم بالتأويل، ويسمون اللفظ الذي ترجح معناه بدليل خارجي اللفظ المؤول.
وعلى هذا إذا ورد لفظ في سياق كلامي، وكان هذا اللفظ يحتمل أكثر من معنى، ولكنه يستعمل في أحد معانيه أكثر من استعماله في المعاني الأخرى، إلا أن السياق الكلامي يأبى هذا المعنى، أو تأباه سياقات المتكلم الأخرى، ويصبح تفسير الكلام عموما بالمعنى الظاهر مشكل، ويكون أحد معانيه الأخرى أكثر ملائمة للسياق الكلامي أو سياقات المتكلم الأخرى، فيتم صرف هذا اللفظ عن معناه الظاهر، إلى معناه الملائم للسياق الذي ورد فيه، أو الملائم لسياقات المتكلم الأخرى، ويسمى هذا الصرف بالتأويل، ويسمى اللفظ بالمؤول.
وهذا يوضح لك أن موضوع التأويل كله إنما وجد لتصحيح فكرة الوضع الأول، وأننا لو قلنا أن اللفظ إنما يدل على معناه بواسطة السياق فإن التأويل سيصبح بلا معنى ولا هدف؛ لأننا سنفسر اللفظ بمعناه الذي دل عليه السياق، وبهذا تعرف سبب موقف ابن تيمية الحفيد -وغيره من القائلين بالنظرية السياقية- من التأويل، وستعرف سبب قول أبي المظفر السمعاني: (أن التأويل ليس من أصول الفقه)، وستعرف سبب التشويش الحاصل في الفرق بين التحريف والتأويل، الذي جعل عامة من كتب في أصول الفقه يُحذرون مما يسمونه بالتأويل الفاسد، فالتأويل علاج للخلل الناتج من فكرة الوضع الأول، وهو في نفسه بحاجة إلى علاج يمنع استخدامه في تحريف الكلم عن مواضعه، وتسلسل معالجة الأفكار دليل على فسادها، وسيشير الناظم فيما يأتي من أبيات إلى التقسيمات التي حاول القائلون بفكرة الوضع الأول أن يعالجوا بها مشاكل التأويل، وبالله التوفيق.
قال ابن عاصم:
والأخذ بالتأويل أمر معتبر*لجل أهل العلم حكمه اشتهر.
وهْو قريب في محل النظر*ومنه ذو بُعد وذو تعذر.
فالأول المعمل باتفاق*ممن به قال على الإطلاق.
وقِسْمُهُ الثاني كأمسك أربعا*يُراد جَدِّد أو دعِ المُتَّبِعا.
ومثله إطعام ستين على*الِاطعام مع تَعداد شخص حُمِلا.
وثالثٌ ليس له قبولُ*وهْو الذي تأنفه العقول.
كمثل ما عن أهل نجران صدر*في مثل نحن وخلقنا ونذر.
في هذه الأبيات يذكر الناظم أن للتأويل ثلاثة أقسام:
القسم الأول: تأويل قريب، ووصفه بأنه معمل بالاتفاق، ولم يمثل له، ويمكن أن يمثل له بتأويل الجمهور لصيغة الحصر الواردة في حديث أسامة (إنما الربا في النسيئة)، بأنها صيغة اهتمام لا حصر؛ لما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن بيع ستة أصناف منها الذهب والفضة إلا بالتماثل وعدم التأجيل، ثم قال: (فمن زاد أو ازداد فقد أربى).
القسم الثاني: تأويل بعيد، وضرب له مثالين:
المثال الأول: تأويل حديث غيلان بن سلمة الثقفي الذي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((أمسك أربعا، وفارق سائرهن)) رواه أحمد، فإن سياق هذا الحديث ظاهر في صحة نكاح الأربع الذي أمر بإمساكهن، وأنه لا يحتاج إلى تجديد عقد النكاح عليهن، وأنه مخير في تعيين الأربع التي يمسكهن من العشر، إلا أن بعض الفقهاء -ممن يرى أن أنكحة الكفار باطلة وأنهم لا يقرون عليها- تأول الأمر بالإمساك الوارد في الحديث: بأن المقصود به تجديد النكاح لأيهن شاء، أو أن الأمر بالمفارقة وقع على الست المتأخرات، وأن الزوج لا يخير فيمن يمسك وفيمن يفارق، (يُراد جَدِّد أو دعِ المُتَّبِعا).
المثال الثاني: تأويل قوله تعالى: {فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا}، فإن بعض الفقهاء -ممن يرى جواز إطعام مسكين واحد بطعام الستين- أوّلوا هذه الآية على أن المراد بها: إطعام طعام ستين مسكينا، مع أن الآية ذكرت العدد ولم تذكر الطعام اهتماما بالعدد، وكان ابن جني يخرج هذا التأويل على بعض كلام سيبويه.
القسم الثالث: التأويل الذي تأنفه العقول، وضرب له مثلا بقصة نصارى نجران -التي تقدم بعضها في الكلام على المحكم والمتشابه- وذلك أن نصارى نجران أولوا بعض ضمائر التعظيم الواردة في مثل قوله تعالى: (إنا نحن نزلنا القرآن)، وقوله: (ولقد خلقنا الإنسان)، وقوله: (ونذر الظالمين فيها جثيا)، على أن المراد بهذه الضمائر الجمع؛ يشيرون إلى الثالوث: (الأب-الابن-روح القدس)، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
انظر وتأمل:
ما يذكره عامة أهل الأصول في مسائل التأويل -ومنها الأمثلة السابقة- هل هو تأويل للظاهر، أم تعارض وترجيح؟
١/إذا قلنا بأن اللفظ المجرد عن السياق الكلامي لا يدل في حقيقته على معنى.
٢/وإذا قلنا بأن العرب لم تجتمع لتضع لكل لفظ معنى، أو لكل أسلوب معنى، وإنما استعملت الألفاظ والأساليب في سياقات كلامية مفيدة، وأن المعاني والأساليب المسطرة في المعاجم وكتب النحو والصرف والبلاغة إنما استنبطها اللغويون من السياقات الكلامية المفيدة المنقولة عن أصحاب السليقة العربية.
٣/وإذا قلنا أن المعاني التي تتبادر للذهن عند سماع بعض الألفاظ أو الأساليب لا تدل بالضرورة على مقصود المتكلم؛ وإنما سبقت إلى الذهن لكونها الأكثر استعمالا في ذلك الأسلوب أو اللفظ.
٥/ وإذا قلنا أن السياق الكلامي هو الذي يدل على مقصود المتكلم، وأن اللفظ إنما يحمل المعنى عندما يندرج في سياق كلامي مفيد.
٦/ فاللفظ حينئذ يفسره السياق الكلامي الذي ورد فيه، أو تفسره سياقات المتكلم الأخرى، وإذا تعارضت السياقات -كما هو الحال في غالب صور التأويل الصحيح التي يذكرها الفقهاء- فهذه باب من أبواب التعارض بين النصوص، ويكون علاجه بالجمع بين السياقين، أو بترجيح أحد السياقين على الآخر، فلا حاجة للتأويل بمعناه الاصطلاحي اذا اتبعنا تفسير السياق، وقد لاحظ عدد من الأصوليين ذلك منهم السمعاني، ومنهم الشاطبي فقال في معرض كلامه على تأويل المشتبه: (أن التأويل إنما يسلط على الدليل لمعارضة ما هو أقوى منه؛ فالناظر بين أمرين إما أن يبطل المرجوح جملة اعتمادا على الراجح، ولا يلزم نفسه الجمع، وهذا نظر يُرجع إلى مثله عند التعارض على الجملة، وإما أن لا يبطله ويعتمد القول به على وجه) انتهى، وبالله التوفيق.
والأخذ بالتأويل أمر معتبر*لجل أهل العلم حكمه اشتهر.
وهْو قريب في محل النظر*ومنه ذو بُعد وذو تعذر.
فالأول المعمل باتفاق*ممن به قال على الإطلاق.
وقِسْمُهُ الثاني كأمسك أربعا*يُراد جَدِّد أو دعِ المُتَّبِعا.
ومثله إطعام ستين على*الِاطعام مع تَعداد شخص حُمِلا.
وثالثٌ ليس له قبولُ*وهْو الذي تأنفه العقول.
كمثل ما عن أهل نجران صدر*في مثل نحن وخلقنا ونذر.
في هذه الأبيات يذكر الناظم أن للتأويل ثلاثة أقسام:
القسم الأول: تأويل قريب، ووصفه بأنه معمل بالاتفاق، ولم يمثل له، ويمكن أن يمثل له بتأويل الجمهور لصيغة الحصر الواردة في حديث أسامة (إنما الربا في النسيئة)، بأنها صيغة اهتمام لا حصر؛ لما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن بيع ستة أصناف منها الذهب والفضة إلا بالتماثل وعدم التأجيل، ثم قال: (فمن زاد أو ازداد فقد أربى).
القسم الثاني: تأويل بعيد، وضرب له مثالين:
المثال الأول: تأويل حديث غيلان بن سلمة الثقفي الذي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((أمسك أربعا، وفارق سائرهن)) رواه أحمد، فإن سياق هذا الحديث ظاهر في صحة نكاح الأربع الذي أمر بإمساكهن، وأنه لا يحتاج إلى تجديد عقد النكاح عليهن، وأنه مخير في تعيين الأربع التي يمسكهن من العشر، إلا أن بعض الفقهاء -ممن يرى أن أنكحة الكفار باطلة وأنهم لا يقرون عليها- تأول الأمر بالإمساك الوارد في الحديث: بأن المقصود به تجديد النكاح لأيهن شاء، أو أن الأمر بالمفارقة وقع على الست المتأخرات، وأن الزوج لا يخير فيمن يمسك وفيمن يفارق، (يُراد جَدِّد أو دعِ المُتَّبِعا).
المثال الثاني: تأويل قوله تعالى: {فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا}، فإن بعض الفقهاء -ممن يرى جواز إطعام مسكين واحد بطعام الستين- أوّلوا هذه الآية على أن المراد بها: إطعام طعام ستين مسكينا، مع أن الآية ذكرت العدد ولم تذكر الطعام اهتماما بالعدد، وكان ابن جني يخرج هذا التأويل على بعض كلام سيبويه.
القسم الثالث: التأويل الذي تأنفه العقول، وضرب له مثلا بقصة نصارى نجران -التي تقدم بعضها في الكلام على المحكم والمتشابه- وذلك أن نصارى نجران أولوا بعض ضمائر التعظيم الواردة في مثل قوله تعالى: (إنا نحن نزلنا القرآن)، وقوله: (ولقد خلقنا الإنسان)، وقوله: (ونذر الظالمين فيها جثيا)، على أن المراد بهذه الضمائر الجمع؛ يشيرون إلى الثالوث: (الأب-الابن-روح القدس)، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
انظر وتأمل:
ما يذكره عامة أهل الأصول في مسائل التأويل -ومنها الأمثلة السابقة- هل هو تأويل للظاهر، أم تعارض وترجيح؟
١/إذا قلنا بأن اللفظ المجرد عن السياق الكلامي لا يدل في حقيقته على معنى.
٢/وإذا قلنا بأن العرب لم تجتمع لتضع لكل لفظ معنى، أو لكل أسلوب معنى، وإنما استعملت الألفاظ والأساليب في سياقات كلامية مفيدة، وأن المعاني والأساليب المسطرة في المعاجم وكتب النحو والصرف والبلاغة إنما استنبطها اللغويون من السياقات الكلامية المفيدة المنقولة عن أصحاب السليقة العربية.
٣/وإذا قلنا أن المعاني التي تتبادر للذهن عند سماع بعض الألفاظ أو الأساليب لا تدل بالضرورة على مقصود المتكلم؛ وإنما سبقت إلى الذهن لكونها الأكثر استعمالا في ذلك الأسلوب أو اللفظ.
٥/ وإذا قلنا أن السياق الكلامي هو الذي يدل على مقصود المتكلم، وأن اللفظ إنما يحمل المعنى عندما يندرج في سياق كلامي مفيد.
٦/ فاللفظ حينئذ يفسره السياق الكلامي الذي ورد فيه، أو تفسره سياقات المتكلم الأخرى، وإذا تعارضت السياقات -كما هو الحال في غالب صور التأويل الصحيح التي يذكرها الفقهاء- فهذه باب من أبواب التعارض بين النصوص، ويكون علاجه بالجمع بين السياقين، أو بترجيح أحد السياقين على الآخر، فلا حاجة للتأويل بمعناه الاصطلاحي اذا اتبعنا تفسير السياق، وقد لاحظ عدد من الأصوليين ذلك منهم السمعاني، ومنهم الشاطبي فقال في معرض كلامه على تأويل المشتبه: (أن التأويل إنما يسلط على الدليل لمعارضة ما هو أقوى منه؛ فالناظر بين أمرين إما أن يبطل المرجوح جملة اعتمادا على الراجح، ولا يلزم نفسه الجمع، وهذا نظر يُرجع إلى مثله عند التعارض على الجملة، وإما أن لا يبطله ويعتمد القول به على وجه) انتهى، وبالله التوفيق.
قال ابن عاصم:
(فصل في البيان)
لمّا تكلم الناظم في المبين والمجمل في الفصل السابق أراد في هذا الفصل:
أن يعرّف البيان، وأن يعدّد ما يحصل به البيان، وأن يتكلم عن بعض أحكام البيان، وأن يتكلم عن بعض الأساليب اللغوية الواردة في الكتاب والسنة التي حصل النزاع فيها هل هي من المجمل أم المبين؟.
ومن المهم قبل الشروع في هذا الفصل ألا ننسى ما ذكره الناظم -في الفصل السابق- من أن المبين عكس المجمل، وأن المجمل مفتقر إلى البيان، لما لهاذين الأمرين من أهمية في فهم بعض النزاعات الأصولية الواردة في هذا الفصل، وبالله التوفيق.
(فصل في البيان)
لمّا تكلم الناظم في المبين والمجمل في الفصل السابق أراد في هذا الفصل:
أن يعرّف البيان، وأن يعدّد ما يحصل به البيان، وأن يتكلم عن بعض أحكام البيان، وأن يتكلم عن بعض الأساليب اللغوية الواردة في الكتاب والسنة التي حصل النزاع فيها هل هي من المجمل أم المبين؟.
ومن المهم قبل الشروع في هذا الفصل ألا ننسى ما ذكره الناظم -في الفصل السابق- من أن المبين عكس المجمل، وأن المجمل مفتقر إلى البيان، لما لهاذين الأمرين من أهمية في فهم بعض النزاعات الأصولية الواردة في هذا الفصل، وبالله التوفيق.
قال ابن عاصم:
إخراج مشكلٍ من المعاني*إلى التجليْ الحد للبيان.
يذكر الناظم في هذا البيت حقيقة البيان، فيعرفه بأنه: تجلية الإشكال عن المعاني، وهو تعريف قريب مما ذكره الصيرفي شارح الرسالة؛ حيث وصف البيان بأنه: (إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي). والبيان -في أصله- مصطلح شرعي؛ فقد وصف -جل وعلا- كتابه بأنه {تبيانا لكل شيء}، وأخبر -جل وعلا- أنه أنزل الكتاب على نبيه -صلى الله عليه وسلم- ليبين به؛ فقال : {وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون}. وعلى هاتين الآيتين أسس الشافعي كتابه الرسالة، وهو أول من ذكر البيان وأنواعه؛ فهو بعد أن افتتح رسالته بالحمد والثناء، والصلاة على رسول الله، وفضل العلم وأهله، وواجب أهل العلم، قال: (فليست تنزل في أحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليلُ على سبيل الهدى فيها)، ثم استدل على ذلك بآيات منها الآيتين السابقتين، ثم عقد بابا ترجمه بقوله: ( باب كيف البيان: والبيان اسم جامع لمعاني مجتمعةِ الأصول متشعبةِ الفروع، فأقلُّ ما في تلك المعاني المجتمعة المتشعبة: أنها بيانٌ لمن خوطب بها ممن نزل القُرَآن بلسانه، متقاربة الاستواء عنده، وإن كان بعضها أشدَّ تأكيدَ بيانٍ من بعض، ومختلفةٌ عند من يجهل لسان العرب)، ثم ذهب -رحمه الله- يعدد تلك المعاني، واستغرق كلامه عنها ثلثي كتاب الرسالة، فمعنى البيان عند الشافعي -كما ترى- مستغرق لجل علم الأصول، إلا أن بعض الأصوليين قيدوا البيان بتوضيح المشكل، وقد انتقد أبو حامد الغزالي ذلك؛ فقال: (وليس من شرطه أن يكون بيانا لمشكل؛ لأن النصوص المعربة عن الأمور ابتداء بيان، وإن لم يتقدم فيها إشكال. وبهذا يبطل قول من حده بأنه إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، فذلك ضرب من البيان؛ وهو بيان المجمل فقط). ومن الوصف الجميل للبيان وصف ابن رشد الحفيد؛ حيث قال: (واسم البيان يقع عندهم في هذه الصناعة على كل ما يمكن أن تثبت به الأحكام، ويقع في الأفهام، من صيغة لفظ أو مفهومه)، فالبيان إذن معنى عام شامل لكل ما يبين حكم الله جل وعلا، والناظم -رحمه الله- وإن قيد البيان بالمشكل فقط إلا أنه يوسع مفهومه؛ كما سيتضح ذلك فيما يأتي من أبيات، وبالله التوفيق.
إخراج مشكلٍ من المعاني*إلى التجليْ الحد للبيان.
يذكر الناظم في هذا البيت حقيقة البيان، فيعرفه بأنه: تجلية الإشكال عن المعاني، وهو تعريف قريب مما ذكره الصيرفي شارح الرسالة؛ حيث وصف البيان بأنه: (إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي). والبيان -في أصله- مصطلح شرعي؛ فقد وصف -جل وعلا- كتابه بأنه {تبيانا لكل شيء}، وأخبر -جل وعلا- أنه أنزل الكتاب على نبيه -صلى الله عليه وسلم- ليبين به؛ فقال : {وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون}. وعلى هاتين الآيتين أسس الشافعي كتابه الرسالة، وهو أول من ذكر البيان وأنواعه؛ فهو بعد أن افتتح رسالته بالحمد والثناء، والصلاة على رسول الله، وفضل العلم وأهله، وواجب أهل العلم، قال: (فليست تنزل في أحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليلُ على سبيل الهدى فيها)، ثم استدل على ذلك بآيات منها الآيتين السابقتين، ثم عقد بابا ترجمه بقوله: ( باب كيف البيان: والبيان اسم جامع لمعاني مجتمعةِ الأصول متشعبةِ الفروع، فأقلُّ ما في تلك المعاني المجتمعة المتشعبة: أنها بيانٌ لمن خوطب بها ممن نزل القُرَآن بلسانه، متقاربة الاستواء عنده، وإن كان بعضها أشدَّ تأكيدَ بيانٍ من بعض، ومختلفةٌ عند من يجهل لسان العرب)، ثم ذهب -رحمه الله- يعدد تلك المعاني، واستغرق كلامه عنها ثلثي كتاب الرسالة، فمعنى البيان عند الشافعي -كما ترى- مستغرق لجل علم الأصول، إلا أن بعض الأصوليين قيدوا البيان بتوضيح المشكل، وقد انتقد أبو حامد الغزالي ذلك؛ فقال: (وليس من شرطه أن يكون بيانا لمشكل؛ لأن النصوص المعربة عن الأمور ابتداء بيان، وإن لم يتقدم فيها إشكال. وبهذا يبطل قول من حده بأنه إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، فذلك ضرب من البيان؛ وهو بيان المجمل فقط). ومن الوصف الجميل للبيان وصف ابن رشد الحفيد؛ حيث قال: (واسم البيان يقع عندهم في هذه الصناعة على كل ما يمكن أن تثبت به الأحكام، ويقع في الأفهام، من صيغة لفظ أو مفهومه)، فالبيان إذن معنى عام شامل لكل ما يبين حكم الله جل وعلا، والناظم -رحمه الله- وإن قيد البيان بالمشكل فقط إلا أنه يوسع مفهومه؛ كما سيتضح ذلك فيما يأتي من أبيات، وبالله التوفيق.
قال ابن عاصم:
وإنه يحصل بالتعليل*والقولِ والمفهوم والتأويل.
والنسخِ والتخصيص والدليل*من حس او عقل على التفصيل.
والفعلِ والإقرار والإيماء*والكَتْبِ والقياس في الأشياء.
في هذه الأبيات يعدد الناظم ما يحصل به البيان:
فذكر أولا: أنه يحصل بالتعليل؛ يقصد أن الشارع إذا أخبرنا عن علة حكم من الأحكام فإن إخباره هذا بيان لمقصد ذلك الحكم، وليقاس عليه مثله، ومثاله قوله تعالى: {كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم}؛ فإن هذا التعليل بيان لعلة جعل الفيء محصورا في الأصناف المذكورة في الآية.
ثانيا: القول، يقصد به قول الله تعالى، وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن في آيات الله بيان للشرائع التي شرعها الله لعبادة، وكلّف الله نبيه -صلى الله عليه وسلم- ببيانها بقوله، وبفعله.
ثالثا: المفهوم، ويقصد به المفهوم بمعناه العام، وهو ما يفهم من سكوت الشارع أو من تقييده الخطاب بوصف أو عدد، سواء دل المفهوم على الأولوية، أو المساواة، أو المخالفة، فإن في سكوت الشارع أو تقييده الخطاب بوصف أو عدد : بيان لحكم المسكوت عنه، أو المخالف للوصف أو العدد، انظر إلى قوله -جل وعلا- : { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} فإن في تقييده الأمر بوصف الاستطاعة بيانٌ -غير منطوق- يقتضي أن غير المستطيع لا يتوجه إليه الأمر، ومما يندرج تحت مفهوم السكوت: قاعدة (السكوت في معرض الحاجة الى البيان بيان).
رابعا: التأويل؛ وفسره شراح المرتقى بالتأويل الاصطلاحي، ويمثلون له بأمثلة الاقتضاء، وهذا مشكل من جهتين: من جهة أن التأويل الاصطلاحي من فعل المجتهد، والبيان إنما يكون من الشارع، ومن جهة أن الاقتضاء يفهم من غير تأويل؛ لأنه من باب حذف المعلوم، والمعلوم لا يحتاج إلى تأويل لفهمه. والذي يظهر أن الناظم يقصد التأويل بمعناه الغالب في استعمال الشرع، الذي هو بمعنى ما يؤول إليه الشيء، ولا شك أن وقوع ما أخبرنا الله به مما تتبين به آيات الكتاب، ونبوات الرسل، قال -جل وعلا- : {هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون}، فهؤلاء بان لهم صدق الرسل لما أتى تأويل الوعيد.
خامسا: النسخ؛ والنسخ هو رفع الحكم الثابت بدليل متقدم، وسيأتي -بإذن الله- الكلام عنه، وهو من طرق البيان لأنه بيان من الشارع أن الحكم السابق قد رفع.
سادسا: التخصيص؛ ويقصد به إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام، ويأتي-بإذن الله- الكلام عنه، وهو من طرق البيان باعتبار أن فيه بيان بأن اللفظ العام لا يراد به كل أفراده.
سابعا: الدليل الحسي والعقلي؛ والغالب أن الناظم يقصد به أن ما خلق الله فينا من إحساس وإدراك للأمور: وسيلة نتبين بها مواقع تنزيل الأحكام على الوقائع، وإلا فإن تبيين نصوص الشريعة بمجرد الحس والعقل هو من القول على الله بغير علم، والآيات التي يذكر الشراح أن العقل والحس هو الذي بينها لا يسلم بها؛ لأنك إذا تأملتها وجدت أن سياقها الذي وردت فيه وما احتف به من قرائن لفظية أو حالية هو الذي بينها.
ثامنا: الفعل؛ ويقصد به فعل النبي-صلى الله عليه وسلم- كقوله في المناسك: (خذوا عني مناسككم)، وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي).
تاسعا: الإقرار؛ ويقصد به إقرار النبي -صلى الله عليه وسلم- لفعل من الأفعال، أو قول من الأقوال، فإن إقراره بيان منه -صلى الله عليه وسلم- بصحة ذلك الفعل أو القول.
عاشرا: الإيماء؛ ويقصد به أن تعليق الشارع لحكم من الأحكام بوصف من الأوصاف بيان منه بأن الوصف هو علة الحكم.
الحادي عشر: الكتابة؛ ويقصد بها كتابة النبي -صلى الله عليه وسلم- ورسائلة إلى ولاته، فإن فيها بيان لما تضمنته من أحكام.
الثاني عشر: القياس في الأشياء؛ ويقصد بها الأقيسة الواردة في نصوص الكتاب والسنة، كقوله تعالى: {إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب}، وقياس النبي -صلى الله عليه وسلم- القبلة على المضمضة، والحج على الدين في وجوب القضاء، فإن في هذه الأقيسة بيان لما تضمنته من أوجه القياس والتشابه.
وتأتي بقية مسائل البيان بإذن الله، وبالله التوفيق.
وإنه يحصل بالتعليل*والقولِ والمفهوم والتأويل.
والنسخِ والتخصيص والدليل*من حس او عقل على التفصيل.
والفعلِ والإقرار والإيماء*والكَتْبِ والقياس في الأشياء.
في هذه الأبيات يعدد الناظم ما يحصل به البيان:
فذكر أولا: أنه يحصل بالتعليل؛ يقصد أن الشارع إذا أخبرنا عن علة حكم من الأحكام فإن إخباره هذا بيان لمقصد ذلك الحكم، وليقاس عليه مثله، ومثاله قوله تعالى: {كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم}؛ فإن هذا التعليل بيان لعلة جعل الفيء محصورا في الأصناف المذكورة في الآية.
ثانيا: القول، يقصد به قول الله تعالى، وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن في آيات الله بيان للشرائع التي شرعها الله لعبادة، وكلّف الله نبيه -صلى الله عليه وسلم- ببيانها بقوله، وبفعله.
ثالثا: المفهوم، ويقصد به المفهوم بمعناه العام، وهو ما يفهم من سكوت الشارع أو من تقييده الخطاب بوصف أو عدد، سواء دل المفهوم على الأولوية، أو المساواة، أو المخالفة، فإن في سكوت الشارع أو تقييده الخطاب بوصف أو عدد : بيان لحكم المسكوت عنه، أو المخالف للوصف أو العدد، انظر إلى قوله -جل وعلا- : { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} فإن في تقييده الأمر بوصف الاستطاعة بيانٌ -غير منطوق- يقتضي أن غير المستطيع لا يتوجه إليه الأمر، ومما يندرج تحت مفهوم السكوت: قاعدة (السكوت في معرض الحاجة الى البيان بيان).
رابعا: التأويل؛ وفسره شراح المرتقى بالتأويل الاصطلاحي، ويمثلون له بأمثلة الاقتضاء، وهذا مشكل من جهتين: من جهة أن التأويل الاصطلاحي من فعل المجتهد، والبيان إنما يكون من الشارع، ومن جهة أن الاقتضاء يفهم من غير تأويل؛ لأنه من باب حذف المعلوم، والمعلوم لا يحتاج إلى تأويل لفهمه. والذي يظهر أن الناظم يقصد التأويل بمعناه الغالب في استعمال الشرع، الذي هو بمعنى ما يؤول إليه الشيء، ولا شك أن وقوع ما أخبرنا الله به مما تتبين به آيات الكتاب، ونبوات الرسل، قال -جل وعلا- : {هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون}، فهؤلاء بان لهم صدق الرسل لما أتى تأويل الوعيد.
خامسا: النسخ؛ والنسخ هو رفع الحكم الثابت بدليل متقدم، وسيأتي -بإذن الله- الكلام عنه، وهو من طرق البيان لأنه بيان من الشارع أن الحكم السابق قد رفع.
سادسا: التخصيص؛ ويقصد به إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام، ويأتي-بإذن الله- الكلام عنه، وهو من طرق البيان باعتبار أن فيه بيان بأن اللفظ العام لا يراد به كل أفراده.
سابعا: الدليل الحسي والعقلي؛ والغالب أن الناظم يقصد به أن ما خلق الله فينا من إحساس وإدراك للأمور: وسيلة نتبين بها مواقع تنزيل الأحكام على الوقائع، وإلا فإن تبيين نصوص الشريعة بمجرد الحس والعقل هو من القول على الله بغير علم، والآيات التي يذكر الشراح أن العقل والحس هو الذي بينها لا يسلم بها؛ لأنك إذا تأملتها وجدت أن سياقها الذي وردت فيه وما احتف به من قرائن لفظية أو حالية هو الذي بينها.
ثامنا: الفعل؛ ويقصد به فعل النبي-صلى الله عليه وسلم- كقوله في المناسك: (خذوا عني مناسككم)، وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي).
تاسعا: الإقرار؛ ويقصد به إقرار النبي -صلى الله عليه وسلم- لفعل من الأفعال، أو قول من الأقوال، فإن إقراره بيان منه -صلى الله عليه وسلم- بصحة ذلك الفعل أو القول.
عاشرا: الإيماء؛ ويقصد به أن تعليق الشارع لحكم من الأحكام بوصف من الأوصاف بيان منه بأن الوصف هو علة الحكم.
الحادي عشر: الكتابة؛ ويقصد بها كتابة النبي -صلى الله عليه وسلم- ورسائلة إلى ولاته، فإن فيها بيان لما تضمنته من أحكام.
الثاني عشر: القياس في الأشياء؛ ويقصد بها الأقيسة الواردة في نصوص الكتاب والسنة، كقوله تعالى: {إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب}، وقياس النبي -صلى الله عليه وسلم- القبلة على المضمضة، والحج على الدين في وجوب القضاء، فإن في هذه الأقيسة بيان لما تضمنته من أوجه القياس والتشابه.
وتأتي بقية مسائل البيان بإذن الله، وبالله التوفيق.
قال ابن عاصم:
ولا يجوز في البيان أن يُرى*عن وقت حاجة له مؤخرا.
وجوزوا التأخير بالإطلاق*عن زمن الخطاب باتفاق.
يتكلم الناظم في هذه الأبيات عن مسألتين: الأولى تأخير البيان عن وقت الحاجة، والثانية تأخيره عن وقت الخطاب، وهذه مسائل فرعت على خلاف نفاة القدر مع الجبرية في التكليف بما لا يطاق، فمن جوّز التكليف بما لا يطاق قال: بأن البيان يجوز أن يتأخر عن وقت الحاجة، ومن منع قال لا يجوز، والذين قالوا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة اختلفوا: فمنهم من قال يجوز أن يتأخر عن وقت الخطاب، ومنهم من منع، ومتقدمي متكلمة الأصول لا يحكون الخلاف فيها إلا مع المعتزلة، ويذكرون أن أصل الخلاف فيها راجع إلى مسألة التكليف بما لا يطاق، وممن ذكر هذا الباقلاني، والجويني، والطوفي في كتابه درء القول القبيح، والناظم -جزاه الله عنا خير الجزاء وغفر له ورحمه- تابع في إيرادها متكلمة الأصول، وهذه المسائل قد يتصور الذهن أنها مسائل أصولية، وأن لها أصول صحيحة كتأخر المخصص عن اللفظ العام، وتأخير تبيين اللفظ المجمل، وتأخر الناسخ عن المنسوخ، والعمل باللفظ العام قبل البحث عن المخصص، وهي مسائل واقعة في الشريعة، إلا أن في ذكر هاتين المسألتين في علم الأصول وفي بناء المسائل الأصولية الصحيحة عليها إشكال من جهات:
الجهة الأولى: أن البيان إنما يكون من جهة الله -عز وجل-، ثم كلّف به نبيه -صلى الله عليه وسلم-، وأفعال الله -عز وجل- لا تجري عليها أحكام الأصول، ولا يقال يجوز على الله تأخير البيان أو لا يجوز، وقد تقدم أن الكلام فيما يجوز على الله وما لا يجوز هو أصل الانحراف في مسائل الأسماء والصفات ومسائل القدر، فلا يجيز ولا يوجب على الله إلا الله، بل لا يسأل -عز وجل- عما يفعل، وأما نبيه -صلى الله عليه وسلم- فنشهد أنه قد أدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، فالكلام عن تقديم البيان وتأخيره ليس من العلم الشرعي في شيء، وإنما هي مسائل كلامية خاض فيها المتكلمون بغير هدى من الله، وقد جعل الشافعي عماد كتاب الرسالة لتوضيح البيان ولم يتكلم عن هاتين المسألتين.
الجهة الثانية: أن الشريعة لم تخاطب المكلفين بالخطاب المجمل قط، وأما الألفاظ التي يُزعم أنها مجملة فإنما عرض لها الإجمال من جهة فكرة الوضع الأول، وإذا فسرت بما تدل عليها سياقاتها التي جاءت فيها أو سياقات الشريعة الأخرى فإن معانيها ستتضح، وسيزول عنها ما عرض لها من غموض، فالقول بأن الشريعة خاطبت المكلفين باللفظ المجمل، ثم بعد ذلك خاطبتهم بما يبين الإجمال قول غير وارد أصلا، وقد أشار إلى قريب من هذا ابن رشد الحفيد في كتابه الضروري.
الجهة الثالثة: أن في جعل تأخر المخصص عن اللفظ العام، وتأخر الناسخ عن الحكم المنسوخ، والعمل بالعام قبل البحث عن المخصص في جعل هذه الأمور من صور تأخر البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة إشكال كبير؛ لأن ذلك يعني أن اللفظ العام قبل تخصيصه من المجمل الذي لا يعمل به، وأن الحكم المنسوخ قبل ورود الناسخ من المجمل الذي لا يعمل به، وأن العام لا يعمل به قبل البحث عن المخصص؛ لاحتمال أن يكون مخصوصا، فيصبح من المجمل الذي لا يعمل به، وهذا خُلف من القول لم يقل به إلا الواقفية منكروا الصيغ.
الجهة الرابعة: إن كان المقصود بالبيان في هاتين المسألتين البيان الأول فإنه يشكل عليه -مع المذكور في الجهة الأولى- أن البيان قد لا يصل لجميع المكلفين في ذات الوقت مع كونهم في أمس الحاجة إلى بيان ما يعتقدونه من الإيمان والتوحيد، فكيف ينقل الإجماع على عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة وعدم وقوعه، ثم إن كان مقصود البيان لا يحصل إلا مع الإمهال والتدرج، فكيف يقال لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهذا المذكور هو فحوى نقد ابن تيمية الحفيد لدعوى الإجماع على عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وبالله التوفيق.
ولا يجوز في البيان أن يُرى*عن وقت حاجة له مؤخرا.
وجوزوا التأخير بالإطلاق*عن زمن الخطاب باتفاق.
يتكلم الناظم في هذه الأبيات عن مسألتين: الأولى تأخير البيان عن وقت الحاجة، والثانية تأخيره عن وقت الخطاب، وهذه مسائل فرعت على خلاف نفاة القدر مع الجبرية في التكليف بما لا يطاق، فمن جوّز التكليف بما لا يطاق قال: بأن البيان يجوز أن يتأخر عن وقت الحاجة، ومن منع قال لا يجوز، والذين قالوا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة اختلفوا: فمنهم من قال يجوز أن يتأخر عن وقت الخطاب، ومنهم من منع، ومتقدمي متكلمة الأصول لا يحكون الخلاف فيها إلا مع المعتزلة، ويذكرون أن أصل الخلاف فيها راجع إلى مسألة التكليف بما لا يطاق، وممن ذكر هذا الباقلاني، والجويني، والطوفي في كتابه درء القول القبيح، والناظم -جزاه الله عنا خير الجزاء وغفر له ورحمه- تابع في إيرادها متكلمة الأصول، وهذه المسائل قد يتصور الذهن أنها مسائل أصولية، وأن لها أصول صحيحة كتأخر المخصص عن اللفظ العام، وتأخير تبيين اللفظ المجمل، وتأخر الناسخ عن المنسوخ، والعمل باللفظ العام قبل البحث عن المخصص، وهي مسائل واقعة في الشريعة، إلا أن في ذكر هاتين المسألتين في علم الأصول وفي بناء المسائل الأصولية الصحيحة عليها إشكال من جهات:
الجهة الأولى: أن البيان إنما يكون من جهة الله -عز وجل-، ثم كلّف به نبيه -صلى الله عليه وسلم-، وأفعال الله -عز وجل- لا تجري عليها أحكام الأصول، ولا يقال يجوز على الله تأخير البيان أو لا يجوز، وقد تقدم أن الكلام فيما يجوز على الله وما لا يجوز هو أصل الانحراف في مسائل الأسماء والصفات ومسائل القدر، فلا يجيز ولا يوجب على الله إلا الله، بل لا يسأل -عز وجل- عما يفعل، وأما نبيه -صلى الله عليه وسلم- فنشهد أنه قد أدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، فالكلام عن تقديم البيان وتأخيره ليس من العلم الشرعي في شيء، وإنما هي مسائل كلامية خاض فيها المتكلمون بغير هدى من الله، وقد جعل الشافعي عماد كتاب الرسالة لتوضيح البيان ولم يتكلم عن هاتين المسألتين.
الجهة الثانية: أن الشريعة لم تخاطب المكلفين بالخطاب المجمل قط، وأما الألفاظ التي يُزعم أنها مجملة فإنما عرض لها الإجمال من جهة فكرة الوضع الأول، وإذا فسرت بما تدل عليها سياقاتها التي جاءت فيها أو سياقات الشريعة الأخرى فإن معانيها ستتضح، وسيزول عنها ما عرض لها من غموض، فالقول بأن الشريعة خاطبت المكلفين باللفظ المجمل، ثم بعد ذلك خاطبتهم بما يبين الإجمال قول غير وارد أصلا، وقد أشار إلى قريب من هذا ابن رشد الحفيد في كتابه الضروري.
الجهة الثالثة: أن في جعل تأخر المخصص عن اللفظ العام، وتأخر الناسخ عن الحكم المنسوخ، والعمل بالعام قبل البحث عن المخصص في جعل هذه الأمور من صور تأخر البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة إشكال كبير؛ لأن ذلك يعني أن اللفظ العام قبل تخصيصه من المجمل الذي لا يعمل به، وأن الحكم المنسوخ قبل ورود الناسخ من المجمل الذي لا يعمل به، وأن العام لا يعمل به قبل البحث عن المخصص؛ لاحتمال أن يكون مخصوصا، فيصبح من المجمل الذي لا يعمل به، وهذا خُلف من القول لم يقل به إلا الواقفية منكروا الصيغ.
الجهة الرابعة: إن كان المقصود بالبيان في هاتين المسألتين البيان الأول فإنه يشكل عليه -مع المذكور في الجهة الأولى- أن البيان قد لا يصل لجميع المكلفين في ذات الوقت مع كونهم في أمس الحاجة إلى بيان ما يعتقدونه من الإيمان والتوحيد، فكيف ينقل الإجماع على عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة وعدم وقوعه، ثم إن كان مقصود البيان لا يحصل إلا مع الإمهال والتدرج، فكيف يقال لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهذا المذكور هو فحوى نقد ابن تيمية الحفيد لدعوى الإجماع على عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وبالله التوفيق.