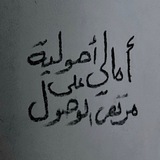قال ابنُ عاصمٍ الغرناطيُّ، سقى الله قبره غواديَ رحمةٍ وروائح نَعمةٍ:
ولُغةُ العُرْبِ لها امتيازُ :: ببدئِها، والمنتهى الإعجازُ
مرادُه بهٰذا البيتِ الدَّلالةُ علىٰ مكانةِ اللّغةِ العربيّةِ الّتي بها نزَل القرآنُ العزيزُ، مِن بين سائرِ اللّغات، ومنزلتِها البيانيّة المرموقةِ الّتي هي بها حَظِيةٌ، أنّها لغةٌ راقيةٌ شريفةٌ، في ألفاظِها وتراكيبِها وأساليبِها، باعتدالِ أحرفِها، وجمالِ مخارِجِها، وصفاتِها، وسهولةِ نطقِها، وحسنِ تأليفِ كَلِمِها، ومفارقتِها للكزِّ، واللَّوك، والمضغِ، وسائرِ عيوبِ المنطق، ووفرةِ موادِّها، وكثرةِ تصاريفِها، وتلوّنِ أساليبِها، واتّساعِ أحكامِها اللّفظيّة، وعوارضِها المعنويّة، وتفنُّن أغراضها، ومراعاتها للمقامات المختلفة، وابتنائِها على الذّكاءِ، والحلاوة، والفخامة، والقوّة، والسّهولة، والذّلاقة، والمواءمة، وانضباطِ الإعرابِ بالحركاتِ، والدّلالة على المعاني الكثيرةِ بالألفاظِ القليلة، واستيفاء التّراكيب، وسائر ما هو مِن معايير الفصاحة، وطُرُقات البلاغة.
فأهلُ العربيّةِ، وإن تفاوتوا في البلاغةِ، بتفاوتهم في الاقتدارِ، وفي حيازةِ أسبابِ البيانِ وموادِّه ووجوهِه، هم كلُّهم مشتركون في قدرٍ مِن الحسنِ متميِّزون به عن سائرِ النّاطقين مِن أهل اللّغاتِ الأخرىٰ، بمثلِ ما ذكَرْنا مِن وجوهٍ. فأدنىٰ مستوياتها مرتبةً هو محتوٍ على الفصاحة، وفيه مِن البلاغةِ قدرٌ هو مفارقٌ به سائرَ الألسنة.
ولا تزالُ البلاغةُ العربيّةُ تعلو بالمتكلِّمين بها رتبةً، فرتبةً، بحسنِ الانسجام، والمناسبةِ للمحلِّ، والإيجاز، وحسنِ التّخلُّص، والانتقال، والتّنبيه، والدَّلالة، وسائر النّكات، حتّىٰ تبلُغَ أمدًا أقصىٰ، ومنتهًى أعلىٰ، حيث تُناطحُ السّحاب، بل تسمو فوقه مقاماتٍ عالياتٍ، فلا يدنو منها شيءٌ، ولا يبلغُها ناطقٌ مهما حاول، بل لا يطاولُها الخلقُ أن يأتوا بمثلِها، ولو اجتمعوا، لا لفظًا، ولا نظمًا، ولا معنًى، ولا هدايةً، ولا نورًا، ولا تعليمًا، ولا تزكيةً، ولا قصَصًا، ولا حكمًا، ولا خبرًا، وإنّما يُذعِنون بالعجزِ، ويسلِّمون للقصورِ، ويعلمون أن لا قِبَلَ ولا حِيَل ولا طِيَل، وتلك رُتبةُ كلامِ اللهِ العزيزِ المعجِز.
وهٰذا هو معنىٰ قولِه: (ولغةُ العُرْب لها امتيازٌ ببدئِها)، فجعَل للعرَبيّةِ مستوَياتٍ ومراتبَ تتفاوتُ حسنًا وجمالًا وجلالًا، لها بدءٌ ومنتهًى، وأدنىٰ وأعلىٰ، وجعَل أوّلها: امتيازًا عن سائرِ اللّغاتِ، بما شرَحْنا مِن المميّزاتِ.
وأمّا المرتبةُ العُليا مِن مراتِبِ الأساليبِ العربيّةِ الّتي هي مرتبةُ الإعجازِ، الّذي عليه كلامُ اللهِ : فطائرةٌ بعيدةُ المنالِ، لا يرومُها بشرٌ، ولا يقدرُ عليها مخلوقٌ. وإلىٰ هٰذا أشار بقولِه: (والمنتهى الإعجازُ) أي: منتهىٰ مراتبِ العربيّةِ الإعجازُ الّذي هو خارجٌ عن طوقِ البشَر، وهو وصفُ كلامِ اللهِ سبحانه.
وبين هاتين المرتبتين مراتبُ كثيرةٌ، لا يعلمُها إلّا الّذي خلَق البشَر، وخلَق فيهم النّطقَ، وعلَّمهم البيانَ، وأودعهم الحكمةَ، وألهمهم المعانيَ، وحرَّك فيهم المشاعر.
فهٰذا المعنى المشروحُ لم يُتَحْ للسانٍ غير لسانِ العرَب أن يصيبَ منه ما أصاب، فلا جرَم أن تبوَّأَ لسانُ العرَب مَنصِبَ أن نزَل به كلامُ اللهِ المبين، وحسبُه بذٰلك فخرًا، وشرَفًا، وعزّةً، وتِيهًا.
وغرَضُ النّاظمِ مِن وراءِ إلقاءِ هٰذا المعنىٰ هنا أمران:
الأوّلُ: التّنويهُ بهٰذا اللّسانِ المبين، ليُبجَّلَ، ويُفخَّمَ، ويُعتنَىٰ به، ويؤاخىٰ بين تعلُّمه وتعلُّم الوحي الشّريف الّذي لا يُفهَم إلّا بفهمِه.
والآخِر: بيانُ منزلةِ القرآنِ مِن بين سائرِ الكلامِ العربيّ، أنّه أفخمُ شيءٍ، وأرفعُ شيءٍ، وأجلُّ شيءٍ، وأتمُّ شيءٍ، ومَن بصُر بذٰلك وفَهِمه: أَنزَله مَنزِلتَه، وعرَف كيف يأتيه.
وكِلا هٰذين المعنيين قد تقدَّم في النِّظامِ ما يمهِّد له، إذْ بيَّن أنّ القرآنَ منزلٌ بلسانٍ عربيٍّ مبينٍ، وأنّه مشتملٌ علىٰ ضروبِ الدَّلالاتِ الّتي تعرفُها العربُ، نطقًا، ومفهومًا، واقتضاءً، وغير ذٰلك، فعاد ههنا وبيَّن شرَف ذٰلك اللّسان، وشرَف الوظيفة اللّغويّة الّتي كان عليها، وحظَّ القرآنِ الكريمِ منها أنّه في أعلىٰ مستوًى شاردٍ غيرِ ممسوسٍ.
ولا يزالُ بعدُ يُدخِلُ علىٰ المعنىٰ مِن المعاني ما ينسلكُ في سِلكِه، ويزيدُه صحّةً، ووضوحًا، ويكشفُ عن وجوهِه، ويبينُ عن معانيه، ويرفعُ مِن مَقامِه في النّفوسِ، حتّىٰ يبلغَ مبلغَ أن يأتيَ بحاصلِ المرادِ ويصرِّحَ به فيقولَ:
فهْو علىٰ نهجِ كلامِ العرَبِ :: فاسلُكْ به سبيلَ ذاك تُصِبِ
ومَن يرُمْ فهمَ كلامِ اللهِ :: بغيره اعتدّ بأصلٍ واهي
ولُغةُ العُرْبِ لها امتيازُ :: ببدئِها، والمنتهى الإعجازُ
مرادُه بهٰذا البيتِ الدَّلالةُ علىٰ مكانةِ اللّغةِ العربيّةِ الّتي بها نزَل القرآنُ العزيزُ، مِن بين سائرِ اللّغات، ومنزلتِها البيانيّة المرموقةِ الّتي هي بها حَظِيةٌ، أنّها لغةٌ راقيةٌ شريفةٌ، في ألفاظِها وتراكيبِها وأساليبِها، باعتدالِ أحرفِها، وجمالِ مخارِجِها، وصفاتِها، وسهولةِ نطقِها، وحسنِ تأليفِ كَلِمِها، ومفارقتِها للكزِّ، واللَّوك، والمضغِ، وسائرِ عيوبِ المنطق، ووفرةِ موادِّها، وكثرةِ تصاريفِها، وتلوّنِ أساليبِها، واتّساعِ أحكامِها اللّفظيّة، وعوارضِها المعنويّة، وتفنُّن أغراضها، ومراعاتها للمقامات المختلفة، وابتنائِها على الذّكاءِ، والحلاوة، والفخامة، والقوّة، والسّهولة، والذّلاقة، والمواءمة، وانضباطِ الإعرابِ بالحركاتِ، والدّلالة على المعاني الكثيرةِ بالألفاظِ القليلة، واستيفاء التّراكيب، وسائر ما هو مِن معايير الفصاحة، وطُرُقات البلاغة.
فأهلُ العربيّةِ، وإن تفاوتوا في البلاغةِ، بتفاوتهم في الاقتدارِ، وفي حيازةِ أسبابِ البيانِ وموادِّه ووجوهِه، هم كلُّهم مشتركون في قدرٍ مِن الحسنِ متميِّزون به عن سائرِ النّاطقين مِن أهل اللّغاتِ الأخرىٰ، بمثلِ ما ذكَرْنا مِن وجوهٍ. فأدنىٰ مستوياتها مرتبةً هو محتوٍ على الفصاحة، وفيه مِن البلاغةِ قدرٌ هو مفارقٌ به سائرَ الألسنة.
ولا تزالُ البلاغةُ العربيّةُ تعلو بالمتكلِّمين بها رتبةً، فرتبةً، بحسنِ الانسجام، والمناسبةِ للمحلِّ، والإيجاز، وحسنِ التّخلُّص، والانتقال، والتّنبيه، والدَّلالة، وسائر النّكات، حتّىٰ تبلُغَ أمدًا أقصىٰ، ومنتهًى أعلىٰ، حيث تُناطحُ السّحاب، بل تسمو فوقه مقاماتٍ عالياتٍ، فلا يدنو منها شيءٌ، ولا يبلغُها ناطقٌ مهما حاول، بل لا يطاولُها الخلقُ أن يأتوا بمثلِها، ولو اجتمعوا، لا لفظًا، ولا نظمًا، ولا معنًى، ولا هدايةً، ولا نورًا، ولا تعليمًا، ولا تزكيةً، ولا قصَصًا، ولا حكمًا، ولا خبرًا، وإنّما يُذعِنون بالعجزِ، ويسلِّمون للقصورِ، ويعلمون أن لا قِبَلَ ولا حِيَل ولا طِيَل، وتلك رُتبةُ كلامِ اللهِ العزيزِ المعجِز.
وهٰذا هو معنىٰ قولِه: (ولغةُ العُرْب لها امتيازٌ ببدئِها)، فجعَل للعرَبيّةِ مستوَياتٍ ومراتبَ تتفاوتُ حسنًا وجمالًا وجلالًا، لها بدءٌ ومنتهًى، وأدنىٰ وأعلىٰ، وجعَل أوّلها: امتيازًا عن سائرِ اللّغاتِ، بما شرَحْنا مِن المميّزاتِ.
وأمّا المرتبةُ العُليا مِن مراتِبِ الأساليبِ العربيّةِ الّتي هي مرتبةُ الإعجازِ، الّذي عليه كلامُ اللهِ : فطائرةٌ بعيدةُ المنالِ، لا يرومُها بشرٌ، ولا يقدرُ عليها مخلوقٌ. وإلىٰ هٰذا أشار بقولِه: (والمنتهى الإعجازُ) أي: منتهىٰ مراتبِ العربيّةِ الإعجازُ الّذي هو خارجٌ عن طوقِ البشَر، وهو وصفُ كلامِ اللهِ سبحانه.
وبين هاتين المرتبتين مراتبُ كثيرةٌ، لا يعلمُها إلّا الّذي خلَق البشَر، وخلَق فيهم النّطقَ، وعلَّمهم البيانَ، وأودعهم الحكمةَ، وألهمهم المعانيَ، وحرَّك فيهم المشاعر.
فهٰذا المعنى المشروحُ لم يُتَحْ للسانٍ غير لسانِ العرَب أن يصيبَ منه ما أصاب، فلا جرَم أن تبوَّأَ لسانُ العرَب مَنصِبَ أن نزَل به كلامُ اللهِ المبين، وحسبُه بذٰلك فخرًا، وشرَفًا، وعزّةً، وتِيهًا.
وغرَضُ النّاظمِ مِن وراءِ إلقاءِ هٰذا المعنىٰ هنا أمران:
الأوّلُ: التّنويهُ بهٰذا اللّسانِ المبين، ليُبجَّلَ، ويُفخَّمَ، ويُعتنَىٰ به، ويؤاخىٰ بين تعلُّمه وتعلُّم الوحي الشّريف الّذي لا يُفهَم إلّا بفهمِه.
والآخِر: بيانُ منزلةِ القرآنِ مِن بين سائرِ الكلامِ العربيّ، أنّه أفخمُ شيءٍ، وأرفعُ شيءٍ، وأجلُّ شيءٍ، وأتمُّ شيءٍ، ومَن بصُر بذٰلك وفَهِمه: أَنزَله مَنزِلتَه، وعرَف كيف يأتيه.
وكِلا هٰذين المعنيين قد تقدَّم في النِّظامِ ما يمهِّد له، إذْ بيَّن أنّ القرآنَ منزلٌ بلسانٍ عربيٍّ مبينٍ، وأنّه مشتملٌ علىٰ ضروبِ الدَّلالاتِ الّتي تعرفُها العربُ، نطقًا، ومفهومًا، واقتضاءً، وغير ذٰلك، فعاد ههنا وبيَّن شرَف ذٰلك اللّسان، وشرَف الوظيفة اللّغويّة الّتي كان عليها، وحظَّ القرآنِ الكريمِ منها أنّه في أعلىٰ مستوًى شاردٍ غيرِ ممسوسٍ.
ولا يزالُ بعدُ يُدخِلُ علىٰ المعنىٰ مِن المعاني ما ينسلكُ في سِلكِه، ويزيدُه صحّةً، ووضوحًا، ويكشفُ عن وجوهِه، ويبينُ عن معانيه، ويرفعُ مِن مَقامِه في النّفوسِ، حتّىٰ يبلغَ مبلغَ أن يأتيَ بحاصلِ المرادِ ويصرِّحَ به فيقولَ:
فهْو علىٰ نهجِ كلامِ العرَبِ :: فاسلُكْ به سبيلَ ذاك تُصِبِ
ومَن يرُمْ فهمَ كلامِ اللهِ :: بغيره اعتدّ بأصلٍ واهي
وهو في هٰذا الغرَض وما بين يديه وما خلفه يتابعُ شيخَه أبا إسحاق الشّاطبيَّ في مقدّماتِ «الموافقات»، وقد كان مِن المعاني الّتي افترعها، وثوَّرها فأحسن التّثوير، وبدَأ فيها وعاد: تقريرُ أنّ هٰذه الشّريعةَ عربيّةٌ، ليُستعَدَّ لها بطريقِ اللّغةِ القويم، ويُتلقَّىٰ فهمُها كما تُخرِجه العربيّةُ مِن أكمامِها مِن ثمراتٍ، وما تجوزُ إلى المقاصدِ مِن غَمَرات، وإنّما حمله علىٰ ذٰلك أن يَشُقَّ معناه، ويذهب في تصحيحِه: ما رأىٰ مِن إعراضِ جمهورِ المتعلِّمين عنها، وتقصيرِهم بحقِّها تقصيرًا حجَب عنهم المراد، وشغَلهم بالطِّراد، واستبدلوا ببهائِها عجميّةً منكرةً، فسَد بها الفهمُ، وضاع الاستنباطُ.
والله أعلم.
والله أعلم.
قال ابن عاصم:
كذاك ما للعُرْبِ من مقاصد*موجودةٌ فيه لدى الموارد.
مثلُ الكنايات عن الأشياء*والنص والإجمال والإيماء.
في هذه الأبيات يتابع الناظم تفريعاته على ما ذكر من أن القرآن نزل بلسان عربي، فيذكر أن مقاصد كلام العرب موجودة فيه، ثم بدأ بتعدادها بهذا الترتيب:
أولا: أنه تجري فيه الكناية عن بعض الأشياء: ويقصد بالكناية ترك التصريح بالمعنى المقصود والإيماء إليه بلازمه أو ما يقترن به غالبا، ومن الكنايات الواقعة في القرآن الكناية عن الجماع بالملامسة، والكناية عن السرور بقرة العين، والكناية عن العقاب بالتوعد بالسؤال، والكناية عن الإهانة بالسحب على الوجوه، وغيرها كثير.
ثانيا: أنه يجري فيه النص على معنى بحيث لا يحتمل اللفظ معنا آخر، ومن النصوص الواردة في القرآن: الأمر بالإنصات عند قراءة القرآن؛ فإن هذا الأمر لا يحتمل معنا آخر غير الأمر بالإنصات، وهكذا تحديد عدة الوفاة بأربعة أشهر وعشرا؛ فإن تحديد هذا العدد لا يحتمل أقل منه ولا أكثر.
ثالثا: أنه يجري فيه الإجمال؛ والإجمال في اللفظ هو حاجته إلى توضيح وتبيين، والإجمال من المعاني المشتركة بين الأصول والبلاغة، وهو يجري في كلام البلغاء لأغراض عديدة منها: أنه يأتي لتوضيح الصورة العامة للكلام؛ فيكون في أول الكلام إجمال لما يفصل بعده، حتى يحصل التصور العام للمعنى لدى المستمع قبل تفصيله، ومنها أنه يأتي للتشويق وجذب الانتباه؛ يقول العلامة حسن اسماعيل عبدالرزاق: (ولا ريب أن الإيضاح بعد الإبهام أو التفصيل بعد الإجمال أوقع في النفس لما هو مركوز في الطباع من أن إبهام الشيء أو إجماله مما يشوق إلى إيضاحه وتفصيله)، ومن أمثلته في القرآن ما جاء في خطبة مؤمن ال فرعون: {وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد} يقول ابن عاشور في تفسير هذه الآية: (رتب خطبته على أسلوب تقديم الإجمال ثم تعقيبه بالتفصيل، فابتدأ بقوله: اتبعون أهدكم سبيل الرشاد، وسبيل الرشاد مجمل وهو على إجماله مما تتوق إليه النفوس، فربط حصوله باتباعهم إياه مما يقبل بهم على تلقي ما يفسر هذا السبيل، ويسترعي أسماعهم إلى ما يقوله إذ لعله سيأتيهم بما ترغبه أنفسهم إذ قد يظنون أنه نقح رأيه ونخل مقاله وأنه سيأتي بما هو الحق الملائم لهم).
رابعا: أنه يجرى فيه الإيماء، والإيماء أيضا من المصطلحات المشتركة بين العلوم، وهي أيضا من المصطلحات الواسعة، وليست من المصطلحات المحكمة المعاني كالنص والمجمل، وغالب استعمال المتقدمين لها أن يستعملوها في الاشارة الى المعانى بطرق خفية غير صريحة، وهذا الاستعماله تجده مشترك بين الاطلاق الاصولي والبلاغي فإن الأصوليين يطلقونها على المعاني التي تستفاد من التعليق بالأوصاف، والبلاغيين يستعملونها غالبا فيما يشبه الكناية القريبة، وهذه الاستعمالات كما ترى كلها داخلة تحت الاشارة الى المعاني بطرق خفية غير صريحة، ومن أمثلتها في القرآن قوله تعالى { حم (1) تنزيل من الرحمن الرحيم (2) كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون (3)} ذكر ابن عاشور أن في إيثار الصفتين الرحمن الرحيم على غيرهما من الصفات إيماء إلى أن هذا التنزيل رحمة من الله بعباده ليخرجهم من الظلمات إلى النور و إيماء إلى استحماق الذين أعرضوا عن الاهتداء بهذا الكتاب بأنهم أعرضوا عن الرحمة.
وتأتي بقية المقاصد بإذن الله، وبالله التوفيق.
كذاك ما للعُرْبِ من مقاصد*موجودةٌ فيه لدى الموارد.
مثلُ الكنايات عن الأشياء*والنص والإجمال والإيماء.
في هذه الأبيات يتابع الناظم تفريعاته على ما ذكر من أن القرآن نزل بلسان عربي، فيذكر أن مقاصد كلام العرب موجودة فيه، ثم بدأ بتعدادها بهذا الترتيب:
أولا: أنه تجري فيه الكناية عن بعض الأشياء: ويقصد بالكناية ترك التصريح بالمعنى المقصود والإيماء إليه بلازمه أو ما يقترن به غالبا، ومن الكنايات الواقعة في القرآن الكناية عن الجماع بالملامسة، والكناية عن السرور بقرة العين، والكناية عن العقاب بالتوعد بالسؤال، والكناية عن الإهانة بالسحب على الوجوه، وغيرها كثير.
ثانيا: أنه يجري فيه النص على معنى بحيث لا يحتمل اللفظ معنا آخر، ومن النصوص الواردة في القرآن: الأمر بالإنصات عند قراءة القرآن؛ فإن هذا الأمر لا يحتمل معنا آخر غير الأمر بالإنصات، وهكذا تحديد عدة الوفاة بأربعة أشهر وعشرا؛ فإن تحديد هذا العدد لا يحتمل أقل منه ولا أكثر.
ثالثا: أنه يجري فيه الإجمال؛ والإجمال في اللفظ هو حاجته إلى توضيح وتبيين، والإجمال من المعاني المشتركة بين الأصول والبلاغة، وهو يجري في كلام البلغاء لأغراض عديدة منها: أنه يأتي لتوضيح الصورة العامة للكلام؛ فيكون في أول الكلام إجمال لما يفصل بعده، حتى يحصل التصور العام للمعنى لدى المستمع قبل تفصيله، ومنها أنه يأتي للتشويق وجذب الانتباه؛ يقول العلامة حسن اسماعيل عبدالرزاق: (ولا ريب أن الإيضاح بعد الإبهام أو التفصيل بعد الإجمال أوقع في النفس لما هو مركوز في الطباع من أن إبهام الشيء أو إجماله مما يشوق إلى إيضاحه وتفصيله)، ومن أمثلته في القرآن ما جاء في خطبة مؤمن ال فرعون: {وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد} يقول ابن عاشور في تفسير هذه الآية: (رتب خطبته على أسلوب تقديم الإجمال ثم تعقيبه بالتفصيل، فابتدأ بقوله: اتبعون أهدكم سبيل الرشاد، وسبيل الرشاد مجمل وهو على إجماله مما تتوق إليه النفوس، فربط حصوله باتباعهم إياه مما يقبل بهم على تلقي ما يفسر هذا السبيل، ويسترعي أسماعهم إلى ما يقوله إذ لعله سيأتيهم بما ترغبه أنفسهم إذ قد يظنون أنه نقح رأيه ونخل مقاله وأنه سيأتي بما هو الحق الملائم لهم).
رابعا: أنه يجرى فيه الإيماء، والإيماء أيضا من المصطلحات المشتركة بين العلوم، وهي أيضا من المصطلحات الواسعة، وليست من المصطلحات المحكمة المعاني كالنص والمجمل، وغالب استعمال المتقدمين لها أن يستعملوها في الاشارة الى المعانى بطرق خفية غير صريحة، وهذا الاستعماله تجده مشترك بين الاطلاق الاصولي والبلاغي فإن الأصوليين يطلقونها على المعاني التي تستفاد من التعليق بالأوصاف، والبلاغيين يستعملونها غالبا فيما يشبه الكناية القريبة، وهذه الاستعمالات كما ترى كلها داخلة تحت الاشارة الى المعاني بطرق خفية غير صريحة، ومن أمثلتها في القرآن قوله تعالى { حم (1) تنزيل من الرحمن الرحيم (2) كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون (3)} ذكر ابن عاشور أن في إيثار الصفتين الرحمن الرحيم على غيرهما من الصفات إيماء إلى أن هذا التنزيل رحمة من الله بعباده ليخرجهم من الظلمات إلى النور و إيماء إلى استحماق الذين أعرضوا عن الاهتداء بهذا الكتاب بأنهم أعرضوا عن الرحمة.
وتأتي بقية المقاصد بإذن الله، وبالله التوفيق.
قال ابن عاصم:
والأخذِ بالمفهوم أو تعطيله*والتركِ للمنطوق معْ تأصيله.
والقصد للمجاز والإيهام*والحذف والإضمار والإقحام.
يستكمل الناظم في هذه الأبيات بقية المقاصد:
المقصد الخامس: الأخذ بالمفهوم أو تعطيله: المفهوم سبق تعريفه وتفصيله في مقدمات النظم، وخلاصته أن المفهوم هو دلالة تقييد الحكم بوصف يفهم منه نفي الحكم عما سواه، والمفهوم في كلام العرب يعمل به في غالب أنواعه عدا مفهوم اللقب، ولا يعمل به إذا خرج مخرج الغالب، أو سيق للمبالغه، أو ظهرت له فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه، وقد تقدم ذكر ذلك مفصلا، وهكذا القران يعمل بمفهومه إذا لم يخرج مخرج الغالب، أو يساق للمبالغة، أو تظهر له فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه.
ومثال ما أخذ مفهومه قوله تعالى: { ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا } فمفهوم قوله تعالى: (وهو مؤمن) أن من عمل الصالحات ولم يؤمن أنه غير موعود بهذا الوعد،
ومثال ما عطل مفهومه: { إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين} فمفهوم العدد هنا لم يؤخذ به؛ لأنه سيق للمبالغة بدليل التعليل الذي تلاه، فلذلك لم يستغفر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من سبعين مرة.
المقصد السادس: ترك المنطوق مع أنه الأصل: وهذا يكون فيما إذا خصص المنطوق، أو كان مجملا، أو نسخ حكمه وترك لفظه، أو عرض له عارض من عوارض الألفاظ الأخرى فيعطل منطوقه، ويصح أن يمثل له بأمثلة المجمل، وما نسخ حكمه دون لفظه، والعام المخصوص، وكذلك العام الذي أريد به الخصوص، وهكذا.
المقصد السابع: المجاز، وقد تقدم مفصلا بما يغني عن إعادته.
المقصد الثامن: أنه يجري فيه الإيهام؛ وهو التورية، وهي أن يقصد بالكلام معناه البعيد غير المتبادر ليوهم المتكلم أنه يقصد المعنى القريب المتبادر، وأمثلته في القرآن قليلة ومنها قوله تعالى: {وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون} يقول ابن عاشور: (ومن رشاقة لفظ الآيات هنا أن فيه تورية بآيات الطريق التي يهتدي بها السائر)، ومثل قوله تعالى: {أين شركاءى الذين كنتم تشاقون فيهم} يقول ابن عاشور: (في هذا القول إيهام أن شفعاءهم موجودون سوى أنهم لم يحضروا...وفي ذلك زيادة في التهكم).
المقصد التاسع: أنه يجري فيه الحذف، وسألخص لك ما قاله فليسوف العربية ابن جني فهو كاف في ذلك، يقول رحمه الله في كلامه عن شجاعة العربية: (أن العرب تحذف الجملة والمفرد والحرف والحركة, وليس شيء من ذلك إلا عن دليل عليه, وإلا كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب في معرفته. فأما الجملة فنحو قولهم في القسم: والله لا فعلت، وأصله أقسم بالله، وقد حذفت الجملة من الخبر نحو قولك: القرطاس والله، أي: أصاب القرطاس، وكذلك الشرط في نحو قوله: الناس مجزيون بأفعالهم إن خيرا فخيرا، وإن شرا فشرا، أي: إن فعل المرء خيرا جزي خيرا، وإن فعل شرا جزي شرا، وعليه قول الله سبحانه: {فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا} أي: فضرب فانفجرت، وقوله عز اسمه: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية} أي: فحلق فعليه فدية،
وأما حذف المفرد فعلى ثلاثة أضرب: اسم وفعل وحرف،
فأما حذف الأسم فكقوله -عز وجل: {كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ} أي: ذلك أو هذا بلاغ، وقوله{ولكن البر من اتقى} أي: بر من اتقى، وقوله {فقبضت قبضة من أثر الرسول} أي: من تراب أثر حافر فرس الرسول، وأما حذف الفعل فقوله تعالى: {إذا السماء انشقت} و {إذا الشمس كورت} و {إن امرؤ هلك} و {لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي} ونحوه الفعل فيه مضمر وحده، أي: إذا انشقت السماء، وإذا كورت الشمس، وإن هلك امرؤ، ولو تملكون.) انتهى ملخصا من عدة مواضع.
أما حذف الحروف فقد قال فيها في موضع آخر ما نصه: (أخبرنا أبو علي -رحمه الله- قال: قال أبو بكر: حذف الحروف ليس بالقياس. قال: وذلك أن الحروف إنما دخلت الكلام لضرب من الاختصار، فلو ذهبت تحذفها لكنت مختصرا لها هي أيضا، واختصار المختصر إجحاف به. تمت الحكاية) انتهى.
والأخذِ بالمفهوم أو تعطيله*والتركِ للمنطوق معْ تأصيله.
والقصد للمجاز والإيهام*والحذف والإضمار والإقحام.
يستكمل الناظم في هذه الأبيات بقية المقاصد:
المقصد الخامس: الأخذ بالمفهوم أو تعطيله: المفهوم سبق تعريفه وتفصيله في مقدمات النظم، وخلاصته أن المفهوم هو دلالة تقييد الحكم بوصف يفهم منه نفي الحكم عما سواه، والمفهوم في كلام العرب يعمل به في غالب أنواعه عدا مفهوم اللقب، ولا يعمل به إذا خرج مخرج الغالب، أو سيق للمبالغه، أو ظهرت له فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه، وقد تقدم ذكر ذلك مفصلا، وهكذا القران يعمل بمفهومه إذا لم يخرج مخرج الغالب، أو يساق للمبالغة، أو تظهر له فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه.
ومثال ما أخذ مفهومه قوله تعالى: { ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا } فمفهوم قوله تعالى: (وهو مؤمن) أن من عمل الصالحات ولم يؤمن أنه غير موعود بهذا الوعد،
ومثال ما عطل مفهومه: { إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين} فمفهوم العدد هنا لم يؤخذ به؛ لأنه سيق للمبالغة بدليل التعليل الذي تلاه، فلذلك لم يستغفر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من سبعين مرة.
المقصد السادس: ترك المنطوق مع أنه الأصل: وهذا يكون فيما إذا خصص المنطوق، أو كان مجملا، أو نسخ حكمه وترك لفظه، أو عرض له عارض من عوارض الألفاظ الأخرى فيعطل منطوقه، ويصح أن يمثل له بأمثلة المجمل، وما نسخ حكمه دون لفظه، والعام المخصوص، وكذلك العام الذي أريد به الخصوص، وهكذا.
المقصد السابع: المجاز، وقد تقدم مفصلا بما يغني عن إعادته.
المقصد الثامن: أنه يجري فيه الإيهام؛ وهو التورية، وهي أن يقصد بالكلام معناه البعيد غير المتبادر ليوهم المتكلم أنه يقصد المعنى القريب المتبادر، وأمثلته في القرآن قليلة ومنها قوله تعالى: {وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون} يقول ابن عاشور: (ومن رشاقة لفظ الآيات هنا أن فيه تورية بآيات الطريق التي يهتدي بها السائر)، ومثل قوله تعالى: {أين شركاءى الذين كنتم تشاقون فيهم} يقول ابن عاشور: (في هذا القول إيهام أن شفعاءهم موجودون سوى أنهم لم يحضروا...وفي ذلك زيادة في التهكم).
المقصد التاسع: أنه يجري فيه الحذف، وسألخص لك ما قاله فليسوف العربية ابن جني فهو كاف في ذلك، يقول رحمه الله في كلامه عن شجاعة العربية: (أن العرب تحذف الجملة والمفرد والحرف والحركة, وليس شيء من ذلك إلا عن دليل عليه, وإلا كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب في معرفته. فأما الجملة فنحو قولهم في القسم: والله لا فعلت، وأصله أقسم بالله، وقد حذفت الجملة من الخبر نحو قولك: القرطاس والله، أي: أصاب القرطاس، وكذلك الشرط في نحو قوله: الناس مجزيون بأفعالهم إن خيرا فخيرا، وإن شرا فشرا، أي: إن فعل المرء خيرا جزي خيرا، وإن فعل شرا جزي شرا، وعليه قول الله سبحانه: {فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا} أي: فضرب فانفجرت، وقوله عز اسمه: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية} أي: فحلق فعليه فدية،
وأما حذف المفرد فعلى ثلاثة أضرب: اسم وفعل وحرف،
فأما حذف الأسم فكقوله -عز وجل: {كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ} أي: ذلك أو هذا بلاغ، وقوله{ولكن البر من اتقى} أي: بر من اتقى، وقوله {فقبضت قبضة من أثر الرسول} أي: من تراب أثر حافر فرس الرسول، وأما حذف الفعل فقوله تعالى: {إذا السماء انشقت} و {إذا الشمس كورت} و {إن امرؤ هلك} و {لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي} ونحوه الفعل فيه مضمر وحده، أي: إذا انشقت السماء، وإذا كورت الشمس، وإن هلك امرؤ، ولو تملكون.) انتهى ملخصا من عدة مواضع.
أما حذف الحروف فقد قال فيها في موضع آخر ما نصه: (أخبرنا أبو علي -رحمه الله- قال: قال أبو بكر: حذف الحروف ليس بالقياس. قال: وذلك أن الحروف إنما دخلت الكلام لضرب من الاختصار، فلو ذهبت تحذفها لكنت مختصرا لها هي أيضا، واختصار المختصر إجحاف به. تمت الحكاية) انتهى.
المقصد العاشر: أنه يجري فيه الإضمار؛ والاضمار عند الأصوليين هو حذف ما يقتضيه المقام للعلم به، وهو الذي يستدلون عليه بالاقتضاء، وقد تقدم تفصيل ذلك، والذي يظهر أن الناظم لايقصد بالاضمار هنا المعنى الأصولي لأنه داخل في الحذف الذي تقدم قريبا، وإنما يقصد الاضمار البلاغي وهو ذكر الضمير في موضع الاسم الظاهر تعظيما وتفخيما، وهذا كثير في القران، انظر قوله تعالى: { نزل به الروح الأمين (193) على قلبك لتكون من المنذرين (194) بلسان عربي مبين (195) وإنه لفي زبر الأولين (196) أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل (197) ولو نزلناه على بعض الأعجمين (198) فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين (199) كذلك سلكناه في قلوب المجرمين (200) لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم (201)} المقصود بالضمير في كل هذه الآيات هو القرآن، ولم يجر له ذكر قبل، والضمير لا يعود إلا إلى متقدم، فعرفنا إذن أن الضمير أقيم هنا مقام الاسم الظاهر، وإنما أشير إلى القرآن بالضمير ولم يشير إليه باسمه، لأن هذه الأوصاف لا يمكن أن تكون إلا للقرآن، فهو لعظم أوصافه وشرف مكانته غني عن أن يعرّف باسمه إذا ذكرت أوصافه.
المقصد الحادي عشر: أنه يجري فيه الإقحام؛ وهذا من المصطلحات المترددة في الاستعمال عند المصنفين، والذي يظهر أن الناظم يريد به المعنى العام، ويمكن أن نصف هذا المعنى بأنه إدخال كلمة مختلفة بين كلمتين مترابطتين، أو إدخال جملة مختلفة بين جملتين مرابتطين، أو حتى إدخال حرف له معنى زائد بين كلام مترابط، وله أمثلة كثيرة في القرآن وإن لم يسمه المفسرون إقحاما، ومن أمثلته إدخال الممسوح بين المغسولات في آية الوضوء يقول جل ذكره {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين}، ومثل قوله تعالى { حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين (238) فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون (239) } فإنه داخل بين آيات النكاح والطلاق، وللمعلمي رسالة لطيفة في سبب هذا الإقحام يقول في آخرها: (وفي سَوقِ الكلام هذا المساقَ الذي يتراءى منه أنَّ آيتي الصلاة مقحمتان بين آيات النكاح: نكتة، وذلك أنَّ المعروف من سنَّة الكلام أنَّ المتكلِّم لا يقطع كلامه ما لم يتمَّ غرضُه، ولا يفصل بين أجزائه بكلام أجنبيٍّ إلَّا إذا عرض أمر مهم، كالخطيب يكون في أثناء خطبته، ثم يرى جماعةً يتكلمون، فيُقحم في خطبته كلامًا يتعلَّق بالزجر عن الكلام وقتَ سماع الخطبة، وبالجملة يبين بهذا أنَّ إقحام الحكيم كلامًا بين أجزاء كلامه إنما يكون لأهمية ذلك المقحَم. وإذ كان يتراءى من آيتي الصلاة أنهما مقحمتان، ففي ذلك دلالة عِظَمِ أهمية الصلاة؛ وهذا بحسب ما يتراءى، والله أعلم) انتهى، وبالله التوفيق.
المقصد الحادي عشر: أنه يجري فيه الإقحام؛ وهذا من المصطلحات المترددة في الاستعمال عند المصنفين، والذي يظهر أن الناظم يريد به المعنى العام، ويمكن أن نصف هذا المعنى بأنه إدخال كلمة مختلفة بين كلمتين مترابطتين، أو إدخال جملة مختلفة بين جملتين مرابتطين، أو حتى إدخال حرف له معنى زائد بين كلام مترابط، وله أمثلة كثيرة في القرآن وإن لم يسمه المفسرون إقحاما، ومن أمثلته إدخال الممسوح بين المغسولات في آية الوضوء يقول جل ذكره {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين}، ومثل قوله تعالى { حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين (238) فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون (239) } فإنه داخل بين آيات النكاح والطلاق، وللمعلمي رسالة لطيفة في سبب هذا الإقحام يقول في آخرها: (وفي سَوقِ الكلام هذا المساقَ الذي يتراءى منه أنَّ آيتي الصلاة مقحمتان بين آيات النكاح: نكتة، وذلك أنَّ المعروف من سنَّة الكلام أنَّ المتكلِّم لا يقطع كلامه ما لم يتمَّ غرضُه، ولا يفصل بين أجزائه بكلام أجنبيٍّ إلَّا إذا عرض أمر مهم، كالخطيب يكون في أثناء خطبته، ثم يرى جماعةً يتكلمون، فيُقحم في خطبته كلامًا يتعلَّق بالزجر عن الكلام وقتَ سماع الخطبة، وبالجملة يبين بهذا أنَّ إقحام الحكيم كلامًا بين أجزاء كلامه إنما يكون لأهمية ذلك المقحَم. وإذ كان يتراءى من آيتي الصلاة أنهما مقحمتان، ففي ذلك دلالة عِظَمِ أهمية الصلاة؛ وهذا بحسب ما يتراءى، والله أعلم) انتهى، وبالله التوفيق.
قال ابن عاصم:
والسَّوْقِ للمعلوم كالمجهول*لنكتة و اللَّحْظِ للتأويلِ.
والقصدِ للتخصيص في التعميم*وعكسِه وقس على المرسوم.
فهْو على نهج لسان العَرَبِ*فاسلك به سبيل ذاك تُصب.
ومن يَرم فهم كلام الله*بغيره اعتَدَّ بأصلٍ واهِ.
يستكمل الناظم في هذه الأبيات بقية مقاصد العربية التي اشتمل عليها القرآن:
المقصد الثاني عشر: أنه يساق فيه المعلوم مساق المجهول لفائدة: وهذا كثير في القرآن ومنه قوله تعالى {قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم} فهذا -على تقدير أنهم يعرفون ابراهيم- من سوق المعلوم مساق المجهول يلمحون إلى تحقير شأنه كما ذكر ابن عاشور، ومنه قوله تعالى: { فلما أتاها نُودي يا موسى} ذكر ابن عاشور أن الفعل (نودي) بني للمجهول مع أن المنادي معروف من كلامه الآتي لأجل تشويق السامع وجذب انتباهه، ومنها الآيات التي سيقت فيها الأفعال التي لا تكون إلا لله مساق المجهول كقوله {حُرمت عليكم}، {أُحِل لكم}، {قِيل يا أرض}، وما يجري مجرها لأن فاعلها معلوم معروف بالفطرة المغروسة في الناس، فهم مقرون بها وإن كذبتها ألسنة المعاندين.
المقصد الثالث عشر: أنه يأتي بما يحتمل التأويل، وسيأتي مبحث التأويل مفصلا في كلام الناظم.
المقصد الرابع عشر: أنه يأتي بالعام الذي أريد به الخصوص، وهذا يقصد به أن القرآن يأتي فيه اللفظ العام يقصد به المعنى بالخاص، والفرق بين هذا وبين العام المخصوص أن العام المخصوص يقصد فيه العموم ولكن تستثنى بعض أفراده عن طريق التخصيص، وأما العام الذي يراد به الخصوص فالمقصود فيه ابتداءً هو المعنى الخاص، وهناك فرق آخر وهو أن العام الذي أريد به الخصوص غالبا ما يفهم من سياق الكلام أو الدلالات العقلية المقترنة به أن العموم غير مقصود، ومن أمثلته قوله تعالى {أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما} فقد حكى المفسرون أن المقصود بالناس هنا النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، وهم بلا شك جزء من الناس، فهو عام أريد به الخاص.
وهنا فائدة وهي أن العام الذي أريد به الخصوص الفائدة فيه بلاغية في المقام الأول، وأما العام المخصوص فالفائدة الأساسية فيه تشريعية.
المقصد الخامس عشر: أن يأتي باللفظ الخاص يراد به العموم، وهذا عكس السابق، يقول الطوفي رحمه الله: (واعلم أن كلام العرب يجئ بالإضافة إلى العموم والخصوص على أربعة أقسام: أحدها: عام يراد به العام نحو {والله بكل شيء عليم}، وثانيها: خاص يراد به الخاص نحو {فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها}، وثالثها: عام يراد به الخاص نحو {وأوتيت من كل شيء ولها} و {تدمر كل شيء بأمر ربها} وقول لبيد: وكل نعيم لا محالة زائل، ورابعها: خاص يراد به العام نحو {فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما} خص التأفيف بالنهي عنه، والمراد النهي عن جميع أنواع أذاهما. فاعرف هذه القاعدة فإنه لا يخرج عنها شيء من الكلام) انتهى،
وقد يبدو للناظر في قسمة الطوفي أن القياس من الخاص الذي يراد به العموم إلا أن ابن رشد ينازع في ذلك فيذكر أن الفرق بين القياس الشرعي واللفظ الخاص الذي يراد به العام: أن القياس يكون على الخاص الذي أريد به الخاص، فيلحق به غيره، بمعنى أن المسكوت عنه يلحق بالمنطوق به من جهة الشبه، لا من جهة اللفظ، لأن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من جهة تنبيه اللفظ ليس بقياس، وإنما هو من باب دلالة اللفظ، ثم قال (وهذان الصنفان يتقاربان جدا، لأنهما إلحاق مسكوت عنه بمنطوق به، وهما يلتبسان على الفقهاء كثيرا جدا) انتهى.
ثم يختم ابن عاصم رحمه الله كلامه بالتأكيد على أن القرآن على نهج اللسان العربي، ثم يعقب ببيت هو من أبياته السيارة فيقول: (ومن يَرم فهم كلام الله*بغيره اعتَدَّ بأصلٍ واهِ) رحم الله ابن عاصم وجزاه عنا خير الجزاء، وبالله التوفيق.
والسَّوْقِ للمعلوم كالمجهول*لنكتة و اللَّحْظِ للتأويلِ.
والقصدِ للتخصيص في التعميم*وعكسِه وقس على المرسوم.
فهْو على نهج لسان العَرَبِ*فاسلك به سبيل ذاك تُصب.
ومن يَرم فهم كلام الله*بغيره اعتَدَّ بأصلٍ واهِ.
يستكمل الناظم في هذه الأبيات بقية مقاصد العربية التي اشتمل عليها القرآن:
المقصد الثاني عشر: أنه يساق فيه المعلوم مساق المجهول لفائدة: وهذا كثير في القرآن ومنه قوله تعالى {قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم} فهذا -على تقدير أنهم يعرفون ابراهيم- من سوق المعلوم مساق المجهول يلمحون إلى تحقير شأنه كما ذكر ابن عاشور، ومنه قوله تعالى: { فلما أتاها نُودي يا موسى} ذكر ابن عاشور أن الفعل (نودي) بني للمجهول مع أن المنادي معروف من كلامه الآتي لأجل تشويق السامع وجذب انتباهه، ومنها الآيات التي سيقت فيها الأفعال التي لا تكون إلا لله مساق المجهول كقوله {حُرمت عليكم}، {أُحِل لكم}، {قِيل يا أرض}، وما يجري مجرها لأن فاعلها معلوم معروف بالفطرة المغروسة في الناس، فهم مقرون بها وإن كذبتها ألسنة المعاندين.
المقصد الثالث عشر: أنه يأتي بما يحتمل التأويل، وسيأتي مبحث التأويل مفصلا في كلام الناظم.
المقصد الرابع عشر: أنه يأتي بالعام الذي أريد به الخصوص، وهذا يقصد به أن القرآن يأتي فيه اللفظ العام يقصد به المعنى بالخاص، والفرق بين هذا وبين العام المخصوص أن العام المخصوص يقصد فيه العموم ولكن تستثنى بعض أفراده عن طريق التخصيص، وأما العام الذي يراد به الخصوص فالمقصود فيه ابتداءً هو المعنى الخاص، وهناك فرق آخر وهو أن العام الذي أريد به الخصوص غالبا ما يفهم من سياق الكلام أو الدلالات العقلية المقترنة به أن العموم غير مقصود، ومن أمثلته قوله تعالى {أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما} فقد حكى المفسرون أن المقصود بالناس هنا النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، وهم بلا شك جزء من الناس، فهو عام أريد به الخاص.
وهنا فائدة وهي أن العام الذي أريد به الخصوص الفائدة فيه بلاغية في المقام الأول، وأما العام المخصوص فالفائدة الأساسية فيه تشريعية.
المقصد الخامس عشر: أن يأتي باللفظ الخاص يراد به العموم، وهذا عكس السابق، يقول الطوفي رحمه الله: (واعلم أن كلام العرب يجئ بالإضافة إلى العموم والخصوص على أربعة أقسام: أحدها: عام يراد به العام نحو {والله بكل شيء عليم}، وثانيها: خاص يراد به الخاص نحو {فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها}، وثالثها: عام يراد به الخاص نحو {وأوتيت من كل شيء ولها} و {تدمر كل شيء بأمر ربها} وقول لبيد: وكل نعيم لا محالة زائل، ورابعها: خاص يراد به العام نحو {فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما} خص التأفيف بالنهي عنه، والمراد النهي عن جميع أنواع أذاهما. فاعرف هذه القاعدة فإنه لا يخرج عنها شيء من الكلام) انتهى،
وقد يبدو للناظر في قسمة الطوفي أن القياس من الخاص الذي يراد به العموم إلا أن ابن رشد ينازع في ذلك فيذكر أن الفرق بين القياس الشرعي واللفظ الخاص الذي يراد به العام: أن القياس يكون على الخاص الذي أريد به الخاص، فيلحق به غيره، بمعنى أن المسكوت عنه يلحق بالمنطوق به من جهة الشبه، لا من جهة اللفظ، لأن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من جهة تنبيه اللفظ ليس بقياس، وإنما هو من باب دلالة اللفظ، ثم قال (وهذان الصنفان يتقاربان جدا، لأنهما إلحاق مسكوت عنه بمنطوق به، وهما يلتبسان على الفقهاء كثيرا جدا) انتهى.
ثم يختم ابن عاصم رحمه الله كلامه بالتأكيد على أن القرآن على نهج اللسان العربي، ثم يعقب ببيت هو من أبياته السيارة فيقول: (ومن يَرم فهم كلام الله*بغيره اعتَدَّ بأصلٍ واهِ) رحم الله ابن عاصم وجزاه عنا خير الجزاء، وبالله التوفيق.
قال ابن عاصم:
ونقلُه تواترا إلينا*بالخط ......
يشير الناظم هنا إلى أن القرآن نقل إلينا مكتوبا نقلا متواترا جيلا بعد جيل، وهذا حق لا ريب فيه في المصحف المكتوب، إذا كان المقصود بالتواتر من جهة الوقوع كما يفهم من كلام الناظم، ولكن هل يشترط في قبول القرآن حصول التواتر؟
الظاهر أن التواتر ليس شرطا كما يذكره أكثر الأصوليين؛ فإن اشتراط التواتر في جميع الأزمان لثبوت الحقائق طريقة منطقية لم تشترطها الشريعة في شيء من أحكامها، بل قد ثبت في النقل الصحيح أن بعض القرآن لم ينقل إلينا متواترا كما روى البخاري من حديث زيد بن ثابت أنه لم يجد آيتين من سورة التوبة إلا مع أبي خزيمة الأنصاري، ولم يجد آية الأحزاب إلا مع خزيمة بن ثابت، وقد حاول كثير من المصنفين تأويل هذه الأخبار بطرق شتى، ومعتمدهم في هذا التأويل هو أن التواتر شرط في قبول القرآن، فهم جعلوا المستدل عليه دليلا، ومما يؤكد هذا أن زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو الذي كلف بجمع القرآن لم يشترط التواتر، بل إن أبا بكر قال لعمر ولزيد: (اقعدا على باب المسجد فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه) [وثق رجاله ابن حجر]، وعدم التواتر لا يعنى أن القرآن لم يحفظ أو قد ضاع منه شيء كما يتوهم كثير من المعاصرين، بل كاد بعضهم أن يجعل نفي تواتر القرآن من المخرجات من الملة، وهذا كله سببه اتباع الطرق المنطقية في اثبات الحقائق، وهذا خطأ؛ فلم يتعبدنا الله عز وجل في شيء من الإيمان بإتباع التسلسل المنطقي.
وهنا فائدة: وهي أن الطرق المنطقية وإن كانت تستلذها العقول إلا أنها لا تحدث اليقين في النفوس ولا يقبلها الناس قبول اقتناع وتسليم دائما، وإنما يؤمن الإنسان ويصدق بما يطابق فطرته، ويطابق ما نشأ عليه وغرس في نفسه، ولذلك تجد بعض أصحاب العقول الكبار يؤمن ويصدق بالخرافات، وما ذلك لنقص في عقله، وإنما لأن هذا الشيء غرس في نفسه واكتسبه من قومه وأهله، ولذلك أيضا تجد أن بعض المتكلمين في آخر أمرهم عادوا إلى دين العجائز وما ذلك لصواب دين العجائز؛ وإنما لأنهم تربّوا في بيوت تلك العجائز، ومما يؤكد هذا المعنى ويزيده وضوحا أنك تجد المناظرات التي تساق فيها الحجج والدلائل العقلية ينفضّ المتناظرون عنها بنفس عقائدهم التي دخلوا بها، ثم انظر أيضا للقرآن الذي يخالط شغف القلوب، وينسف ما فيها من شك وخرافه، ويغرس فيها الإيمان الذي يفدى بالأرواح، فإنك لا تجد في الأعم الغالب منه حجج منطقية، وطرائق إقناع عقلية، وإنما تجده يخاطب الفطرة المغروسة في الإنسان، ويخاطب حواسه، انظر إلى قوله تعالى { قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين (10) قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون } انظر لهذا الكلام فإنك لا تجد فيه ترتيبا على الطريقة المنطقية فلا مقدمات ولا نتائج ولا إلزامات ولا دليل الحدوث ولا دليل التمانع ولا تواتر الأخبار وإنما هو صدع بالحق ومخاطبة للفطرة، ونتيجته في إدخال الإيمان إلى القلوب أعظم بأضعاف مضاعفة من نتائج الطرق المنطقية،
ثم إن الطرق المنطقية تفترض وجود مقدمات تنتج عنها نتائج عبر ترتيب منطقي، وقد يحدث أن المقدمات في خارج الذهن تنتج النتائج ولكنها لا تنتجها دائما بالطريقة المنطقية، لأن الحياة الواقعية مقدماتها ليست محصورة كمقدمات الأذهان، والروابط فيها بين النتائج والمقدمات ليست روابط منطقية كالروابط الحاصلة في الأذهان، وهذا الشيء يدركه الناس من حيث لا يشعرون، ولذلك تجد أنهم لا يؤمنون ولا ينقادون ولا يجزمون بالحجج المنطقية في كل الأحوال، وإن كانوا يستخدمونها لتبرير ما يفعلونه، ويستخدمونها للانتصار على خصومهم،
ومن هذا يتضح لك أن اشتراط التواتر ونحوه من التراتيب المنطقية في قبول القرآن أو في سائر الأمور الشرعية أو حتى الأمور التاريخية الصرفة ما هو إلا زخرف من القول اغتر به من اغتر بالطرق المنطقية، فامتياز القرآن عن غيره من الكلام كامتياز ضوء الشمس عن ضوء الشموع، لا يحتاج لإثباته إلى طرق منطقية ولا مقدمات عقلية ولا مناظرات ولا شروط ولا قيود، وإنما هو الحق الذي يخالط الأرواح كما يخالط الماء الماء، وبالله التوفيق.
ونقلُه تواترا إلينا*بالخط ......
يشير الناظم هنا إلى أن القرآن نقل إلينا مكتوبا نقلا متواترا جيلا بعد جيل، وهذا حق لا ريب فيه في المصحف المكتوب، إذا كان المقصود بالتواتر من جهة الوقوع كما يفهم من كلام الناظم، ولكن هل يشترط في قبول القرآن حصول التواتر؟
الظاهر أن التواتر ليس شرطا كما يذكره أكثر الأصوليين؛ فإن اشتراط التواتر في جميع الأزمان لثبوت الحقائق طريقة منطقية لم تشترطها الشريعة في شيء من أحكامها، بل قد ثبت في النقل الصحيح أن بعض القرآن لم ينقل إلينا متواترا كما روى البخاري من حديث زيد بن ثابت أنه لم يجد آيتين من سورة التوبة إلا مع أبي خزيمة الأنصاري، ولم يجد آية الأحزاب إلا مع خزيمة بن ثابت، وقد حاول كثير من المصنفين تأويل هذه الأخبار بطرق شتى، ومعتمدهم في هذا التأويل هو أن التواتر شرط في قبول القرآن، فهم جعلوا المستدل عليه دليلا، ومما يؤكد هذا أن زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو الذي كلف بجمع القرآن لم يشترط التواتر، بل إن أبا بكر قال لعمر ولزيد: (اقعدا على باب المسجد فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه) [وثق رجاله ابن حجر]، وعدم التواتر لا يعنى أن القرآن لم يحفظ أو قد ضاع منه شيء كما يتوهم كثير من المعاصرين، بل كاد بعضهم أن يجعل نفي تواتر القرآن من المخرجات من الملة، وهذا كله سببه اتباع الطرق المنطقية في اثبات الحقائق، وهذا خطأ؛ فلم يتعبدنا الله عز وجل في شيء من الإيمان بإتباع التسلسل المنطقي.
وهنا فائدة: وهي أن الطرق المنطقية وإن كانت تستلذها العقول إلا أنها لا تحدث اليقين في النفوس ولا يقبلها الناس قبول اقتناع وتسليم دائما، وإنما يؤمن الإنسان ويصدق بما يطابق فطرته، ويطابق ما نشأ عليه وغرس في نفسه، ولذلك تجد بعض أصحاب العقول الكبار يؤمن ويصدق بالخرافات، وما ذلك لنقص في عقله، وإنما لأن هذا الشيء غرس في نفسه واكتسبه من قومه وأهله، ولذلك أيضا تجد أن بعض المتكلمين في آخر أمرهم عادوا إلى دين العجائز وما ذلك لصواب دين العجائز؛ وإنما لأنهم تربّوا في بيوت تلك العجائز، ومما يؤكد هذا المعنى ويزيده وضوحا أنك تجد المناظرات التي تساق فيها الحجج والدلائل العقلية ينفضّ المتناظرون عنها بنفس عقائدهم التي دخلوا بها، ثم انظر أيضا للقرآن الذي يخالط شغف القلوب، وينسف ما فيها من شك وخرافه، ويغرس فيها الإيمان الذي يفدى بالأرواح، فإنك لا تجد في الأعم الغالب منه حجج منطقية، وطرائق إقناع عقلية، وإنما تجده يخاطب الفطرة المغروسة في الإنسان، ويخاطب حواسه، انظر إلى قوله تعالى { قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين (10) قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون } انظر لهذا الكلام فإنك لا تجد فيه ترتيبا على الطريقة المنطقية فلا مقدمات ولا نتائج ولا إلزامات ولا دليل الحدوث ولا دليل التمانع ولا تواتر الأخبار وإنما هو صدع بالحق ومخاطبة للفطرة، ونتيجته في إدخال الإيمان إلى القلوب أعظم بأضعاف مضاعفة من نتائج الطرق المنطقية،
ثم إن الطرق المنطقية تفترض وجود مقدمات تنتج عنها نتائج عبر ترتيب منطقي، وقد يحدث أن المقدمات في خارج الذهن تنتج النتائج ولكنها لا تنتجها دائما بالطريقة المنطقية، لأن الحياة الواقعية مقدماتها ليست محصورة كمقدمات الأذهان، والروابط فيها بين النتائج والمقدمات ليست روابط منطقية كالروابط الحاصلة في الأذهان، وهذا الشيء يدركه الناس من حيث لا يشعرون، ولذلك تجد أنهم لا يؤمنون ولا ينقادون ولا يجزمون بالحجج المنطقية في كل الأحوال، وإن كانوا يستخدمونها لتبرير ما يفعلونه، ويستخدمونها للانتصار على خصومهم،
ومن هذا يتضح لك أن اشتراط التواتر ونحوه من التراتيب المنطقية في قبول القرآن أو في سائر الأمور الشرعية أو حتى الأمور التاريخية الصرفة ما هو إلا زخرف من القول اغتر به من اغتر بالطرق المنطقية، فامتياز القرآن عن غيره من الكلام كامتياز ضوء الشمس عن ضوء الشموع، لا يحتاج لإثباته إلى طرق منطقية ولا مقدمات عقلية ولا مناظرات ولا شروط ولا قيود، وإنما هو الحق الذي يخالط الأرواح كما يخالط الماء الماء، وبالله التوفيق.
قال ابن عاصم:
..........*...واستعمالُه لدينا.
بِمَقْرَإِ المدينة المشهورِ*وما يضاهيه من المأثور.
وصحةُ النقل بوفق المصحف*واللغةِ الشرطُ بكل الأحرف.
يتحدث الناظم في هذه الأبيات أن المعتمد قراءة أهل المدينة وما يضاهيها من القراءات المأثورة، ثم يخبر عن شروط القراءة المقبولة، وفي كلامه تقديم وتأخير؛ وتقدير الكلام: (الشرط بكل الأحرف صحة النقل بوفق المصحف واللغة)، ولنفصل ما أجمل فيما يلي من فِقر:
الأولى: القراءات -وإن شئت قل الروايات المأثورة أو الأحرف كما عبر الناظم- هي طرق ووجوه لفظ آيات القرآن، فإن نسبت هذه الطريقة إلى قارئ فهي رواية، والحرف يستعمل أحيانا مرادف للرواية فيقال هذا حرف قرأ به فلان، كما يقال أيضا هذه قراءة فلان، فهي متقاربة في الاستعمال، وإن كان بعضها أخص من بعض في بعض الاستعمالات.
الثانية: أن الناظم ذكر أن المستعمل في مذهب مالك هو مقرأ المدينة، ومقرأ المدينة قراءة نافع، وكان فقهاء المدينة وأولهم مالك بن أنس يصفون قراءة نافع بأنها سنة، وهذا منقول عن أحمد وعن عدد من أئمة السلف، ونافع كما -يقول الذهبي- هو نافع بن عبد الرحمن ابن أبي نعيم المدني، كان أسود اللون حالكا أصله من أصبهان، وكان يقول: (قرأت على سبعين من التابعين)، وأقرأ الناس دهرا طويلا، وهو من طبقة أتباع التابعين، ومات رحمه الله سنة تسع وستين ومائة.
الثالثة: أن قراءة نافع تضاهيها في الصحة قراءات مأثورة كثيرة، سبعٌ منها سماها ابن مجاهد مما انتهت إليها القراءة في الأمصار الإسلامية الكبار، ففي المدينة قراءة نافع، وفي مكة قراءة عبد الله بن كثير، في الكوفة قراءة عاصِم بن أبي النجُود، وقراءة حَمْزَة بن حبيب الزيات، وقراءة علي بن حمزة الكسائي، وفي البصرة قراءة أبي عمْرو بن العَلاء، وفي الشام قراءة عبد الله بن عامر اليحصبِي، والقراءات المروية كثيرة أهمل منها كثير، وصح منها كثير، وليست الصحيحة مقتصرة على السبعة، وإنما هم أئمة القراء، كما أن الائمة الأربعة أئمة الفقه، وإن كانت مذاهب الفقه ليست محصورة فيهم، وهذا ما جعل العلماء يضعون شروطا للقراءة المقبولة، ولو كانت محصورة في السبع أو العشر لما كان لوضع الشروط معنى، يقول ابن الجزري: (وأما إطلاق من لا يعلم على ما لم يكن عن السبعة القراء، أو ما لم يكن في هذه الكتب المشهورة كالشاطبية والتيسير أنه شاذ، فإنه اصطلاح ممن لا يعرف حقيقة ما يقول)انتهى، وهو يقصد بذلك بعض المتكلمين، وقد صرح به جماعة منهم تجد أقوالهم منقولة في كتب الأصول.
الرابعة: شروط القراءة المقبولة -كما عددها الناظم- ثلاثة:
الشرط الأول: صحة النقل؛ ويشرح هذا الشرط ابن الجزري في كتابه النشر بقوله: (وقولنا <وصح سندها> فإنا نعني به أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله كذا حتى تنتهي، وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين له غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شذ بها بعضهم، وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن ولم يكتف فيه بصحة السند، وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وأن ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت به قرآن، وهذا ما لا يخفى ما فيه، فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من الرسم وغيره إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواترا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وجب قبوله وقطع بكونه قرآنا، سواء وافق الرسم أم خالفه وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم وقد كنت قبل أجنح إلى هذا القول، ثم ظهر فساده وموافقة أئمة السلف والخلف) انتهى، وهذا يؤكد ما ذكرته لك سابقا من أن اشتراط التواتر طريقة كلامية منطقية لا شرعية.
الشرط الثاني: موافقتها لخط المصحف، وليس المقصود به مصحف بعينه وإنما المقصود به المصاحف التي فرقها عثمان في الأمصار، ولذلك عدل ابن الجزري رحمه الله في الشرط فذكر أن الشرط موافقة أحد المصاحف، ثم قال: (ونعني بموافقة أحد المصاحف ما كان ثابتا في بعضها دون بعض كقراءة ابن عامر (قالوا اتخذ الله ولدا) في البقرة بغير واو، وبالزبر وبالكتاب المنير بزيادة الباء في الاسمين [ال عمران] ونحو ذلك، فإن ذلك ثابت في المصحف الشامي، وكقراءة ابن كثير جنات تجري من تحتها الأنهار في الموضع الأخير من سورة براءة بزيادة (من) ، فإن ذلك ثابت في المصحف المكي، وكذلك فإن الله هو الغني الحميد في سورة الحديد بحذف (هو) ، وكذا (سارعوا) بحذف الواو، وكذا (منهما منقلبا) بالتثنية في الكهف، إلى غير ذلك من مواضع كثيرة في القرآن اختلفت المصاحف فيها فوردت القراءة عن أئمة تلك الأمصار على موافقة مصحفهم، فلو لم يكن ذلك كذلك في شيء من المصاحف العثمانية لكانت القراءة بذلك شاذة لمخالفتها الرسم المجمع عليه) انتهى، والاختلاف بين خطوط المصاحف العثمانية ذكره العلماء فيما كتبوه من كتب في القراءات والرسم ونحوه.
..........*...واستعمالُه لدينا.
بِمَقْرَإِ المدينة المشهورِ*وما يضاهيه من المأثور.
وصحةُ النقل بوفق المصحف*واللغةِ الشرطُ بكل الأحرف.
يتحدث الناظم في هذه الأبيات أن المعتمد قراءة أهل المدينة وما يضاهيها من القراءات المأثورة، ثم يخبر عن شروط القراءة المقبولة، وفي كلامه تقديم وتأخير؛ وتقدير الكلام: (الشرط بكل الأحرف صحة النقل بوفق المصحف واللغة)، ولنفصل ما أجمل فيما يلي من فِقر:
الأولى: القراءات -وإن شئت قل الروايات المأثورة أو الأحرف كما عبر الناظم- هي طرق ووجوه لفظ آيات القرآن، فإن نسبت هذه الطريقة إلى قارئ فهي رواية، والحرف يستعمل أحيانا مرادف للرواية فيقال هذا حرف قرأ به فلان، كما يقال أيضا هذه قراءة فلان، فهي متقاربة في الاستعمال، وإن كان بعضها أخص من بعض في بعض الاستعمالات.
الثانية: أن الناظم ذكر أن المستعمل في مذهب مالك هو مقرأ المدينة، ومقرأ المدينة قراءة نافع، وكان فقهاء المدينة وأولهم مالك بن أنس يصفون قراءة نافع بأنها سنة، وهذا منقول عن أحمد وعن عدد من أئمة السلف، ونافع كما -يقول الذهبي- هو نافع بن عبد الرحمن ابن أبي نعيم المدني، كان أسود اللون حالكا أصله من أصبهان، وكان يقول: (قرأت على سبعين من التابعين)، وأقرأ الناس دهرا طويلا، وهو من طبقة أتباع التابعين، ومات رحمه الله سنة تسع وستين ومائة.
الثالثة: أن قراءة نافع تضاهيها في الصحة قراءات مأثورة كثيرة، سبعٌ منها سماها ابن مجاهد مما انتهت إليها القراءة في الأمصار الإسلامية الكبار، ففي المدينة قراءة نافع، وفي مكة قراءة عبد الله بن كثير، في الكوفة قراءة عاصِم بن أبي النجُود، وقراءة حَمْزَة بن حبيب الزيات، وقراءة علي بن حمزة الكسائي، وفي البصرة قراءة أبي عمْرو بن العَلاء، وفي الشام قراءة عبد الله بن عامر اليحصبِي، والقراءات المروية كثيرة أهمل منها كثير، وصح منها كثير، وليست الصحيحة مقتصرة على السبعة، وإنما هم أئمة القراء، كما أن الائمة الأربعة أئمة الفقه، وإن كانت مذاهب الفقه ليست محصورة فيهم، وهذا ما جعل العلماء يضعون شروطا للقراءة المقبولة، ولو كانت محصورة في السبع أو العشر لما كان لوضع الشروط معنى، يقول ابن الجزري: (وأما إطلاق من لا يعلم على ما لم يكن عن السبعة القراء، أو ما لم يكن في هذه الكتب المشهورة كالشاطبية والتيسير أنه شاذ، فإنه اصطلاح ممن لا يعرف حقيقة ما يقول)انتهى، وهو يقصد بذلك بعض المتكلمين، وقد صرح به جماعة منهم تجد أقوالهم منقولة في كتب الأصول.
الرابعة: شروط القراءة المقبولة -كما عددها الناظم- ثلاثة:
الشرط الأول: صحة النقل؛ ويشرح هذا الشرط ابن الجزري في كتابه النشر بقوله: (وقولنا <وصح سندها> فإنا نعني به أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله كذا حتى تنتهي، وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين له غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شذ بها بعضهم، وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن ولم يكتف فيه بصحة السند، وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وأن ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت به قرآن، وهذا ما لا يخفى ما فيه، فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من الرسم وغيره إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواترا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وجب قبوله وقطع بكونه قرآنا، سواء وافق الرسم أم خالفه وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم وقد كنت قبل أجنح إلى هذا القول، ثم ظهر فساده وموافقة أئمة السلف والخلف) انتهى، وهذا يؤكد ما ذكرته لك سابقا من أن اشتراط التواتر طريقة كلامية منطقية لا شرعية.
الشرط الثاني: موافقتها لخط المصحف، وليس المقصود به مصحف بعينه وإنما المقصود به المصاحف التي فرقها عثمان في الأمصار، ولذلك عدل ابن الجزري رحمه الله في الشرط فذكر أن الشرط موافقة أحد المصاحف، ثم قال: (ونعني بموافقة أحد المصاحف ما كان ثابتا في بعضها دون بعض كقراءة ابن عامر (قالوا اتخذ الله ولدا) في البقرة بغير واو، وبالزبر وبالكتاب المنير بزيادة الباء في الاسمين [ال عمران] ونحو ذلك، فإن ذلك ثابت في المصحف الشامي، وكقراءة ابن كثير جنات تجري من تحتها الأنهار في الموضع الأخير من سورة براءة بزيادة (من) ، فإن ذلك ثابت في المصحف المكي، وكذلك فإن الله هو الغني الحميد في سورة الحديد بحذف (هو) ، وكذا (سارعوا) بحذف الواو، وكذا (منهما منقلبا) بالتثنية في الكهف، إلى غير ذلك من مواضع كثيرة في القرآن اختلفت المصاحف فيها فوردت القراءة عن أئمة تلك الأمصار على موافقة مصحفهم، فلو لم يكن ذلك كذلك في شيء من المصاحف العثمانية لكانت القراءة بذلك شاذة لمخالفتها الرسم المجمع عليه) انتهى، والاختلاف بين خطوط المصاحف العثمانية ذكره العلماء فيما كتبوه من كتب في القراءات والرسم ونحوه.
الشرط الثالث: موافقة اللغة، هكذا اشترط الناظم وهو رأي الأعم الأغلب من أهل الأصول والعربية، إلا أن علماء القراءة لم يأخذوه بإطلاق فقد حاول ابن الجزري أن يخفف هذا الشرط فقال موافقة العربية لو بوجه، والداني صرح بأن الرواية إذا ثبتت لا يردّها قياس عربية ولا فشوّ لغة، ويعلل الشيخ غانم قدوري الحمد ذلك بقوله: (لأن القواعد التي وضعها النحاة جاءت لاحقة، ووضعت لغرض تعليمي يستند إلى الظواهر المطردة ولا يعنى كثيرا بالظواهر المنفردة، والقراءات مهما كان موقف النحويين منها فإنها أكثر تعبيرا عن واقع العربية في فترة ظهور الإسلام، من حيث الأصوات والمفردات والتراكيب) انتهى. وبالله التوفيق.
قال ابن عاصم:
وذاك مقطوع على مُغَيَّبهْ*وتُقْتَضى الأحكام مِن تَطَلُّبِه.
وانعقد الإجماع أن الجاحدا*له من الكفار قولا واحدا.
ذكر الناظم في هذين البيتين ثلاث مسائل تترتب على قبول القراءة - التي توفرت فيها الشروط السابقة- : الأولى عقدية، والثانية أصولية، والثالثة فقهية:
المسألة الأولى: أن ما تضمنته القراءة المقبولة من غيبيات مقطوع به، لأنها من القرآن، والقرآن أخبرنا الله عز وجل عن آياته أنها الحق، فقال: {تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين}، وأخبرنا أنه أنزله بالحق: {ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد}، وقال جل وعلا عما حكى فيه من قصص الأمم السالفة: {إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم} وقال: {واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين}، فهو الكتاب المنزل بالحق، من عند الحق جل وعلا، وكل ما فيه حق، وما كان كذلك فهو مقطوع على مغيبة كما قال الناظم.
المسألة الثانية: أنه يعمل بما تضمنته من أمر ونهي، لأن الله أمرنا باتباع ما في القرآن، وهي منه فقال: { كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين (2) اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون}، وقال: {فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون}، ومفهوم الصفة هنا يقتضى بأن من لم يتبع النور الذي أنزل معه أنه ليس بمفلح، وقال: {واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون}، وهذا وعيد والوعيد لا يكون في شيء مخير.
المسألة الثالثة: أن من حجد كونها من القرآن فهو كافر بالإجماع، نقله ابن حزم، والنووي، وابن جزي، والشوكاني،
قال ابن حزم في مراتب الإجماع: (اتفقوا أن من زاد فيه حرفًا من غير القراءات المروية المحفوظة المنقولة نقل الكافة، أو نقص منه حرفًا، أو بدل منه حرفًا مكان حرف، وقد قامت عليه الحجة، أنه من القرآن، فتمادى متعمدًا لكل ذلك، عالمًا بأنه بخلاف ما فعل، فإنه كافر) انتهى، ومستند ذلك الإجماع أن الله أخبرنا في كتابه أن الذكر محفوظ، فمن حجد ما ثبت منه وهو متعمد وأُخبِر بغلطه وبُين له سبب غلطه وفهمه واستمر في جحوده فهو مكذب لخبر الله جل وعلا الذي جاء به الرسول الذي أمرنا بالإيمان بما جاء به، وهذا هو الكفر.
*فائدة:
الحكم بالكفر يكون حكما فقهيا، ويكون حكما قضائيا:
الفقهي هو ما يذكر في الكتب والفتاوى، ويحكم به المفتي المجتهد، وهذا الحكم لا يوصف به شخص بعينه؛ فيقال فلان كافر، وإنما يعلق بالأوصاف؛ فيقال من فعل كذا فهو كافر،
وأما القضائي فهو ما يحكم به القاضي على الشخص المعين، وهو الذي يذكر في مسائل حد المرتد وفي كتب القضاء، ولا يحكم به القاضي إلا بعد أن يعرضه على المتهم به، فيسأله عنه فإن أقر به تأكد من أهليته، فإن كان مكلفا تأكد من علمه بأن ما اقترفه كفر، فأن كان يعلم سأله عن سبب فعله، فإن لم يكن له تأويل صحيح علمه وبين له فساد تأويله، فإن فهم وأصر على تأويله استتابه، فإن أصر حكم بكفره ودفعه إلى الحاكم لينفذ حد الرده به، وهذا فرق مهم والجهل به سبب كثير من الفتن، وبالله التوفيق.
وذاك مقطوع على مُغَيَّبهْ*وتُقْتَضى الأحكام مِن تَطَلُّبِه.
وانعقد الإجماع أن الجاحدا*له من الكفار قولا واحدا.
ذكر الناظم في هذين البيتين ثلاث مسائل تترتب على قبول القراءة - التي توفرت فيها الشروط السابقة- : الأولى عقدية، والثانية أصولية، والثالثة فقهية:
المسألة الأولى: أن ما تضمنته القراءة المقبولة من غيبيات مقطوع به، لأنها من القرآن، والقرآن أخبرنا الله عز وجل عن آياته أنها الحق، فقال: {تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين}، وأخبرنا أنه أنزله بالحق: {ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد}، وقال جل وعلا عما حكى فيه من قصص الأمم السالفة: {إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم} وقال: {واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين}، فهو الكتاب المنزل بالحق، من عند الحق جل وعلا، وكل ما فيه حق، وما كان كذلك فهو مقطوع على مغيبة كما قال الناظم.
المسألة الثانية: أنه يعمل بما تضمنته من أمر ونهي، لأن الله أمرنا باتباع ما في القرآن، وهي منه فقال: { كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين (2) اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون}، وقال: {فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون}، ومفهوم الصفة هنا يقتضى بأن من لم يتبع النور الذي أنزل معه أنه ليس بمفلح، وقال: {واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون}، وهذا وعيد والوعيد لا يكون في شيء مخير.
المسألة الثالثة: أن من حجد كونها من القرآن فهو كافر بالإجماع، نقله ابن حزم، والنووي، وابن جزي، والشوكاني،
قال ابن حزم في مراتب الإجماع: (اتفقوا أن من زاد فيه حرفًا من غير القراءات المروية المحفوظة المنقولة نقل الكافة، أو نقص منه حرفًا، أو بدل منه حرفًا مكان حرف، وقد قامت عليه الحجة، أنه من القرآن، فتمادى متعمدًا لكل ذلك، عالمًا بأنه بخلاف ما فعل، فإنه كافر) انتهى، ومستند ذلك الإجماع أن الله أخبرنا في كتابه أن الذكر محفوظ، فمن حجد ما ثبت منه وهو متعمد وأُخبِر بغلطه وبُين له سبب غلطه وفهمه واستمر في جحوده فهو مكذب لخبر الله جل وعلا الذي جاء به الرسول الذي أمرنا بالإيمان بما جاء به، وهذا هو الكفر.
*فائدة:
الحكم بالكفر يكون حكما فقهيا، ويكون حكما قضائيا:
الفقهي هو ما يذكر في الكتب والفتاوى، ويحكم به المفتي المجتهد، وهذا الحكم لا يوصف به شخص بعينه؛ فيقال فلان كافر، وإنما يعلق بالأوصاف؛ فيقال من فعل كذا فهو كافر،
وأما القضائي فهو ما يحكم به القاضي على الشخص المعين، وهو الذي يذكر في مسائل حد المرتد وفي كتب القضاء، ولا يحكم به القاضي إلا بعد أن يعرضه على المتهم به، فيسأله عنه فإن أقر به تأكد من أهليته، فإن كان مكلفا تأكد من علمه بأن ما اقترفه كفر، فأن كان يعلم سأله عن سبب فعله، فإن لم يكن له تأويل صحيح علمه وبين له فساد تأويله، فإن فهم وأصر على تأويله استتابه، فإن أصر حكم بكفره ودفعه إلى الحاكم لينفذ حد الرده به، وهذا فرق مهم والجهل به سبب كثير من الفتن، وبالله التوفيق.
قال ابن عاصم:
وغيرُه ينسب للشذوذ*والحكم منه ليس بالمأخوذ.
ولا يجوز بعدُ أن يُقرأَ بهْ*وليس مقطوعا على مُغَيَّبه.
ولم يُكَفَّر عندهم من قد وقعْ*منه له جحد وبئس ما صنع.
في هذه الأبيات ذكر الناظم أحكام القراءة الشاذة، فأشار أولا إلى تعريفها، ثم أتبعه بذكر مسائل أربع تتعلق بالقراءة الشاذة، مسألة أصولية، ومسألة عقدية، ومسألتان فقهيتان، وسأذكرها لك على ترتيب الناظم رحمه الله:
أولا: القراءة الشاذة:
يشير الناظم بقوله: (وغيرها) إلى أنها تقابل القراءة المقبولة، وعلى هذا تكون القراءة الشاذة عنده ما اختل فيها أحد الشروط الثلاثة التي ذكرها سابقا وهي: صحة السند، وموافقة خط المصحف، وموافقة اللغة، واختلفت مذاهب الأصوليين في حد القراءة الشاذة اختلافا كبيرا سببه تأثير الطرق الكلامية فيما يفيد القطع، وسيأتي ذكرها لاحقا عند استدراك الناظم في البيت التالي إن شاء الله.
ثانيا: حكم القراءة بالشاذ من القراءات:
وهذه المسألة تحكى فيها أقوالا شتى من العسير الجزم بصحة نسبتها لأصحابها، لأن الخلاف في تحديد القراءة الشاذة فيما بين الأصوليين أنفسهم وفيما بينهم وبين القراء كبير، واستصحب كل فريق منهم رأيه الى الفروع الفقهية، ولكن إذا جعلنا الشاذ هو ما خالف رسم المصحف مما صح سنده فالجمهور على منع القراءة به، ونقل ابن عبد البر رحمه الله إجماعا أغلبيا على طريقته في الإجماع فقال: (وقد قال مالك من قرأ في صلاته بقراءة ابن مسعود أو غيره من الصحابة مما يخالف المصحف لم يصل وراءه، وعلماء المسلمين مجمعون على ذلك إلا قوم شذوا لا يعرج عليهم منهم الأعمش سليمان بن مهران) انتهى، والأعمش هو الذي قال عنه سفيان بن عيينة: (كان الأعمش أقرأهم لكتاب الله،وأحفظهم للحديث، وأعلمهم بالفرائض)، وقال عنه يحيى القطان: (هو علامة الإسلام)، وهو شيخ حمزة الزيات أحد السبعة، وقد نقل ابن عبد البر رحمه الله أيضا عن مالك أنه لا يرى بأسا بقراءة ابن مسعود التي تخالف الرسم العثماني، إلا أنه عقب عليه بقوله: (معناه عندي أن يقرأ به في غير الصلاة)، وهكذا قد نُقِل عن أحمد روايتين، فنقل عنه المروذي أنه قال: (قراءة العامة أعجب إلي، وإن قرأ بقراءة ابن مسعود لا أقول يعيد)، وقال أبو داود السجستاني صاحب السنن: (سمعت أحمد يقول: اقرأ ما في المصحف)، وليس المقصود استيفاء المذاهب والاستدلال فإن محل ذلك الفقه وإنما المقصود الإشارة إلى أن المسألة اجتهادية، وليست محل إجماع كما يذكر كثير من المتكلمين ومن أحسن الظن بهم من الفقهاء، بل تجاوز الأمر ببعض مقلدة المذاهب من المتأخرين إلى القول بتعزير من قرأ بما لم يتواتر -ولو وافق رسم المصحف- بالسجن والضرب، ولا أدري هل سيضربون مالك وأحمد أم سيضربون الأعمش سليمان بن مهران، فلله الأمر من قبل ومن بعد.
ثالثا: أخذ الأحكام من القراءة الشاذة:
يقطع الناظم رحمه الله بأن الأحكام لا تؤخذ من القراءة الشاذة، وهذا مطرد مع القول بمنع القراءة بها، وهذه المسألة هي أم الباب -كما يقال- وهي سبب ذكر القراءة الشاذة وأحكامها في علم الأصول، وفيها نزاع كبير بين الأصوليين، فذهب جمهور الفقهاء وبعض الأصوليين إلى القول بحجيتها إذا صح سندها، وذهب فريق آخر إلى القول بعدم حجيتها، ودليل من قال بأنها حجة أنها قراءة صح سندها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يثبت نسخها، وذهب فريق آخر إلى القول بعدم حجيتها، ودليلهم أن الصحابة لم يكتبوها في المصحف، ولو كانت من القرآن لكتبت فيه، وهي ليست من السنة لأن الصحابي نقلها على أنها قرآن، وليست من رأي الصحابي لأن الصحابي لا يتصور منه أن يدرج رأيه في كلام رب العالمين، وليست إجماعا ولا قياسا، لأنها نقلت على أنها قرآن، فهذه هي أصول الشريعة ولا يمكن رد هذه القراءة إلى شيء منها، وقد حاول بعض الأصوليين تكييفها على بعض الأصول فقالوا بأنها خبر آحاد يعمل بها، وهذا في غاية الإشكال لأن خبر الواحد عندهم إما أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون من كلام الصحابي، وهم لا يعدونها من حديث النبي ولا يعدونها من قول الصحابي، وأحيانا يقولون إنها مما نسخ لفظه وبقي حكمه، ودعوى النسخ تحتاج إلى دليل، وأحيانا يقولون هي من القرآن عملا لا علما، والعمل لا يثبت إلا بعلم يستند إليه، ولكن إذا نظرت في كلام المتقدمين من الفقهاء والمفسرين تجد أنهم يحتجون بها، كاحتجاجهم بقراءة {وعلى الذين يطوقونه}، وآية الصلاة الوسطى، وقراءة {صيام ثلاثة أيام متتابعات}، و، قراءة {فطلقوهن لقبل عدتهن}وغيرها كثير، والظن أنها من المسائل التي ترجع إلى ما يسميه ابن قدامه رحمه الله الذوق الفقهي والله أعلم بالصواب.
رابعا: أنه لا يقطع بما تضمنته من غيبيات، وهذا مبني على ما تقدم من الاحتجاج بها، لأن اعتقاد ما تضمنته من إيمان نوع من العمل بها والاحتجاج بها.
وغيرُه ينسب للشذوذ*والحكم منه ليس بالمأخوذ.
ولا يجوز بعدُ أن يُقرأَ بهْ*وليس مقطوعا على مُغَيَّبه.
ولم يُكَفَّر عندهم من قد وقعْ*منه له جحد وبئس ما صنع.
في هذه الأبيات ذكر الناظم أحكام القراءة الشاذة، فأشار أولا إلى تعريفها، ثم أتبعه بذكر مسائل أربع تتعلق بالقراءة الشاذة، مسألة أصولية، ومسألة عقدية، ومسألتان فقهيتان، وسأذكرها لك على ترتيب الناظم رحمه الله:
أولا: القراءة الشاذة:
يشير الناظم بقوله: (وغيرها) إلى أنها تقابل القراءة المقبولة، وعلى هذا تكون القراءة الشاذة عنده ما اختل فيها أحد الشروط الثلاثة التي ذكرها سابقا وهي: صحة السند، وموافقة خط المصحف، وموافقة اللغة، واختلفت مذاهب الأصوليين في حد القراءة الشاذة اختلافا كبيرا سببه تأثير الطرق الكلامية فيما يفيد القطع، وسيأتي ذكرها لاحقا عند استدراك الناظم في البيت التالي إن شاء الله.
ثانيا: حكم القراءة بالشاذ من القراءات:
وهذه المسألة تحكى فيها أقوالا شتى من العسير الجزم بصحة نسبتها لأصحابها، لأن الخلاف في تحديد القراءة الشاذة فيما بين الأصوليين أنفسهم وفيما بينهم وبين القراء كبير، واستصحب كل فريق منهم رأيه الى الفروع الفقهية، ولكن إذا جعلنا الشاذ هو ما خالف رسم المصحف مما صح سنده فالجمهور على منع القراءة به، ونقل ابن عبد البر رحمه الله إجماعا أغلبيا على طريقته في الإجماع فقال: (وقد قال مالك من قرأ في صلاته بقراءة ابن مسعود أو غيره من الصحابة مما يخالف المصحف لم يصل وراءه، وعلماء المسلمين مجمعون على ذلك إلا قوم شذوا لا يعرج عليهم منهم الأعمش سليمان بن مهران) انتهى، والأعمش هو الذي قال عنه سفيان بن عيينة: (كان الأعمش أقرأهم لكتاب الله،وأحفظهم للحديث، وأعلمهم بالفرائض)، وقال عنه يحيى القطان: (هو علامة الإسلام)، وهو شيخ حمزة الزيات أحد السبعة، وقد نقل ابن عبد البر رحمه الله أيضا عن مالك أنه لا يرى بأسا بقراءة ابن مسعود التي تخالف الرسم العثماني، إلا أنه عقب عليه بقوله: (معناه عندي أن يقرأ به في غير الصلاة)، وهكذا قد نُقِل عن أحمد روايتين، فنقل عنه المروذي أنه قال: (قراءة العامة أعجب إلي، وإن قرأ بقراءة ابن مسعود لا أقول يعيد)، وقال أبو داود السجستاني صاحب السنن: (سمعت أحمد يقول: اقرأ ما في المصحف)، وليس المقصود استيفاء المذاهب والاستدلال فإن محل ذلك الفقه وإنما المقصود الإشارة إلى أن المسألة اجتهادية، وليست محل إجماع كما يذكر كثير من المتكلمين ومن أحسن الظن بهم من الفقهاء، بل تجاوز الأمر ببعض مقلدة المذاهب من المتأخرين إلى القول بتعزير من قرأ بما لم يتواتر -ولو وافق رسم المصحف- بالسجن والضرب، ولا أدري هل سيضربون مالك وأحمد أم سيضربون الأعمش سليمان بن مهران، فلله الأمر من قبل ومن بعد.
ثالثا: أخذ الأحكام من القراءة الشاذة:
يقطع الناظم رحمه الله بأن الأحكام لا تؤخذ من القراءة الشاذة، وهذا مطرد مع القول بمنع القراءة بها، وهذه المسألة هي أم الباب -كما يقال- وهي سبب ذكر القراءة الشاذة وأحكامها في علم الأصول، وفيها نزاع كبير بين الأصوليين، فذهب جمهور الفقهاء وبعض الأصوليين إلى القول بحجيتها إذا صح سندها، وذهب فريق آخر إلى القول بعدم حجيتها، ودليل من قال بأنها حجة أنها قراءة صح سندها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يثبت نسخها، وذهب فريق آخر إلى القول بعدم حجيتها، ودليلهم أن الصحابة لم يكتبوها في المصحف، ولو كانت من القرآن لكتبت فيه، وهي ليست من السنة لأن الصحابي نقلها على أنها قرآن، وليست من رأي الصحابي لأن الصحابي لا يتصور منه أن يدرج رأيه في كلام رب العالمين، وليست إجماعا ولا قياسا، لأنها نقلت على أنها قرآن، فهذه هي أصول الشريعة ولا يمكن رد هذه القراءة إلى شيء منها، وقد حاول بعض الأصوليين تكييفها على بعض الأصول فقالوا بأنها خبر آحاد يعمل بها، وهذا في غاية الإشكال لأن خبر الواحد عندهم إما أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون من كلام الصحابي، وهم لا يعدونها من حديث النبي ولا يعدونها من قول الصحابي، وأحيانا يقولون إنها مما نسخ لفظه وبقي حكمه، ودعوى النسخ تحتاج إلى دليل، وأحيانا يقولون هي من القرآن عملا لا علما، والعمل لا يثبت إلا بعلم يستند إليه، ولكن إذا نظرت في كلام المتقدمين من الفقهاء والمفسرين تجد أنهم يحتجون بها، كاحتجاجهم بقراءة {وعلى الذين يطوقونه}، وآية الصلاة الوسطى، وقراءة {صيام ثلاثة أيام متتابعات}، و، قراءة {فطلقوهن لقبل عدتهن}وغيرها كثير، والظن أنها من المسائل التي ترجع إلى ما يسميه ابن قدامه رحمه الله الذوق الفقهي والله أعلم بالصواب.
رابعا: أنه لا يقطع بما تضمنته من غيبيات، وهذا مبني على ما تقدم من الاحتجاج بها، لأن اعتقاد ما تضمنته من إيمان نوع من العمل بها والاحتجاج بها.
خامسا: أن من حجد كونها من القرآن لا يكفر، لأن ثبوت القراءة من المسائل التي قد تخفى، وهذا مما يعذر فيه بالجهل كسائر المسائل الخفية، ولكن صنعه هذا مذموم لأنه أقدم على نفي ما لم يعلم، وسيأتي مثل هذا أيضا في من حجد شيء من الإجماع إن شاء الله.
سادسا: ضمن الناظم في قوله: (وبئس ما صنع) عبارة مكي بن أبي طالب الإمام الأندلسي، أستاذ القراء، المولود بقرطبة سنة ٣٥٥ للهجرة، وهذا نص عبارته من كتاب الإبانة: (والعلة الثانية: أنه مخالف لما قد أجمع عليه، فلا يقطع على مغيبه وصحته، وما لم يقطع على صحته لا تجوز القراءة به، ولا يكفر من جحده، وبئس ما صنع إذ جحده)، ولعل ابن عاصم رحمه الله أراد أن يشير إلى أنه لم يتبع مذاهب المتكلمين في هذه المسألة، وقد صرح بذلك في البيت التالي، فرحم الله ابن عاصم، وجزاه عنا خير الجزاء، وبالله التوفيق.
سادسا: ضمن الناظم في قوله: (وبئس ما صنع) عبارة مكي بن أبي طالب الإمام الأندلسي، أستاذ القراء، المولود بقرطبة سنة ٣٥٥ للهجرة، وهذا نص عبارته من كتاب الإبانة: (والعلة الثانية: أنه مخالف لما قد أجمع عليه، فلا يقطع على مغيبه وصحته، وما لم يقطع على صحته لا تجوز القراءة به، ولا يكفر من جحده، وبئس ما صنع إذ جحده)، ولعل ابن عاصم رحمه الله أراد أن يشير إلى أنه لم يتبع مذاهب المتكلمين في هذه المسألة، وقد صرح بذلك في البيت التالي، فرحم الله ابن عاصم، وجزاه عنا خير الجزاء، وبالله التوفيق.
قال ابن عاصم:
ومذهب القُرّا بهذي المسأله*أقعد في الأمر كذا في البسمله.
وذو الأصول حظُّه الأخذ لما*منه استمدّ عِلمه مسلِّما.
والحق أن لا يُكْذب الرواة*في نقلهم لأنهم ثقات.
وهْو لدى النعمان في عداد*ما قد أتى في خبر الآحاد.
ومالك ظاهرٌ اعتداده*به لأنْ صح به استشهاده.
في هذه الأبيات ينتقد ابن عاصم مذاهب الأصوليين في مسائل القراءة، ويقدم مذهب القراء عليهم، ويخبر أن الحق أن لا يكذب الرواة الثقات، ثم يخبر أن النعمان وهو المكنى بأبي حنيفة الإمام المشهور ومالك يعتدون به، وأن منزلته عند أبي حنيفة منزلة ما صح من الأخبار، وقد تقدم ذلك في مسألة الاحتجاج بالقراءة الشاذة، و إليك مقدمات توضح السبب الذي جعل الناظم ينتقد مذاهب الأصوليين في القراءة الشاذة.
*المقدمة الأولى:
يقسم المناطقة المدارك إلى تصورات وتصديقات، والتصورات هي إدراك المعاني المفردة كمعنى الجمل ومعنى طويل، والتصديقات هي إدراك نسبة المعاني المفردة إلى بعضها وإن شئت قل الحكم على المعاني المفردة، كالجمل طويل، والتصورات تحصل بالحد وهو التعريف كتعريف الجمل بأنه الحيوان ذو الخف والسنام، والتصديقات تثبت بأمور منها البرهان وهو القياس المنطقي الذي يرتب المقدمات على النتائج، وهذا البرهان يكون قطعيا إذا كانت مقدماته يقينية، واليقينيات التي يقوم عليها البرهان القطعي عندهم ست: البدهيات وهي ما يعرف بمجرد تصوره، والباطنيات كالجوع والعطش، والتجريبيات وهي ما يعرف من تكرر العادة التي لا تنخرم كإحراق النار، والمتواترات وهي الأخبار التي ينقلها جماعات يستحيل تواطؤهم على الكذب، والحدسيات وهي ما يدرك بالحدس وتؤكده القرائن، والمحسوسات وهي ما تدرك بالحواس الخمس، ومن هذه المقدمة تعرف مكانة التواتر عند المناطقة وأنه نوع من أنواع اليقينيات التي يقوم عليها القياس المنطقي الذي هو لب المنطق الأرسطي.
*المقدمة الثانية:
مكانة المنطق عظيمة عند المتكلمين حتى أنهم جعلوا معرفته شرط من شروط الإجتهاد، يقول محمد بن عمر الرازي رحمه الله في المحصول: (فإن قال قائل فصلوا العلوم التي يحتاج المجتهد إليها قلنا قال الغزالي رحمه الله مدارك الأحكام أربعة الكتاب والسنة والإجماع والعقل فلا بد من العلم بهذه الأربعة ولا بد معها من أربعة أخرى اثنان مقدمان واثنان مؤخران فهذه ثمانية لا بد من شرحها) ثم قال: (وأما العلمان المقدمان فأحدهما علم شرائط الحد والبرهان على الإطلاق وثانيهما معرفة النحو واللغة والتصريف)انتهى، وعلم شرائط الحد والبرهان هو المنطق، ويقول أبو حامد الغزالي رحمه الله عن مقدمته المنطقية: (وليست هذه المقدمة من جملة علم الأصول ولا من مقدماته الخاصة به، بل هي مقدمة العلوم كلها، ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه أصلا)انتهى، وينقل ابن السبكي عن أبيه قوله عن علم المنطق: (وهو من أحسن العلوم وأنفعها في كل بحث)انتهى، فهؤلاء الثلاثة هم من قامت على كتبهم المدرسة الكلامية في الأصول، فلأبي حامد المستصفى، وللرازي المحصول، ولابن السبكي جمع الجوامع، فإذا كانت هذه هي منزلة المنطق عندهم فلا تستبعد أن يجعلوه أساسا لما كتبوه في الأصول.
*المقدمة الثالثة:
*يقول أبو حامد رحمه الله في المستصفى: (فإن قيل: فلم شرطتم التواتر؟ قلنا: ليحصل العلم به؛ لأن الحكم بما لا يعلم جهل، وكون الشيء كلام الله تعالى أمر حقيقي ليس بوضعي حتى يتعلق بظننا فيقال إذا ظننتم كذا فقد حرمنا عليكم فعلا أو حللناه لكم)انتهى، وهذا صريح في أن أصل اشتراط التواتر في قبول القرآن استمد من المنطق ولم يستمد من أصول الشريعة، لأنه جعل العلم -الذي هو القطع- لا يكون في النقل إلا بتواتر المنقول، وقد علمنا في المقدمة الأولى أن التواتر أحد اليقينيات الست التي يبنى عليها البرهان٠
*النتيجة:
علمنا مما تقدم في المقدمة الأولى أن التواتر نظرية منطقية، وعلمنا من المقدمة الثانية ولع المتكلمين بالمنطق، وعلمنا من المقدمة الثالثة سبب اشتراط التواتر لقبول القرآن، فإذا تبين لك هذا كله سيتضح لك أن مبنى المسألة كلها منطقي لا شرعي، وسيتضح لك سبب ترجيح الناظم لمذهب القراء وسبب نقده لأقوال الأصوليين.
*التواتر شرط في جميع المنقول:
يطرد بعض متكلمة الأصول اشتراط التواتر في قبول الأدلة النقلية كافة، فيشترطون التواتر لقبول القرآن، وقبول السنة، وقبول الإجماع، فالتواتر في المنقولات عندهم نظرية عامة يؤسسون عليها مدرستهم في الأصول، وسيأتي بإذن الله ما يؤكد ذلك في مسألة هل تشترط القطعية في قبول الأخبار، وهل يشترط حصول التواتر للعمل بالإجماع.
*مسألة البسملة:
أعتُرض على المتكلمين بمسألة هل البسملة من القرآن؟ لأن دخولها في كل أول سورة ليس قطعيا ولا متواترا، فذهب جماعة منهم إلى نفي كونها من القرآن في غير سورة النمل خروجا من هذا الإشكال، إلا أنهم لما وجدوا أن من أئمة الإسلام من جعلها آية في أول سورة قالوا بأن من جعلها آية في أول كل سورة لا يكفر، ولذلك أشار الناظم هنا إلى البسملة وأن مذاهب القراء فيها أقعد.
ومذهب القُرّا بهذي المسأله*أقعد في الأمر كذا في البسمله.
وذو الأصول حظُّه الأخذ لما*منه استمدّ عِلمه مسلِّما.
والحق أن لا يُكْذب الرواة*في نقلهم لأنهم ثقات.
وهْو لدى النعمان في عداد*ما قد أتى في خبر الآحاد.
ومالك ظاهرٌ اعتداده*به لأنْ صح به استشهاده.
في هذه الأبيات ينتقد ابن عاصم مذاهب الأصوليين في مسائل القراءة، ويقدم مذهب القراء عليهم، ويخبر أن الحق أن لا يكذب الرواة الثقات، ثم يخبر أن النعمان وهو المكنى بأبي حنيفة الإمام المشهور ومالك يعتدون به، وأن منزلته عند أبي حنيفة منزلة ما صح من الأخبار، وقد تقدم ذلك في مسألة الاحتجاج بالقراءة الشاذة، و إليك مقدمات توضح السبب الذي جعل الناظم ينتقد مذاهب الأصوليين في القراءة الشاذة.
*المقدمة الأولى:
يقسم المناطقة المدارك إلى تصورات وتصديقات، والتصورات هي إدراك المعاني المفردة كمعنى الجمل ومعنى طويل، والتصديقات هي إدراك نسبة المعاني المفردة إلى بعضها وإن شئت قل الحكم على المعاني المفردة، كالجمل طويل، والتصورات تحصل بالحد وهو التعريف كتعريف الجمل بأنه الحيوان ذو الخف والسنام، والتصديقات تثبت بأمور منها البرهان وهو القياس المنطقي الذي يرتب المقدمات على النتائج، وهذا البرهان يكون قطعيا إذا كانت مقدماته يقينية، واليقينيات التي يقوم عليها البرهان القطعي عندهم ست: البدهيات وهي ما يعرف بمجرد تصوره، والباطنيات كالجوع والعطش، والتجريبيات وهي ما يعرف من تكرر العادة التي لا تنخرم كإحراق النار، والمتواترات وهي الأخبار التي ينقلها جماعات يستحيل تواطؤهم على الكذب، والحدسيات وهي ما يدرك بالحدس وتؤكده القرائن، والمحسوسات وهي ما تدرك بالحواس الخمس، ومن هذه المقدمة تعرف مكانة التواتر عند المناطقة وأنه نوع من أنواع اليقينيات التي يقوم عليها القياس المنطقي الذي هو لب المنطق الأرسطي.
*المقدمة الثانية:
مكانة المنطق عظيمة عند المتكلمين حتى أنهم جعلوا معرفته شرط من شروط الإجتهاد، يقول محمد بن عمر الرازي رحمه الله في المحصول: (فإن قال قائل فصلوا العلوم التي يحتاج المجتهد إليها قلنا قال الغزالي رحمه الله مدارك الأحكام أربعة الكتاب والسنة والإجماع والعقل فلا بد من العلم بهذه الأربعة ولا بد معها من أربعة أخرى اثنان مقدمان واثنان مؤخران فهذه ثمانية لا بد من شرحها) ثم قال: (وأما العلمان المقدمان فأحدهما علم شرائط الحد والبرهان على الإطلاق وثانيهما معرفة النحو واللغة والتصريف)انتهى، وعلم شرائط الحد والبرهان هو المنطق، ويقول أبو حامد الغزالي رحمه الله عن مقدمته المنطقية: (وليست هذه المقدمة من جملة علم الأصول ولا من مقدماته الخاصة به، بل هي مقدمة العلوم كلها، ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه أصلا)انتهى، وينقل ابن السبكي عن أبيه قوله عن علم المنطق: (وهو من أحسن العلوم وأنفعها في كل بحث)انتهى، فهؤلاء الثلاثة هم من قامت على كتبهم المدرسة الكلامية في الأصول، فلأبي حامد المستصفى، وللرازي المحصول، ولابن السبكي جمع الجوامع، فإذا كانت هذه هي منزلة المنطق عندهم فلا تستبعد أن يجعلوه أساسا لما كتبوه في الأصول.
*المقدمة الثالثة:
*يقول أبو حامد رحمه الله في المستصفى: (فإن قيل: فلم شرطتم التواتر؟ قلنا: ليحصل العلم به؛ لأن الحكم بما لا يعلم جهل، وكون الشيء كلام الله تعالى أمر حقيقي ليس بوضعي حتى يتعلق بظننا فيقال إذا ظننتم كذا فقد حرمنا عليكم فعلا أو حللناه لكم)انتهى، وهذا صريح في أن أصل اشتراط التواتر في قبول القرآن استمد من المنطق ولم يستمد من أصول الشريعة، لأنه جعل العلم -الذي هو القطع- لا يكون في النقل إلا بتواتر المنقول، وقد علمنا في المقدمة الأولى أن التواتر أحد اليقينيات الست التي يبنى عليها البرهان٠
*النتيجة:
علمنا مما تقدم في المقدمة الأولى أن التواتر نظرية منطقية، وعلمنا من المقدمة الثانية ولع المتكلمين بالمنطق، وعلمنا من المقدمة الثالثة سبب اشتراط التواتر لقبول القرآن، فإذا تبين لك هذا كله سيتضح لك أن مبنى المسألة كلها منطقي لا شرعي، وسيتضح لك سبب ترجيح الناظم لمذهب القراء وسبب نقده لأقوال الأصوليين.
*التواتر شرط في جميع المنقول:
يطرد بعض متكلمة الأصول اشتراط التواتر في قبول الأدلة النقلية كافة، فيشترطون التواتر لقبول القرآن، وقبول السنة، وقبول الإجماع، فالتواتر في المنقولات عندهم نظرية عامة يؤسسون عليها مدرستهم في الأصول، وسيأتي بإذن الله ما يؤكد ذلك في مسألة هل تشترط القطعية في قبول الأخبار، وهل يشترط حصول التواتر للعمل بالإجماع.
*مسألة البسملة:
أعتُرض على المتكلمين بمسألة هل البسملة من القرآن؟ لأن دخولها في كل أول سورة ليس قطعيا ولا متواترا، فذهب جماعة منهم إلى نفي كونها من القرآن في غير سورة النمل خروجا من هذا الإشكال، إلا أنهم لما وجدوا أن من أئمة الإسلام من جعلها آية في أول سورة قالوا بأن من جعلها آية في أول كل سورة لا يكفر، ولذلك أشار الناظم هنا إلى البسملة وأن مذاهب القراء فيها أقعد.
قال ابن عاصم:
(فصل في المحكم والمتشابه).
في هذا الفصل يتحدث الناظم عن المحكم والمتشابه، وهو بحث أصولي أصيل؛ لأن المتشابه لا يعمل به ولا تستنبط منه الأحكام الشرعية، وإنما تستنبط من المحكم، وهو من المسائل التي كثر النزاع فيها بين المفسرين واللغويين، كما كثر النزاع فيها بين الفرق الإسلامية، فكل يجعل قوله هو المحكم وقول خصمه هو المتشابه، فالقدرية يجعلون آيات القدر من المتشابه وآيات إثبات المشيئة للعباد من المحكم، وعكسهم في ذلك الجبرية، وهكذا الوعيدية يجعلون آيات الوعيد هي المحكم وآيات الرجاء من المتشابه، وعكسهم في ذلك المرجئة، ومثلهم معطلة الصفات يجعلون آيات التنزية هي المحكم وآيات الصفات من المتشابه، وعكسهم في ذلك المشبهة، وكثر ذكر هذا الأخير في مصنفات المتكلمين الأصولية، وصرحوا بعدّ آيات الصفات من المتشابه، وجعلوها كالحروف المقطعة لا يعلم معناها، وما ذاك إلا لشيوع التعطيل بين المتكلمين، والنزاع الحاصل في هذا البحث ليس في أصل قسمة المحكم والمتشابه وإنما في تعيين المحكم من القرآن وتعيين المتشابه منه، وفي معنى تأويل المتشابه وعلم الراسخين به.
واعلم أن للتشابه والإحكام في القرآن معاني متعددة، فقد جاء وصف القرآن كله بأنه محكم، وجاء وصفه كله بأنه متشابه، وجاء وصفه بأن منه محكم ومتشابه، والبحث هنا إنما هو في المعنى الأخير، وأما المعنى الأول الذي جاء في قوله تعالى: { الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير}، فإن المقصود بالإحكام هنا هو الإتقان، وأما المعنى الثاني وهو الذي جاء في قوله: { الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني} فإن المقصود بالتشابه هنا أنه يشبه بعضه بعضا، ويصدق بعضه بعضا، كما قال تعالى: {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا}، وسيفصل ابن عاصم في هذا البحث تفصيلا حسنا كعادته رحمه الله، يأتي الكلام عليه إن شاء الله، وبالله التوفيق.
(فصل في المحكم والمتشابه).
في هذا الفصل يتحدث الناظم عن المحكم والمتشابه، وهو بحث أصولي أصيل؛ لأن المتشابه لا يعمل به ولا تستنبط منه الأحكام الشرعية، وإنما تستنبط من المحكم، وهو من المسائل التي كثر النزاع فيها بين المفسرين واللغويين، كما كثر النزاع فيها بين الفرق الإسلامية، فكل يجعل قوله هو المحكم وقول خصمه هو المتشابه، فالقدرية يجعلون آيات القدر من المتشابه وآيات إثبات المشيئة للعباد من المحكم، وعكسهم في ذلك الجبرية، وهكذا الوعيدية يجعلون آيات الوعيد هي المحكم وآيات الرجاء من المتشابه، وعكسهم في ذلك المرجئة، ومثلهم معطلة الصفات يجعلون آيات التنزية هي المحكم وآيات الصفات من المتشابه، وعكسهم في ذلك المشبهة، وكثر ذكر هذا الأخير في مصنفات المتكلمين الأصولية، وصرحوا بعدّ آيات الصفات من المتشابه، وجعلوها كالحروف المقطعة لا يعلم معناها، وما ذاك إلا لشيوع التعطيل بين المتكلمين، والنزاع الحاصل في هذا البحث ليس في أصل قسمة المحكم والمتشابه وإنما في تعيين المحكم من القرآن وتعيين المتشابه منه، وفي معنى تأويل المتشابه وعلم الراسخين به.
واعلم أن للتشابه والإحكام في القرآن معاني متعددة، فقد جاء وصف القرآن كله بأنه محكم، وجاء وصفه كله بأنه متشابه، وجاء وصفه بأن منه محكم ومتشابه، والبحث هنا إنما هو في المعنى الأخير، وأما المعنى الأول الذي جاء في قوله تعالى: { الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير}، فإن المقصود بالإحكام هنا هو الإتقان، وأما المعنى الثاني وهو الذي جاء في قوله: { الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني} فإن المقصود بالتشابه هنا أنه يشبه بعضه بعضا، ويصدق بعضه بعضا، كما قال تعالى: {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا}، وسيفصل ابن عاصم في هذا البحث تفصيلا حسنا كعادته رحمه الله، يأتي الكلام عليه إن شاء الله، وبالله التوفيق.
قال ابن عاصم:
متضحات الآي محكمات*قسيمهن المتشابهات.
من حيث لا يُعلم مقتضاها*فيما أتت به كمثل طه.
أو لظهور صفة اشتباه*..............
في هذه الأبيات يذكر الناظم انقسام الآي إلى محكم ومتشابه،
ويعرف المحكم بأنه الواضح،
ويذكر أن المتشابه هو قسيم المحكم، فيكون معنى المتشابه عنده أنه غير الواضح، ثم يتابع الناظم أبا إسحاق الشاطبي فيذكر أن للمتشابه الواقع في الشريعة مرتبتان:
المرتبة الأولى: الذي لا سبيل إلى معرفة معناه، ويمثل له بالحروف المقطعة التي تستفتح به بعض السور كحرف الطاء والهاء المذكورة في قوله تعالى {طه}، وأصل هذه المرتبة ما ورد في سبب نزول قوله تعالى: {فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه} من أنها نزلت في اليهود الذين حاولوا معرفة مدة بقاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم من حساب الحروف المقطعة.
المرتبة الثانية: الذي تعرض له صفة من صفات الإشتباه العارضة للألفاظ كالإجمال، والإشتراك، والغرابة الواردة في بعض غريب القرآن والسنة، وكالإطلاق في موضع والتقييد في آخر، والتعميم في موضع والتخصيص في آخر، وقد سمى الناظم هذه المرتبة في الأبيات التالية (تشابه الإجمال)، وأصل هذا النوع ما جاء في تفسير ابن عباس رضي الله عنه للمتشابه بأنه (المنسوخ والمقدم والمؤخر)؛ فإن المنسوخ عند السلف جار على معناه اللغوي؛ وهو معنى يشمل العام المخصوص، والمطلق الذي قيد، والمجمل الذي بين في موضع آخر، كما أن هذه المرتبة تجري أيضا على سبب النزول الآخر المروي في الآية من أنها نزلت في نصارى نجران لما جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم في عيسى وأنه ابن الله -تعالى الله عما يقولون- وأنهم احتجوا بقوله تعالى: {وروح منه}، وهذه المرتبة يسميها جمع من أهل العلم بالمتشابه الإضافي أو النسبي، ويذكرون أنها تفارق النوع الأول في إمكان معرفة معناها بالاجتهاد في النظر والبحث.
تنبيه:
معنى الاشتباه يتضح بمعرفة أمرين:
الأول: معرفة التأويل المقصود في الآية؛ لأن المتشابه هو الذي لا يعلم تأويله إلا الله كما سيرجح الناظم ذلك في البيت التالي، والتأويل يرد في استعمال الشرع إما بمعنى التفسير، أو بمعنى التنزيل وكيفية الوقوع، وهذا الأخير هو الأكثر استعمالا في القرآن -كما في أضواء البيان- وعلى المعنى الأول يكون معنى المتشابه هو الذي لا يُعرف معناه، وعلى الثاني يكون المتشابه هو الذي لا يعلم كيفية وقوعه إلا الله وإن كان معناه واضحا، وهذا المعنى الأخير هو الذي يناسب الوقف على قوله تعالى {إلا الله}، وهو الذي يرجح أن الواو استئنافية لا عاطفه، ويناسب أن الراسخين في العلم من الصحابة والتابعين لم يتركوا لفظة في القرآن إلا سألوا عن تفسيرها وبحثوا فيه، ويناسب مدح الراسخين بالايمان به كما سيأتي الحديث عنه في الأبيات التالية.
الثاني: هل في القرآن ألفاظ لا تعرف معانيها ولم يتعرض لها الراسخون بالتفسير؟ والجواب عن هذا يتضح بتتبع الألفاظ التي وصفت بأنها لا تعرف معانيها،
وأولها الحروف المقطعه، فإنك إذا نظرت فيها ستجد أنها حروف مقطعة، والحروف لا تحمل المعاني إلا بالاتصال ببعضها كسائر ألفاظ العربية، أو الحذف بعد الاتصال كدلالة القاف المكسورة (قِ) على الأمر بالوقاية ونحوها، فيكون البحث ليس عن معنى الحروف المقطعة -لأنها لايمكن أن تحمل المعاني- بل البحث عن الحكمه من ذكرها في أوائل السور، والبحث عن هذه الحكمة لا يخلوا منها تفسير،
ومن الألفاظ التي وصفت بأنها لا تعرف معانيها صفات الله عز وجل التي وصف الله بها نفسه في كتابه، ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح من سنته، وهذا من عجائب ما انتهى إليه المتكلمة، فإن معنى الوجه واليد والمجيء والاستواء ونحوها من الصفات العلى معروفة في العربية، وقد فسرها الراسخون في العلم من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، وبينوا أنها تليق بالله عز وجل، وأنها لا تشابه صفات المخلوقين، تجد ذلك مسطور في دواوين السنة، وعلى رأسها كتاب التوحيد من صحيح البخاري، وتجدها في كتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد، والرد على الجهمية للدارمي صاحب السنن، والرد على الجهمية لخطيب أهل السنة الإمام ابن قتيبة، والرد على الجهمية لابن منده، وكتاب أحاديث الصفات للإمام الدارقطني، ومن قبلهم قد قال مالك: (الاستواء معلوم)، وما أحق هؤلاء المتكلمة بقول الفاروق عمر رضي الله عنه: (إن أصحاب الرأي أعداء السنن؛ أعيتهم أن يحفظوها، وتفلتت منهم أن يعوها، واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا: لا نعلم، فعارضوا السنن برأيهم فإياكم وإياهم)، وليتهم قالوا بالرأي وسكتوا، بل زعموا أن تحديث الناس بأحاديث النبي صلى الله عليه في الصفات لا يجوز، بل عزروا عليه بالضرب والحبس، وهي من العلم الذي جاء الوعيد على كتمانه، بل تمادى بعض مقلديهم فقرروا بأن من اعتقد بعض ظواهر القرآن والسنة كفر يعنون بذلك الصفات والقدر والتعليل، وقرروا بأن من أصول الكفر التمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير عرضها على البراهين العقلية
متضحات الآي محكمات*قسيمهن المتشابهات.
من حيث لا يُعلم مقتضاها*فيما أتت به كمثل طه.
أو لظهور صفة اشتباه*..............
في هذه الأبيات يذكر الناظم انقسام الآي إلى محكم ومتشابه،
ويعرف المحكم بأنه الواضح،
ويذكر أن المتشابه هو قسيم المحكم، فيكون معنى المتشابه عنده أنه غير الواضح، ثم يتابع الناظم أبا إسحاق الشاطبي فيذكر أن للمتشابه الواقع في الشريعة مرتبتان:
المرتبة الأولى: الذي لا سبيل إلى معرفة معناه، ويمثل له بالحروف المقطعة التي تستفتح به بعض السور كحرف الطاء والهاء المذكورة في قوله تعالى {طه}، وأصل هذه المرتبة ما ورد في سبب نزول قوله تعالى: {فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه} من أنها نزلت في اليهود الذين حاولوا معرفة مدة بقاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم من حساب الحروف المقطعة.
المرتبة الثانية: الذي تعرض له صفة من صفات الإشتباه العارضة للألفاظ كالإجمال، والإشتراك، والغرابة الواردة في بعض غريب القرآن والسنة، وكالإطلاق في موضع والتقييد في آخر، والتعميم في موضع والتخصيص في آخر، وقد سمى الناظم هذه المرتبة في الأبيات التالية (تشابه الإجمال)، وأصل هذا النوع ما جاء في تفسير ابن عباس رضي الله عنه للمتشابه بأنه (المنسوخ والمقدم والمؤخر)؛ فإن المنسوخ عند السلف جار على معناه اللغوي؛ وهو معنى يشمل العام المخصوص، والمطلق الذي قيد، والمجمل الذي بين في موضع آخر، كما أن هذه المرتبة تجري أيضا على سبب النزول الآخر المروي في الآية من أنها نزلت في نصارى نجران لما جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم في عيسى وأنه ابن الله -تعالى الله عما يقولون- وأنهم احتجوا بقوله تعالى: {وروح منه}، وهذه المرتبة يسميها جمع من أهل العلم بالمتشابه الإضافي أو النسبي، ويذكرون أنها تفارق النوع الأول في إمكان معرفة معناها بالاجتهاد في النظر والبحث.
تنبيه:
معنى الاشتباه يتضح بمعرفة أمرين:
الأول: معرفة التأويل المقصود في الآية؛ لأن المتشابه هو الذي لا يعلم تأويله إلا الله كما سيرجح الناظم ذلك في البيت التالي، والتأويل يرد في استعمال الشرع إما بمعنى التفسير، أو بمعنى التنزيل وكيفية الوقوع، وهذا الأخير هو الأكثر استعمالا في القرآن -كما في أضواء البيان- وعلى المعنى الأول يكون معنى المتشابه هو الذي لا يُعرف معناه، وعلى الثاني يكون المتشابه هو الذي لا يعلم كيفية وقوعه إلا الله وإن كان معناه واضحا، وهذا المعنى الأخير هو الذي يناسب الوقف على قوله تعالى {إلا الله}، وهو الذي يرجح أن الواو استئنافية لا عاطفه، ويناسب أن الراسخين في العلم من الصحابة والتابعين لم يتركوا لفظة في القرآن إلا سألوا عن تفسيرها وبحثوا فيه، ويناسب مدح الراسخين بالايمان به كما سيأتي الحديث عنه في الأبيات التالية.
الثاني: هل في القرآن ألفاظ لا تعرف معانيها ولم يتعرض لها الراسخون بالتفسير؟ والجواب عن هذا يتضح بتتبع الألفاظ التي وصفت بأنها لا تعرف معانيها،
وأولها الحروف المقطعه، فإنك إذا نظرت فيها ستجد أنها حروف مقطعة، والحروف لا تحمل المعاني إلا بالاتصال ببعضها كسائر ألفاظ العربية، أو الحذف بعد الاتصال كدلالة القاف المكسورة (قِ) على الأمر بالوقاية ونحوها، فيكون البحث ليس عن معنى الحروف المقطعة -لأنها لايمكن أن تحمل المعاني- بل البحث عن الحكمه من ذكرها في أوائل السور، والبحث عن هذه الحكمة لا يخلوا منها تفسير،
ومن الألفاظ التي وصفت بأنها لا تعرف معانيها صفات الله عز وجل التي وصف الله بها نفسه في كتابه، ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح من سنته، وهذا من عجائب ما انتهى إليه المتكلمة، فإن معنى الوجه واليد والمجيء والاستواء ونحوها من الصفات العلى معروفة في العربية، وقد فسرها الراسخون في العلم من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، وبينوا أنها تليق بالله عز وجل، وأنها لا تشابه صفات المخلوقين، تجد ذلك مسطور في دواوين السنة، وعلى رأسها كتاب التوحيد من صحيح البخاري، وتجدها في كتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد، والرد على الجهمية للدارمي صاحب السنن، والرد على الجهمية لخطيب أهل السنة الإمام ابن قتيبة، والرد على الجهمية لابن منده، وكتاب أحاديث الصفات للإمام الدارقطني، ومن قبلهم قد قال مالك: (الاستواء معلوم)، وما أحق هؤلاء المتكلمة بقول الفاروق عمر رضي الله عنه: (إن أصحاب الرأي أعداء السنن؛ أعيتهم أن يحفظوها، وتفلتت منهم أن يعوها، واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا: لا نعلم، فعارضوا السنن برأيهم فإياكم وإياهم)، وليتهم قالوا بالرأي وسكتوا، بل زعموا أن تحديث الناس بأحاديث النبي صلى الله عليه في الصفات لا يجوز، بل عزروا عليه بالضرب والحبس، وهي من العلم الذي جاء الوعيد على كتمانه، بل تمادى بعض مقلديهم فقرروا بأن من اعتقد بعض ظواهر القرآن والسنة كفر يعنون بذلك الصفات والقدر والتعليل، وقرروا بأن من أصول الكفر التمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير عرضها على البراهين العقلية
والقواطع الشرعية، فجعلوا ظاهر كتاب الله مشتبه، والقواعد الأرسطية هي المحكم، وأوجبوا رد الكتاب إلى البراهين الأرسطية، وقد ذكرت لك تلك البراهين عند قول ابن عاصم: (ومذهب القرا)، نسأل الله أن يوفقنا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
وسيأتي مزيد بيان للمحكم والمتشابه في أبيات ابن عاصم رحمه الله تعالى، وجزاه عنا خير الجزاء، وبالله التوفيق.
وسيأتي مزيد بيان للمحكم والمتشابه في أبيات ابن عاصم رحمه الله تعالى، وجزاه عنا خير الجزاء، وبالله التوفيق.
قال ابن عاصم:
.......................*والراجح الوقف على اسم الله.
ويقتضي ذاك مساقُ الآيه*من جهة التفصيل في البدايه.
والسبب الواقع للتنزيل*وهْو مراعىً لأولي التحصيل.
في هذه الأبيات يتحدث الناظم عن مسألةٍ طال اختلاف القراء والمفسرين والأصوليين واللغويين فيها، وهي مسألة الوقف في قوله تعالى: {هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب}، والمقصود بالوقف هنا هل يوقف على قوله تعالى: {وما يعلم تأويله إلا الله} فيكون علم المتشابه مما اختص الله به، وتكون الواو التي بعد الاسم الشريف استئنافية، أو يوقف على قوله تعالى: {وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم} فيكون علم المتشابه مما يحيط به الراسخون في العلم، وتكون الواو التي بعد الاسم الشريف عاطفة؟
للعلماء في هذه المسألة أقوال أشهرها: أن الوقف هو على الاسم الشريف، وأن الواو استئنافية، و{الراسخون} مبتدأ خبره {يقولون}، وهذا هو الذي رجحه ابن عاصم هنا، وساق عدد من القرائن ذكر أنها تقتضي هذا القول:
*الأولى: سياق الآية (من جهة التفصيل في البداية) كما ذكر الناظم؛ والتفصيل الذي في بداية الآية هو: قوله تعالى: {فأما} وما جاء بعدها من تفصيل مذاهب الناس بين السعي في تأويل المتشابه والتعرض للفتنة، وبين التسليم بالكتاب كله والإيمان بأنه كله من عند الله، فلما وصف الله عز وجل مبتغي تأويل المتشابه بأن في قلوبهم زيغ، وأنهم يسعون للفتنة، ولما أثنى على الراسخين بأنهم يؤمنون بالكتاب كله، ويقولون كل من عند ربنا، علمنا من هذا أنه كان لو العلم بالمتشابه ممكن لما ذم الله من طلب تأويله، وأثنى على سلم به وصدق، وهذا يقتضي أن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله وحده، وهذا يرجح صحة الوقف على الاسم الشريف.
*الثانية سبب نزول الآية: وقد روي في سبب نزول هذه الآيه روايتان: الأولى أنها نزلت في اليهود لما حاولوا معرفة مدة بقاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم من حساب الحروف المقطعة التي تستفتح به بعض السور، وهذه يرويها أصحاب السير، ورواها ابن جرير الطبري، وقد ضعفها ابن كثير في تفسيره لأول سورة البقرة.
الرواية الثانية: أنها نزلت في نصارى نجران وأنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ألست تزعم أنه كلمة الله، وروح منه؟ قال: «بلى». قالوا: فحسبنا. فأنزل الله هذه الآية، وهذه أخرجها ابن جرير في تفسيره بسند مرسل.
ووجه الاستدلال بهاذين السببين هو: أن الحكمة من وضع الحروف المقطعة في أوائل السور و كيفية كون عيسى روح من الله مما اختص الله بعلمه، وهذا يؤيد أن من القرآن متشابه لا يعلمه إلا الله، وهذا الأخير دليل على رجحان الوقف على الاسم الشريف، وبالله التوفيق.
.......................*والراجح الوقف على اسم الله.
ويقتضي ذاك مساقُ الآيه*من جهة التفصيل في البدايه.
والسبب الواقع للتنزيل*وهْو مراعىً لأولي التحصيل.
في هذه الأبيات يتحدث الناظم عن مسألةٍ طال اختلاف القراء والمفسرين والأصوليين واللغويين فيها، وهي مسألة الوقف في قوله تعالى: {هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب}، والمقصود بالوقف هنا هل يوقف على قوله تعالى: {وما يعلم تأويله إلا الله} فيكون علم المتشابه مما اختص الله به، وتكون الواو التي بعد الاسم الشريف استئنافية، أو يوقف على قوله تعالى: {وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم} فيكون علم المتشابه مما يحيط به الراسخون في العلم، وتكون الواو التي بعد الاسم الشريف عاطفة؟
للعلماء في هذه المسألة أقوال أشهرها: أن الوقف هو على الاسم الشريف، وأن الواو استئنافية، و{الراسخون} مبتدأ خبره {يقولون}، وهذا هو الذي رجحه ابن عاصم هنا، وساق عدد من القرائن ذكر أنها تقتضي هذا القول:
*الأولى: سياق الآية (من جهة التفصيل في البداية) كما ذكر الناظم؛ والتفصيل الذي في بداية الآية هو: قوله تعالى: {فأما} وما جاء بعدها من تفصيل مذاهب الناس بين السعي في تأويل المتشابه والتعرض للفتنة، وبين التسليم بالكتاب كله والإيمان بأنه كله من عند الله، فلما وصف الله عز وجل مبتغي تأويل المتشابه بأن في قلوبهم زيغ، وأنهم يسعون للفتنة، ولما أثنى على الراسخين بأنهم يؤمنون بالكتاب كله، ويقولون كل من عند ربنا، علمنا من هذا أنه كان لو العلم بالمتشابه ممكن لما ذم الله من طلب تأويله، وأثنى على سلم به وصدق، وهذا يقتضي أن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله وحده، وهذا يرجح صحة الوقف على الاسم الشريف.
*الثانية سبب نزول الآية: وقد روي في سبب نزول هذه الآيه روايتان: الأولى أنها نزلت في اليهود لما حاولوا معرفة مدة بقاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم من حساب الحروف المقطعة التي تستفتح به بعض السور، وهذه يرويها أصحاب السير، ورواها ابن جرير الطبري، وقد ضعفها ابن كثير في تفسيره لأول سورة البقرة.
الرواية الثانية: أنها نزلت في نصارى نجران وأنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ألست تزعم أنه كلمة الله، وروح منه؟ قال: «بلى». قالوا: فحسبنا. فأنزل الله هذه الآية، وهذه أخرجها ابن جرير في تفسيره بسند مرسل.
ووجه الاستدلال بهاذين السببين هو: أن الحكمة من وضع الحروف المقطعة في أوائل السور و كيفية كون عيسى روح من الله مما اختص الله بعلمه، وهذا يؤيد أن من القرآن متشابه لا يعلمه إلا الله، وهذا الأخير دليل على رجحان الوقف على الاسم الشريف، وبالله التوفيق.
قال ابن عاصم:
وجاء ما لم يُدر للتنبيه*على الذي للراسخين فيه.
وذلك التصديق والإيمان*وليس يُستبعد هذا الشان.
في هذه الأبيات يذكر الناظم الجواب عن أشهر مناقشات من قالوا بأن الوقف في الآية على قوله {والراسخون} وأن منهم من يعلم تأويل المتشابه،
فإنهم ناقشوا قول الجمهور بأنه: (لو اختص الله بعلم المتشابه لكان الله تعالى وتقدس قد خاطب خلقه بكلام لا يفهمونه، ثم أمرهم بتدبره والعمل به، وكلف الخلق بما لا يسعهم، وهذا باطل؛ لأن الله -عز وجل- قد نفى هذا بكلامه في كتابه، وأخبر بأنه لا يكلف نفسا إلا وسعها).
وقد أجاب الناظم -رحمه الله- عن هذا الإعتراض بهذين البيتين، وبين أن من مقاصد التكليف بما لا يعرف معناه هو ابتلاء الخلق هل يؤمنوا، ويصدقوا، ويقولوا كما قال الراسخون {آمنا به كل من عند ربنا}؟ أم يكذبوا، وترتاب أنفسهم، ويتبعون ما تشابه ابتغاء الفتنة، وابتغاء تأويله،
وكأنه أراد أن يذكر القارئ بما ذكره في باب التكليف عند قوله:
(القصد بالتكليف صرف الخلق*عن داعيات النفس نحو الحق)، من أن مقصد التكليف الأساسي هو إخراج العباد عن هوى أنفسهم نحو التسليم والإنقياد لأمر الله جل وعلا، فكأن الناظم أراد أن يبين أن مخاطبة الخلق بالمتشابه توافق هذا المقصد وتؤيده، (وليس يستبعد هذا الشان) كما قال رحمه الله، وبالله التوفيق.
وجاء ما لم يُدر للتنبيه*على الذي للراسخين فيه.
وذلك التصديق والإيمان*وليس يُستبعد هذا الشان.
في هذه الأبيات يذكر الناظم الجواب عن أشهر مناقشات من قالوا بأن الوقف في الآية على قوله {والراسخون} وأن منهم من يعلم تأويل المتشابه،
فإنهم ناقشوا قول الجمهور بأنه: (لو اختص الله بعلم المتشابه لكان الله تعالى وتقدس قد خاطب خلقه بكلام لا يفهمونه، ثم أمرهم بتدبره والعمل به، وكلف الخلق بما لا يسعهم، وهذا باطل؛ لأن الله -عز وجل- قد نفى هذا بكلامه في كتابه، وأخبر بأنه لا يكلف نفسا إلا وسعها).
وقد أجاب الناظم -رحمه الله- عن هذا الإعتراض بهذين البيتين، وبين أن من مقاصد التكليف بما لا يعرف معناه هو ابتلاء الخلق هل يؤمنوا، ويصدقوا، ويقولوا كما قال الراسخون {آمنا به كل من عند ربنا}؟ أم يكذبوا، وترتاب أنفسهم، ويتبعون ما تشابه ابتغاء الفتنة، وابتغاء تأويله،
وكأنه أراد أن يذكر القارئ بما ذكره في باب التكليف عند قوله:
(القصد بالتكليف صرف الخلق*عن داعيات النفس نحو الحق)، من أن مقصد التكليف الأساسي هو إخراج العباد عن هوى أنفسهم نحو التسليم والإنقياد لأمر الله جل وعلا، فكأن الناظم أراد أن يبين أن مخاطبة الخلق بالمتشابه توافق هذا المقصد وتؤيده، (وليس يستبعد هذا الشان) كما قال رحمه الله، وبالله التوفيق.
قال ابن عاصم:
مع كونه لم يأت في الأحكام*فيُطلبَ البيان في الإعلام.
ألا ترى ما قال في الأبِّ عُمر*وما به في عدم البحث اعتذر.
فحكم ذا للراسخين يُعتبر*منزَّلا منزل أبٍّ لعمر.
والقول في الآية باشتمال*معْ ذا على تشابه الإجمال.
مرتَكَبٌ صعب ومما يَلزم*عليه أن يَقِلَّ فيه المحكم.
في هذه الأبيات يستدرك الناظم على القسمة الأصولية -التي نقلها في أول الأبيات- وهي تقسيم التشابه إلى حقيقي وعارض باستدراكين:
الأول: أن التشابه الحقيقي لا يقع في الأحكام، يقصد أحكام الحلال والحرام، ولكن قد يعرض لها صفة اشتباه بسبب عموم مخصوص أوإجمال أونسخ أواشتراك ونحوه، لكن هذا الاشتباه ليس عارضا من أصل الشريعة؛ لأن الشريعة وضحت المخصص، وبينت المجمل، وأظهرت الناسخ، (وإنما عرض لتقصير في البحث، أو زيع عن طريق البيان اتباعا للهوى) -كما قال الشاطبي- ثم يستدل الناظم على أن التشابه الحقيقي لا يقع في الأحكام بقصة عمر: وهي قصة رواها ابن أبي شيبة والحاكم وابن جرير الطبري والاسماعيلي في مستخرجه على البخاري -بأسانيد صححها ابن كثير وابن حجر- وكلهم رووها من طريق أنس أن عمر -رضي الله عنه- قرأ على المنبر: {فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا}، ثم قال: (كل هذا قد عرفناه، فما الأب؟ ثم رفع عصا كانت في يده، فقال: هذا لعمر الله هو التكلف، فما عليك أن لا تدري ما الأب، اتبعوا ما بين لكم من هذا الكتاب فاعملوا به، وما لم تعرفوه فكلوه إلى ربه)، ووجه استدلال الناظم بها: أن عمر اعتذر عن البحث عن معنى (الأب) بقوله: (هذا لعمر الله هو التكلف، فما عليك أن لا تدري ما الأب)، فعده من التكلف؛ لأنه علم لا يثمر عملا، ولا يخفى بجهله معنى الآية، ويكفي فيه الإيمان بأنه من القرآن وأنه من عند الله وأن يوكل علمه إلى الله، فعلمنا من هذا -بطريق المفهوم- أن ما يضر جهله لتوقف العمل على معرفته -وهو الأحكام التكليفية- أنه لا عذر في ترك البحث عن معناه، وهذا يقتضي أن له معنى، وهذا يدل على أن التشابه الحقيقي لا يقع فيه.
الثاني: أن آية المحكم والمتشابه لا يدخل فيها التشابه العارض وهو تشابه الإجمال، وهذا يعني أن المتشابه العارض -أو تشابه الإجمال كما عبر الناظم- لا يختص الله بمعرفته بل قد يعرفه الراسخون، ولا يمدح من اكتفى بتفويض علمه لله جل وعلا، ولا يذم من تتبع معناه وبحث فيه، ويستدل الناظم على ذلك: بأن التشابه العارض يقع كثيرا للناظر في كتاب الله، فلو كان داخلا في التشابه المذكور في الآية للزم من ذلك أن يكون المتشابه في القرآن أكثر من المحكم، وأن يكون أكثر القرآن مما اختص الله بعلمه، وأن الراسخون في العلم لا يعلمون أكثره، وهذا (مرتكب صعب)؛ لأن الله أخبرنا أن أصل الكتاب ومعظمه هو المحكم، وأمرنا بتدبره، وأخبرنا أنه شفاء لما في الصدور، وأنه هدى ورحمة للمؤمنين، وهذا كله لا يكون إلا إذا كان أكثره متضح غير متشابه، هذا هو مقصود الناظم فيما يظهر، وبالله التوفيق.
مع كونه لم يأت في الأحكام*فيُطلبَ البيان في الإعلام.
ألا ترى ما قال في الأبِّ عُمر*وما به في عدم البحث اعتذر.
فحكم ذا للراسخين يُعتبر*منزَّلا منزل أبٍّ لعمر.
والقول في الآية باشتمال*معْ ذا على تشابه الإجمال.
مرتَكَبٌ صعب ومما يَلزم*عليه أن يَقِلَّ فيه المحكم.
في هذه الأبيات يستدرك الناظم على القسمة الأصولية -التي نقلها في أول الأبيات- وهي تقسيم التشابه إلى حقيقي وعارض باستدراكين:
الأول: أن التشابه الحقيقي لا يقع في الأحكام، يقصد أحكام الحلال والحرام، ولكن قد يعرض لها صفة اشتباه بسبب عموم مخصوص أوإجمال أونسخ أواشتراك ونحوه، لكن هذا الاشتباه ليس عارضا من أصل الشريعة؛ لأن الشريعة وضحت المخصص، وبينت المجمل، وأظهرت الناسخ، (وإنما عرض لتقصير في البحث، أو زيع عن طريق البيان اتباعا للهوى) -كما قال الشاطبي- ثم يستدل الناظم على أن التشابه الحقيقي لا يقع في الأحكام بقصة عمر: وهي قصة رواها ابن أبي شيبة والحاكم وابن جرير الطبري والاسماعيلي في مستخرجه على البخاري -بأسانيد صححها ابن كثير وابن حجر- وكلهم رووها من طريق أنس أن عمر -رضي الله عنه- قرأ على المنبر: {فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا}، ثم قال: (كل هذا قد عرفناه، فما الأب؟ ثم رفع عصا كانت في يده، فقال: هذا لعمر الله هو التكلف، فما عليك أن لا تدري ما الأب، اتبعوا ما بين لكم من هذا الكتاب فاعملوا به، وما لم تعرفوه فكلوه إلى ربه)، ووجه استدلال الناظم بها: أن عمر اعتذر عن البحث عن معنى (الأب) بقوله: (هذا لعمر الله هو التكلف، فما عليك أن لا تدري ما الأب)، فعده من التكلف؛ لأنه علم لا يثمر عملا، ولا يخفى بجهله معنى الآية، ويكفي فيه الإيمان بأنه من القرآن وأنه من عند الله وأن يوكل علمه إلى الله، فعلمنا من هذا -بطريق المفهوم- أن ما يضر جهله لتوقف العمل على معرفته -وهو الأحكام التكليفية- أنه لا عذر في ترك البحث عن معناه، وهذا يقتضي أن له معنى، وهذا يدل على أن التشابه الحقيقي لا يقع فيه.
الثاني: أن آية المحكم والمتشابه لا يدخل فيها التشابه العارض وهو تشابه الإجمال، وهذا يعني أن المتشابه العارض -أو تشابه الإجمال كما عبر الناظم- لا يختص الله بمعرفته بل قد يعرفه الراسخون، ولا يمدح من اكتفى بتفويض علمه لله جل وعلا، ولا يذم من تتبع معناه وبحث فيه، ويستدل الناظم على ذلك: بأن التشابه العارض يقع كثيرا للناظر في كتاب الله، فلو كان داخلا في التشابه المذكور في الآية للزم من ذلك أن يكون المتشابه في القرآن أكثر من المحكم، وأن يكون أكثر القرآن مما اختص الله بعلمه، وأن الراسخون في العلم لا يعلمون أكثره، وهذا (مرتكب صعب)؛ لأن الله أخبرنا أن أصل الكتاب ومعظمه هو المحكم، وأمرنا بتدبره، وأخبرنا أنه شفاء لما في الصدور، وأنه هدى ورحمة للمؤمنين، وهذا كله لا يكون إلا إذا كان أكثره متضح غير متشابه، هذا هو مقصود الناظم فيما يظهر، وبالله التوفيق.
قال ابن عاصم:
(فصل في المبين والمجمل والظاهر والمؤول)
يذكر المصنف هنا: المبين، والمجمل، والظاهر، والمؤول، وقد ذكر في الفصل السابق: المحكم، والمتشابه، وسيذكر لاحقا: العام، والخاص، والمطلق، والمقيد، والأمر، والنهي، والنسخ، فما هي حقيقة هذه الأسماء؟ ولماذا ذكرت بعد الدليل الأول وهو الكتاب؟
هذه الأسماء -وإن شئت قل الأحكام- هي صفات تعرض للألفاظ، فاللفظ قد يكون عاما يشمل أفرادا لا حصر لها، وقد يكون مجملا لا يفيد معنى بعينه، وقد يكون متشابها، أو محكما، أو خاصا، أو أمرا، أو نهيا، أو غيرها من عوارض الألفاظ، فهي إذن صفات يوصف بها اللفظ، وإن شئت قل يحكم بها على اللفظ، فيحكم بأن هذا خاصا، وذاك مطلقا، وقد اصطلح أهل الأصول على تسميتها بعوارض الألفاظ، كأنهم أخذوها من معنى العارض في اللغة، وإن كان بعض المتكلمين يرجع هذا الاصطلاح إلى تقسيم من تقاسيم المنطق الأرسطي.
وأما ذكرها بعد الدليل الأول فقد يعتقد الناظر لأول وهلة أنه غريب؛ لأن المشهور من طريقة الناظم أنه يتابع ابن جزي أو الشاطبي، والناظم هنا خالفهما جميعا، ولا يخالفهما في الغالب إلا لمعنى يريده، فإن الشاطبي جعل الكلام على عوارض الألفاظ في مقدمات الكلام على الأدلة، وابن جزي جعلها في المقدمات اللغوية التي في أول الكتاب، والناظم هنا لم يجعلها في المقدمات اللغوية، ولم يذكرها قبل الأدلة، وفي ظني أن الناظم ذكرها هنا استطرادا، فإنه لما ذكر الكتاب وذكر أنه منه محكم ومتشابه، وهما من عوارض الألفاظ، فناسب أن يكمل بقية العوارض؛ كأنه رأى أنها تناسب التسلسل الذهني لمن يحفظ هذه المنظومة، فإن حافظ المنظومة لما عرف أن من الكتاب محكم ومتشابه كان من المناسب أن يعرف أنه منه عام وخاص، ومطلق ومقيد، وأمر ونهي، ومجمل ومبين، وهكذا، وهذا أجود للطالب من طريقة ابن جزي ومن طريقة الشاطبي، وأجود من طريقة الآمدي ومن معه ممن أخرها بعد الكتاب والسنة والإجماع، وعلى كلٍ فإن المهم هو معرفة أنها تختص بالكتاب والسنة دون بقية الأدلة، وبالله التوفيق.
(فصل في المبين والمجمل والظاهر والمؤول)
يذكر المصنف هنا: المبين، والمجمل، والظاهر، والمؤول، وقد ذكر في الفصل السابق: المحكم، والمتشابه، وسيذكر لاحقا: العام، والخاص، والمطلق، والمقيد، والأمر، والنهي، والنسخ، فما هي حقيقة هذه الأسماء؟ ولماذا ذكرت بعد الدليل الأول وهو الكتاب؟
هذه الأسماء -وإن شئت قل الأحكام- هي صفات تعرض للألفاظ، فاللفظ قد يكون عاما يشمل أفرادا لا حصر لها، وقد يكون مجملا لا يفيد معنى بعينه، وقد يكون متشابها، أو محكما، أو خاصا، أو أمرا، أو نهيا، أو غيرها من عوارض الألفاظ، فهي إذن صفات يوصف بها اللفظ، وإن شئت قل يحكم بها على اللفظ، فيحكم بأن هذا خاصا، وذاك مطلقا، وقد اصطلح أهل الأصول على تسميتها بعوارض الألفاظ، كأنهم أخذوها من معنى العارض في اللغة، وإن كان بعض المتكلمين يرجع هذا الاصطلاح إلى تقسيم من تقاسيم المنطق الأرسطي.
وأما ذكرها بعد الدليل الأول فقد يعتقد الناظر لأول وهلة أنه غريب؛ لأن المشهور من طريقة الناظم أنه يتابع ابن جزي أو الشاطبي، والناظم هنا خالفهما جميعا، ولا يخالفهما في الغالب إلا لمعنى يريده، فإن الشاطبي جعل الكلام على عوارض الألفاظ في مقدمات الكلام على الأدلة، وابن جزي جعلها في المقدمات اللغوية التي في أول الكتاب، والناظم هنا لم يجعلها في المقدمات اللغوية، ولم يذكرها قبل الأدلة، وفي ظني أن الناظم ذكرها هنا استطرادا، فإنه لما ذكر الكتاب وذكر أنه منه محكم ومتشابه، وهما من عوارض الألفاظ، فناسب أن يكمل بقية العوارض؛ كأنه رأى أنها تناسب التسلسل الذهني لمن يحفظ هذه المنظومة، فإن حافظ المنظومة لما عرف أن من الكتاب محكم ومتشابه كان من المناسب أن يعرف أنه منه عام وخاص، ومطلق ومقيد، وأمر ونهي، ومجمل ومبين، وهكذا، وهذا أجود للطالب من طريقة ابن جزي ومن طريقة الشاطبي، وأجود من طريقة الآمدي ومن معه ممن أخرها بعد الكتاب والسنة والإجماع، وعلى كلٍ فإن المهم هو معرفة أنها تختص بالكتاب والسنة دون بقية الأدلة، وبالله التوفيق.