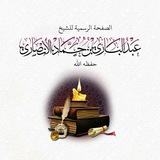Forwarded from فيصل بن حماد الدرسي
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🌙 شهر مبارك علينا وعليكم... أسأل الله أن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه، وحسن العمل فيه، في خير وعافية، ويتقبله منا ومنكم🌙
بسم الله الرحمن الرحيم
سألني بعض الأساتذة الأفاضل عن كتاب "شجرة النور الزكيَّة في طبقات المالكيَّة" للعلامة محمَّد بن محمَّد مخلوف التونسي المتوفى عام 1360 هـ رحمه الله تعالى: ما الصواب في قراءة كلمة "النور"، هل هو ضم النون أو فتحها؟ وطلب تفصيلَ الكلام في ذلك وتبيينَه، لأن بعض الباحثين المعاصرين يُرجِّح أنه "النَّور" بفتح النون.
فأقول وبالله تعالى التوفيق:
ظاهرٌ من العنوان أن المؤلف يريد بقوله "شجرة النُّور الزكيَّة" تشبيهَ علماء المذهب المالكي - رحمهم الله - بالشجرة العظيمة التي رسختْ جُذورُها وتفرَّعت غُصونُها، وملأت الآفاق بنور الفقه والعلم.
كما أنَّ من المشهور وصف العلم بكونه نُورًا، وهو أشهر من أن يُكثَّرَ فيه الكلام، ويردَّدَ فيه القول.
فهذا إمام المذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى أُثِر عنه قوله: إنَّ العلم ليس بكثرة الرواية، إنما العلمُ نٌورٌ يجعلُه الله في القلب. الجامع للخطيب (2/ 174)
ولما قرأ الإمام الشافعي الموطَّأ عليه حِفْظًا، وأعجبتْه قراءتُه، قال له: إن الله تعالى قد ألقى على قلبِك نُورًا فلا تُطفئْه بالمعصية. تهذيب الأسماء واللغات (1/ 47)
وروى الإمام مالك في الموطأ بلاغا: أن لقمان الحكيم أوصى ابنه فقال: يا بني جالس العلماء، وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة، كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء.
ونور الحكمة من جليل العلم.
وقال سُحنون جامع المدونة – رحمه الله -: من لم يعمل بعلمه لم ينفعه العلم بل يضره، وإنما العلم نور يضعه الله في القلوب، فإذا عمل به نوَّر قلبَه، وإن لم يعمل به وأحب الدنيا أعمى حبُّ الدنيا قلبَه ولم ينوره العلم. الديباج المُذْهب (2/ 38)
وفي البيتين المنسوبين إلى الإمام الشافعي قال:
شكوتُ إلى وكيع سوء حفظي
فأرشدني إلى ترك المعاصي
وأخبرني بأنَّ العلم نورٌ
ونور الله لا يعطى لعاصِ
وقال الكمال ابن الأنباري:
العلمُ أوفى حِليــــــةٍ ولباسِ
والعقــــلُ أوقى جُنةِ الأكياسِ
والعلمُ نورُ يُهـــتدى بضيائِهِ
وبه يَسودُ الناسُ فــوق الناسِ
الوافي بالوفيات (18 / 149)
وأشار إلى كون العلم نورًا سابقٌ البربري في قوله:
والعلمُ يجلو العَمى عن قلبِ صاحبِهِ
كما يُجلِّي سوادَ الظُّلمة القمرُ
جامع بيان العلم وفضله (1/ 221)
والمراد بإيراد هذه الآثار والأشعار - المتقدم ذكرها - بيان أنه من المشهور تشبيهُ العلم بالنور، وأنه المقصود في العنوان، إذ الفقه أجل العلوم، (ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين).
ويكفي للجزم بصحة ضبط النُّور - بالضم -:
أنَّ مؤلف الكتاب قد أشار إلى مراده بالنُّور المذكور في العنوان، في أثناء وصفه لكتابه في مقدمته حيث قال:
(ثم لخصتُ المقصِدَ في صورة شجرة، بعبارات وجيزة محررة، أغصانها بالدر يانعة، وثمراتُها طيبة نافعة، وأنوارُها ساطعة لامعة، روضُها كله زَهَر، وسلكها كله دُرَر، شجرةٌ تُقتبس أنوارُها، وتُجتنى ثمارها وأزهارها، لم تزل من البركة والسمو في النماء، أصلها ثابت وفرعها في السماء، طابت أصلاً، وزكت فرعاً وفصلاً، وسميته "شجرة النور الزكية في طبقات المالكية"). مقدمة الكتاب (ص 11)
فأشار مرتين إلى مقصوده بالنُّور في العنوان:
الأولى: حينما قال: "وأنوارها ساطعة لامعة"، فإنَّ السطوع من شأن النور والضياء، وكذلك اللمعان.
والثانية: في قوله: "شجرة تقتبس أنوارها"، فإنَّ الاقتباس يكون من الضوء وموضعه، لا من الزهَر والثَّمَر.
وقوله هذا كالصريح في ترجيح هذا الضبط، لاقتران الشجرة بالأنوار، كما في العنوان.
كما أنه سبق أن أومأ لذلك في تحميد الكتاب حين قال: (الحمد لله الذي أنزل القرآن وهدى مَن أحبَّ لاجتناءِ أزهارِه، واقتباس أنوارِه).
فالأنوار هنا جمع نُور، وهو محل الاستضاءة والاقتباس.
وأما النَّوْر – بالفتح - فعبَّر عنه بمرادفه، وهو الزَّهَر في ثلاثة مواضع:
الأول الماضي قريبا في التحميد.
والثاني في قوله: روضُها كله زَهَر.
والثالث في قوله: تُجتنى ثمارها وأزهارها.
فكأنَّ المؤلف خَشِي من هذا الذي سأل عنه السائل من التباس النُّور – بالضم - بالنَّور – بالفتح –، فتحاشا أن يذكر كلمة النَّوْر في مقدمته، وعبَّر عنها بمرادفتها وهي الزَّهَر، بينما كرَّر كلمة الأنوار جمع نُور في أكثر من موضع.
ثم إنه على القول بأنَّ الصواب نَوْر - بالفتح - فإنَّ معنى العنوان يضعفُ عن معناه إذا كانت الكلمة بالضم، فيصير المقصود به:
هذه شجرة العلم ذات الرائحة الزكية والعرف الطيب.
وأما على الضبط الصحيح، وهو ضم النون، فإنَّ هذا المعنى يتحقق، ويُضاف إليه ما هو أعلى منه وأولى.
فيكون معنى قوله: شجرة النور الزكية" أي: هذه شجرة العلم، المنيرة بأنوار أهلها، والزكية بطيب عَرْفها.
والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
سألني بعض الأساتذة الأفاضل عن كتاب "شجرة النور الزكيَّة في طبقات المالكيَّة" للعلامة محمَّد بن محمَّد مخلوف التونسي المتوفى عام 1360 هـ رحمه الله تعالى: ما الصواب في قراءة كلمة "النور"، هل هو ضم النون أو فتحها؟ وطلب تفصيلَ الكلام في ذلك وتبيينَه، لأن بعض الباحثين المعاصرين يُرجِّح أنه "النَّور" بفتح النون.
فأقول وبالله تعالى التوفيق:
ظاهرٌ من العنوان أن المؤلف يريد بقوله "شجرة النُّور الزكيَّة" تشبيهَ علماء المذهب المالكي - رحمهم الله - بالشجرة العظيمة التي رسختْ جُذورُها وتفرَّعت غُصونُها، وملأت الآفاق بنور الفقه والعلم.
كما أنَّ من المشهور وصف العلم بكونه نُورًا، وهو أشهر من أن يُكثَّرَ فيه الكلام، ويردَّدَ فيه القول.
فهذا إمام المذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى أُثِر عنه قوله: إنَّ العلم ليس بكثرة الرواية، إنما العلمُ نٌورٌ يجعلُه الله في القلب. الجامع للخطيب (2/ 174)
ولما قرأ الإمام الشافعي الموطَّأ عليه حِفْظًا، وأعجبتْه قراءتُه، قال له: إن الله تعالى قد ألقى على قلبِك نُورًا فلا تُطفئْه بالمعصية. تهذيب الأسماء واللغات (1/ 47)
وروى الإمام مالك في الموطأ بلاغا: أن لقمان الحكيم أوصى ابنه فقال: يا بني جالس العلماء، وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة، كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء.
ونور الحكمة من جليل العلم.
وقال سُحنون جامع المدونة – رحمه الله -: من لم يعمل بعلمه لم ينفعه العلم بل يضره، وإنما العلم نور يضعه الله في القلوب، فإذا عمل به نوَّر قلبَه، وإن لم يعمل به وأحب الدنيا أعمى حبُّ الدنيا قلبَه ولم ينوره العلم. الديباج المُذْهب (2/ 38)
وفي البيتين المنسوبين إلى الإمام الشافعي قال:
شكوتُ إلى وكيع سوء حفظي
فأرشدني إلى ترك المعاصي
وأخبرني بأنَّ العلم نورٌ
ونور الله لا يعطى لعاصِ
وقال الكمال ابن الأنباري:
العلمُ أوفى حِليــــــةٍ ولباسِ
والعقــــلُ أوقى جُنةِ الأكياسِ
والعلمُ نورُ يُهـــتدى بضيائِهِ
وبه يَسودُ الناسُ فــوق الناسِ
الوافي بالوفيات (18 / 149)
وأشار إلى كون العلم نورًا سابقٌ البربري في قوله:
والعلمُ يجلو العَمى عن قلبِ صاحبِهِ
كما يُجلِّي سوادَ الظُّلمة القمرُ
جامع بيان العلم وفضله (1/ 221)
والمراد بإيراد هذه الآثار والأشعار - المتقدم ذكرها - بيان أنه من المشهور تشبيهُ العلم بالنور، وأنه المقصود في العنوان، إذ الفقه أجل العلوم، (ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين).
ويكفي للجزم بصحة ضبط النُّور - بالضم -:
أنَّ مؤلف الكتاب قد أشار إلى مراده بالنُّور المذكور في العنوان، في أثناء وصفه لكتابه في مقدمته حيث قال:
(ثم لخصتُ المقصِدَ في صورة شجرة، بعبارات وجيزة محررة، أغصانها بالدر يانعة، وثمراتُها طيبة نافعة، وأنوارُها ساطعة لامعة، روضُها كله زَهَر، وسلكها كله دُرَر، شجرةٌ تُقتبس أنوارُها، وتُجتنى ثمارها وأزهارها، لم تزل من البركة والسمو في النماء، أصلها ثابت وفرعها في السماء، طابت أصلاً، وزكت فرعاً وفصلاً، وسميته "شجرة النور الزكية في طبقات المالكية"). مقدمة الكتاب (ص 11)
فأشار مرتين إلى مقصوده بالنُّور في العنوان:
الأولى: حينما قال: "وأنوارها ساطعة لامعة"، فإنَّ السطوع من شأن النور والضياء، وكذلك اللمعان.
والثانية: في قوله: "شجرة تقتبس أنوارها"، فإنَّ الاقتباس يكون من الضوء وموضعه، لا من الزهَر والثَّمَر.
وقوله هذا كالصريح في ترجيح هذا الضبط، لاقتران الشجرة بالأنوار، كما في العنوان.
كما أنه سبق أن أومأ لذلك في تحميد الكتاب حين قال: (الحمد لله الذي أنزل القرآن وهدى مَن أحبَّ لاجتناءِ أزهارِه، واقتباس أنوارِه).
فالأنوار هنا جمع نُور، وهو محل الاستضاءة والاقتباس.
وأما النَّوْر – بالفتح - فعبَّر عنه بمرادفه، وهو الزَّهَر في ثلاثة مواضع:
الأول الماضي قريبا في التحميد.
والثاني في قوله: روضُها كله زَهَر.
والثالث في قوله: تُجتنى ثمارها وأزهارها.
فكأنَّ المؤلف خَشِي من هذا الذي سأل عنه السائل من التباس النُّور – بالضم - بالنَّور – بالفتح –، فتحاشا أن يذكر كلمة النَّوْر في مقدمته، وعبَّر عنها بمرادفتها وهي الزَّهَر، بينما كرَّر كلمة الأنوار جمع نُور في أكثر من موضع.
ثم إنه على القول بأنَّ الصواب نَوْر - بالفتح - فإنَّ معنى العنوان يضعفُ عن معناه إذا كانت الكلمة بالضم، فيصير المقصود به:
هذه شجرة العلم ذات الرائحة الزكية والعرف الطيب.
وأما على الضبط الصحيح، وهو ضم النون، فإنَّ هذا المعنى يتحقق، ويُضاف إليه ما هو أعلى منه وأولى.
فيكون معنى قوله: شجرة النور الزكية" أي: هذه شجرة العلم، المنيرة بأنوار أهلها، والزكية بطيب عَرْفها.
والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
🔹 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. وبعد.
💫فضل الأعمال الصالحة في العشر الأواخر من رمضان💫
في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَحْيَا ليلَه، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَجَدَّ، وَشَدَّ الْمِئْزَرَ .
وعنها قالت: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ.
فمن أعمال العشر الأواخر التي ينبغي أن يغتنمها المسلم:
1⃣ إحياء ليلها بصلاة القيام، والذكر والدعاء، وقراءة القرآن.
2⃣ تنبيه الأهل من النساء والأولاد على فضل هذه الليالي، وحثهم على صلاة القيام فيها، والبعد عن الغفلة واللهو.
3⃣ الاجتهاد في العبادة واستغراق الوقت فيها، وتركُ بعض المباحات استغلالا لهذه الليالي الفاضلة.
4⃣ تلاوة القرآن في ليالي العشر وأيامها فإنه أفضل الأذكار، وأحسن ما تصرف فيه الأوقات.
فقد كان جبريل عليه السلام يلقى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فِي كل ليلةٍ من رَمَضَان فيدارسه الْقُرْآن.
والعشر أفضل ليالي رمضان، فهي أحرى بتلاوة القرآن والقيام به.
5⃣ تحرِّي ليلة القدر، وخصوصًا في ليالي الوتر منها، قال عليه الصلاة والسلام: "تحرَّوْا ليلة القدر في الوِتر من العشر الأواخر من رمضان".
وقال صلى الله عليه وسلم: "من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا ، غفر له ما تقدم من ذنبه".
6⃣ كثرة الدعاء بخيري الدنيا والآخرة، ومناجاة الله تبارك وتعالى، فإنَّ الصائم يُرجَى استجابة دعائه، وفي ليالي العشر يتأكد استجابة الدعاء خصوصا في السَّحَر وبين الأذان والإقامة، وفي السجود.
فليكثر المسلم من الدعاء، ويتحرى جوامعَه الواردة في الكتاب والسنة. فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بالدعاء في ليالي العشر، فرُوي عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتَ إن وافقتُ ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني".
7⃣ الاعتكاف، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في هذا العشر طلبًا لإدراك ليلة القدر، وتفرغًا للخلوة لمناجاة ربه وذكره ودعائه.
8⃣ الإكثار من الاستغفار؛ فإنه من أعظم أسباب المغفرة، والاستغفار ختام الأعمال الصالحة كلها، فيُختم به الصلاة والحج وقيام الليل وتُختم به المجالس.
قال الحسن البصري: أكثروا من الاستغفار فإنكم لا تدرون متى تنزل الرحمة.
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار يأمرهم بختم رمضان بالاستغفار وصدقة الفطر: فإن الفِطْرةَ طُهْرة للصائم من اللغو والرفث، والاستغفارَ يُرَقِّعُ ما تَخرَّق من الصيام باللغو والرفث.
📌 وينبغي للمسلم في هذه الليالي المباركة الحذرُ مما يُضيِّعُ أوقاتها الفاضلة، ويمحق بركتها، من الاشتغال بوسائل التواصل الحديثة، أو مشاهدة القنوات الفضائية، أو حضور مجالس اللهو واللعب والغفلة، فما هي إلا أيام قليلة وتنقضي، ومن الغَبْن العظيم التفريط فيها، والانشغال بغير الأعمال الصالحات، التي بها رفع الدرجات وتكفير الذنوب والسيئات.
وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. وبعد.
💫فضل الأعمال الصالحة في العشر الأواخر من رمضان💫
في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَحْيَا ليلَه، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَجَدَّ، وَشَدَّ الْمِئْزَرَ .
وعنها قالت: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ.
فمن أعمال العشر الأواخر التي ينبغي أن يغتنمها المسلم:
1⃣ إحياء ليلها بصلاة القيام، والذكر والدعاء، وقراءة القرآن.
2⃣ تنبيه الأهل من النساء والأولاد على فضل هذه الليالي، وحثهم على صلاة القيام فيها، والبعد عن الغفلة واللهو.
3⃣ الاجتهاد في العبادة واستغراق الوقت فيها، وتركُ بعض المباحات استغلالا لهذه الليالي الفاضلة.
4⃣ تلاوة القرآن في ليالي العشر وأيامها فإنه أفضل الأذكار، وأحسن ما تصرف فيه الأوقات.
فقد كان جبريل عليه السلام يلقى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فِي كل ليلةٍ من رَمَضَان فيدارسه الْقُرْآن.
والعشر أفضل ليالي رمضان، فهي أحرى بتلاوة القرآن والقيام به.
5⃣ تحرِّي ليلة القدر، وخصوصًا في ليالي الوتر منها، قال عليه الصلاة والسلام: "تحرَّوْا ليلة القدر في الوِتر من العشر الأواخر من رمضان".
وقال صلى الله عليه وسلم: "من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا ، غفر له ما تقدم من ذنبه".
6⃣ كثرة الدعاء بخيري الدنيا والآخرة، ومناجاة الله تبارك وتعالى، فإنَّ الصائم يُرجَى استجابة دعائه، وفي ليالي العشر يتأكد استجابة الدعاء خصوصا في السَّحَر وبين الأذان والإقامة، وفي السجود.
فليكثر المسلم من الدعاء، ويتحرى جوامعَه الواردة في الكتاب والسنة. فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بالدعاء في ليالي العشر، فرُوي عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتَ إن وافقتُ ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني".
7⃣ الاعتكاف، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في هذا العشر طلبًا لإدراك ليلة القدر، وتفرغًا للخلوة لمناجاة ربه وذكره ودعائه.
8⃣ الإكثار من الاستغفار؛ فإنه من أعظم أسباب المغفرة، والاستغفار ختام الأعمال الصالحة كلها، فيُختم به الصلاة والحج وقيام الليل وتُختم به المجالس.
قال الحسن البصري: أكثروا من الاستغفار فإنكم لا تدرون متى تنزل الرحمة.
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار يأمرهم بختم رمضان بالاستغفار وصدقة الفطر: فإن الفِطْرةَ طُهْرة للصائم من اللغو والرفث، والاستغفارَ يُرَقِّعُ ما تَخرَّق من الصيام باللغو والرفث.
📌 وينبغي للمسلم في هذه الليالي المباركة الحذرُ مما يُضيِّعُ أوقاتها الفاضلة، ويمحق بركتها، من الاشتغال بوسائل التواصل الحديثة، أو مشاهدة القنوات الفضائية، أو حضور مجالس اللهو واللعب والغفلة، فما هي إلا أيام قليلة وتنقضي، ومن الغَبْن العظيم التفريط فيها، والانشغال بغير الأعمال الصالحات، التي بها رفع الدرجات وتكفير الذنوب والسيئات.
وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
🌙 "ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﻥَّ ﻟﻴﻠﺔ ﺳﺒﻊ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﻫﻲ ليلة القدر" 🌙
📗 ﺃﺧﺮﺝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ (762) ﻋﻦ ﺯِﺭ ﺑﻦ ﺣُﺒﻴﺶ ﻗﺎﻝ: ﺳﻤﻌﺖُ ﺃُﺑﻲَّ ﺑﻦَ ﻛﻌﺐ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻳﻘﻮﻝ - ﻭﻗﻴﻞ ﻟﻪ: ﺇﻥ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻳﻘﻮﻝ: ﻣﻦ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺴَّﻨﺔَ ﺃﺻﺎﺏ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭ - ﻓﻘﺎﻝ ﺃُﺑَﻲٌّ: ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﻫﻮ، ﺇﻧﻬﺎ ﻟﻔﻲ ﺭﻣﻀﺎﻥ - ﻳَﺤﻠﻒ ﻣﺎ ﻳَﺴﺘﺜﻨﻲ - ﻭﻭﺍﻟﻠﻪ ﺇﻧﻲ ﻷﻋﻠﻢُ ﺃﻱَّ ﻟﻴﻠﺔٍ ﻫﻲ؛ ﻫﻲ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔُ ﺍﻟﺘﻲ ﺃَﻣﺮﻧﺎ ﺑﻬﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﻘﻴﺎﻣِﻬﺎ، ﻫﻲ ﻟﻴﻠﺔُ ﺻﺒﻴﺤﺔِ ﺳﺒﻊٍ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ، ﻭﺃﻣﺎﺭﺗُﻬﺎ ﺃﻥ ﺗَﻄﻠُﻊَ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻓﻲ ﺻﺒﻴﺤﺔ ﻳﻮﻣِﻬﺎ ﺑﻴﻀﺎﺀَ ﻻ ﺷُﻌﺎﻉ ﻟﻬﺎ.
📙 ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺃﻳﻀﺎ (1165) ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ، ﻗﺎﻝ: ﺭﺃﻯ ﺭﺟﻞ ﺃﻥ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻟﻴﻠﺔ ﺳﺒﻊ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ، ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: «ﺃَﺭﻯ ﺭُﺅﻳﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺍﻷﻭﺍﺧﺮ، ﻓﺎﻃﻠﺒﻮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺗﺮ ﻣﻨﻬﺎ».
📘 ﻭأخرج أيضا (1170) ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ، ﻗﺎﻝ: ﺗﺬﺍﻛﺮﻧﺎ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻋﻨﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎﻝ: «ﺃﻳﻜﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺣﻴﻦ ﻃﻠﻊ ﺍﻟﻘﻤﺮ، ﻭﻫﻮ ﻣﺜﻞ ﺷﻖ ﺟﻔﻨﺔ».
ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﺎﻓﺮ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ: ﺃﻱ ﻟﻴﻠﺔ ﺳﺒﻊ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻤﺮ ﻳﻄﻠﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺼﻔﺔ.
ينظر: ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﻻﺑﻦ ﺣﺠﺮ (4 / 264)
🔸وعن ﻣﻌﺎﻭية ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ عنه، مرفوعا: «ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻟﻴﻠﺔ ﺳﺒﻊ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ». ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻓﻲ ﺳﻨﻨﻪ (2 / 53)
📌 ﻭالصحيح وقفه، ﻭﻻ ﻳﺼﺢ مرفوعا.
💦 ﻭﻗﺎﻝ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ: ﻧﺤﻦ ﻧﻘﻮﻝ ﻫﻲ ﻟﻴﻠﺔ ﺳﺒﻊ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﻟِﻤَﺎ ﺟﺎﺀﻧﺎ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ.
▪ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ الإمامين ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ بن راهويه.
📕 ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺍﺑﻦ ﺭﺟﺐ: ﻭﻣﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻟﻴﻠﺔ ﺳﺒﻊ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ: ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﺫﺭ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﻷﻭﺍﺧﺮ، ﻭأﻧﻪ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺛﻠﺚ ﺍﻟﻠﻴﻞ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻠﻴﻞ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﺣﺘﻰ ﺧﺸﻮﺍ ﺃﻥ ﻳﻔﻮﺗﻬﻢ ﺍﻟﻔﻼﺡ، ﻭﺟﻤﻊ ﺃﻫﻠﻪ ﻟﻴﻠﺘﺌﺬ ﻭﺟﻤﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻧﺘﻬﻰ. ﻭﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﺫﺭ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻷﺭﺑﻊ، ﻭﺳﻨﺪﻩ ﺻﺤﻴﺢ.
📗 ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺭﺟﺐ: ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻨﺒﻂ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻴﻠﺔ ﺳﺒﻊ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ من ﻣﻮﺿﻌﻴﻦ:
🔸 ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ: ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺫﻛﺮ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺣﺮﻭﻓﻬﺎ ﺗﺴﻊ ﺣﺮﻭﻑ، ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻊ ﺇﺫﺍ ﺿﺮﺑﺖ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﻬﻲ ﺳﺒﻊ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ.
🔹ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ: (ﺳﻼﻡ ﻫﻲ) ﻓﻜﻠﻤﺔ "ﻫﻲ": ﻫﻲ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﻛﻠﻤﺎﺗﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﺛﻼﺛﻮﻥ ﻛﻠﻤﺔ.
📌 ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ: ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﻣﻠﺢ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ، ﻻ ﻣﻦ ﻣﺘﻴﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ.
🔸ﻗال الحافظ ابن رجب: وهو كما قال. ﻟﻄﺎﺋﻒ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ (ﺹ199-203)
🔲 تنبيه:
ما سبق ذكره المقصود من إيراده: بيان أن ليلة سبع وعشرين من أرجى ليالي العشر أن تكون ليلة القدر .
وليس المراد الجزم بذلك.
فكل ليالي العشر محتملة لأن تكون إحداها ليلة القدر، لا سيما الأوتار منها.
🌷 والله تعالى أعلم.
🌙 "ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﻥَّ ﻟﻴﻠﺔ ﺳﺒﻊ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﻫﻲ ليلة القدر" 🌙
📗 ﺃﺧﺮﺝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ (762) ﻋﻦ ﺯِﺭ ﺑﻦ ﺣُﺒﻴﺶ ﻗﺎﻝ: ﺳﻤﻌﺖُ ﺃُﺑﻲَّ ﺑﻦَ ﻛﻌﺐ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻳﻘﻮﻝ - ﻭﻗﻴﻞ ﻟﻪ: ﺇﻥ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻳﻘﻮﻝ: ﻣﻦ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺴَّﻨﺔَ ﺃﺻﺎﺏ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭ - ﻓﻘﺎﻝ ﺃُﺑَﻲٌّ: ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﻫﻮ، ﺇﻧﻬﺎ ﻟﻔﻲ ﺭﻣﻀﺎﻥ - ﻳَﺤﻠﻒ ﻣﺎ ﻳَﺴﺘﺜﻨﻲ - ﻭﻭﺍﻟﻠﻪ ﺇﻧﻲ ﻷﻋﻠﻢُ ﺃﻱَّ ﻟﻴﻠﺔٍ ﻫﻲ؛ ﻫﻲ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔُ ﺍﻟﺘﻲ ﺃَﻣﺮﻧﺎ ﺑﻬﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﻘﻴﺎﻣِﻬﺎ، ﻫﻲ ﻟﻴﻠﺔُ ﺻﺒﻴﺤﺔِ ﺳﺒﻊٍ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ، ﻭﺃﻣﺎﺭﺗُﻬﺎ ﺃﻥ ﺗَﻄﻠُﻊَ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻓﻲ ﺻﺒﻴﺤﺔ ﻳﻮﻣِﻬﺎ ﺑﻴﻀﺎﺀَ ﻻ ﺷُﻌﺎﻉ ﻟﻬﺎ.
📙 ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺃﻳﻀﺎ (1165) ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ، ﻗﺎﻝ: ﺭﺃﻯ ﺭﺟﻞ ﺃﻥ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻟﻴﻠﺔ ﺳﺒﻊ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ، ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: «ﺃَﺭﻯ ﺭُﺅﻳﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺍﻷﻭﺍﺧﺮ، ﻓﺎﻃﻠﺒﻮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺗﺮ ﻣﻨﻬﺎ».
📘 ﻭأخرج أيضا (1170) ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ، ﻗﺎﻝ: ﺗﺬﺍﻛﺮﻧﺎ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻋﻨﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎﻝ: «ﺃﻳﻜﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺣﻴﻦ ﻃﻠﻊ ﺍﻟﻘﻤﺮ، ﻭﻫﻮ ﻣﺜﻞ ﺷﻖ ﺟﻔﻨﺔ».
ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﺎﻓﺮ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ: ﺃﻱ ﻟﻴﻠﺔ ﺳﺒﻊ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻤﺮ ﻳﻄﻠﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺼﻔﺔ.
ينظر: ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﻻﺑﻦ ﺣﺠﺮ (4 / 264)
🔸وعن ﻣﻌﺎﻭية ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ عنه، مرفوعا: «ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻟﻴﻠﺔ ﺳﺒﻊ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ». ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻓﻲ ﺳﻨﻨﻪ (2 / 53)
📌 ﻭالصحيح وقفه، ﻭﻻ ﻳﺼﺢ مرفوعا.
💦 ﻭﻗﺎﻝ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ: ﻧﺤﻦ ﻧﻘﻮﻝ ﻫﻲ ﻟﻴﻠﺔ ﺳﺒﻊ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﻟِﻤَﺎ ﺟﺎﺀﻧﺎ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ.
▪ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ الإمامين ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ بن راهويه.
📕 ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺍﺑﻦ ﺭﺟﺐ: ﻭﻣﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻟﻴﻠﺔ ﺳﺒﻊ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ: ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﺫﺭ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﻷﻭﺍﺧﺮ، ﻭأﻧﻪ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺛﻠﺚ ﺍﻟﻠﻴﻞ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻠﻴﻞ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﺣﺘﻰ ﺧﺸﻮﺍ ﺃﻥ ﻳﻔﻮﺗﻬﻢ ﺍﻟﻔﻼﺡ، ﻭﺟﻤﻊ ﺃﻫﻠﻪ ﻟﻴﻠﺘﺌﺬ ﻭﺟﻤﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻧﺘﻬﻰ. ﻭﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﺫﺭ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻷﺭﺑﻊ، ﻭﺳﻨﺪﻩ ﺻﺤﻴﺢ.
📗 ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺭﺟﺐ: ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻨﺒﻂ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻴﻠﺔ ﺳﺒﻊ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ من ﻣﻮﺿﻌﻴﻦ:
🔸 ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ: ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺫﻛﺮ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺣﺮﻭﻓﻬﺎ ﺗﺴﻊ ﺣﺮﻭﻑ، ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻊ ﺇﺫﺍ ﺿﺮﺑﺖ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﻬﻲ ﺳﺒﻊ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ.
🔹ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ: (ﺳﻼﻡ ﻫﻲ) ﻓﻜﻠﻤﺔ "ﻫﻲ": ﻫﻲ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﻛﻠﻤﺎﺗﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﺛﻼﺛﻮﻥ ﻛﻠﻤﺔ.
📌 ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ: ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﻣﻠﺢ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ، ﻻ ﻣﻦ ﻣﺘﻴﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ.
🔸ﻗال الحافظ ابن رجب: وهو كما قال. ﻟﻄﺎﺋﻒ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ (ﺹ199-203)
🔲 تنبيه:
ما سبق ذكره المقصود من إيراده: بيان أن ليلة سبع وعشرين من أرجى ليالي العشر أن تكون ليلة القدر .
وليس المراد الجزم بذلك.
فكل ليالي العشر محتملة لأن تكون إحداها ليلة القدر، لا سيما الأوتار منها.
🌷 والله تعالى أعلم.
🌙بسم الله الرحمن الرحيم🌙
💫التكبير في عيد الفطر💫
🔹 قال الله جل وعلا: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ}.
▪يبدأ وقت التكبير للعيد - على الراجح من أقوال أهل العلم فيما ذكره ابن المنذر رحمه الله -: عند الخروج إلى المصلى لصلاة العيد.
🔺 قال ابن المنذر: وإن كبَّر ليلةَ الفطر، فلا بأس به، لأنه ذِكْرٌ لله عز وجل.
💡 قال: واختلف أهل العلم في التكبير ليلة الفطر، فقال أكثر أهل العلم: يُكبِّرون إذا غَدوا إلى المصلى، كان ابن عمر يفعل ذلك، ورُوى ذلك عن علي بن أبي طالب، وأبي أمامة الباهلي، وأبي رُهم، وناس من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.
▪وكان الشافعي يقول: "إذا رُؤي هلال شوال أحب أن يكبّر الناس جماعة، وفرادى فلا يزالون يكبرون ويظهرون التكبير حتى يغدوا إلى المصلى، وحتى يخرج الإمام للصلاة، وكذلك أحب في ليلة الأضحى لمن لم يحج.
🔹 قال ابن المنذر: بالقول الأول أقول، لأن ذلك قد رَويناه عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجماعة من التابعين، وهو قول أكثر أهل العلم.
📗 ينظر الإشراف على مذاهب العلماء (باختصار2/ 159)
🌀 ويدل على ما تقدم:
📙 ما أخرجه الفريابي في أحكام العيدين (39)بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أنه كان يُكبِّرُ إذا غدا إلى المصلى يومَ العيد).
📘 وأخرج أيضا (ص١١٧) بإسناد صحيح عن ابن أبي ذئب، قال: سألت ابن شهاب عن التكبير ليلة الفطر، فقال: التكبير يوم الفطر. وترك ليلة الفطر.
📙 وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم: يَنبغي لهم إذا غَدوا إلى المصلَّى كبَّروا، فإذا جَلَسُوا كَبَّروا، فإذا جاء الإمامُ صَمتوا، فإذا كبَّر الإمامُ كبَّروا، ولا يُكبِّرون إذا جاء الإمامُ إلا بتكبيرِه، حتى إذا فَرَغَ، وانقضتِ الصلاة فقد انقضى العيد.
أخرجه الطبري في تفسيره (2/ 157).
والله تعالى أعلم.
📝 عبدالباري بن حماد الأنصاري
💫التكبير في عيد الفطر💫
🔹 قال الله جل وعلا: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ}.
▪يبدأ وقت التكبير للعيد - على الراجح من أقوال أهل العلم فيما ذكره ابن المنذر رحمه الله -: عند الخروج إلى المصلى لصلاة العيد.
🔺 قال ابن المنذر: وإن كبَّر ليلةَ الفطر، فلا بأس به، لأنه ذِكْرٌ لله عز وجل.
💡 قال: واختلف أهل العلم في التكبير ليلة الفطر، فقال أكثر أهل العلم: يُكبِّرون إذا غَدوا إلى المصلى، كان ابن عمر يفعل ذلك، ورُوى ذلك عن علي بن أبي طالب، وأبي أمامة الباهلي، وأبي رُهم، وناس من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.
▪وكان الشافعي يقول: "إذا رُؤي هلال شوال أحب أن يكبّر الناس جماعة، وفرادى فلا يزالون يكبرون ويظهرون التكبير حتى يغدوا إلى المصلى، وحتى يخرج الإمام للصلاة، وكذلك أحب في ليلة الأضحى لمن لم يحج.
🔹 قال ابن المنذر: بالقول الأول أقول، لأن ذلك قد رَويناه عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجماعة من التابعين، وهو قول أكثر أهل العلم.
📗 ينظر الإشراف على مذاهب العلماء (باختصار2/ 159)
🌀 ويدل على ما تقدم:
📙 ما أخرجه الفريابي في أحكام العيدين (39)بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أنه كان يُكبِّرُ إذا غدا إلى المصلى يومَ العيد).
📘 وأخرج أيضا (ص١١٧) بإسناد صحيح عن ابن أبي ذئب، قال: سألت ابن شهاب عن التكبير ليلة الفطر، فقال: التكبير يوم الفطر. وترك ليلة الفطر.
📙 وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم: يَنبغي لهم إذا غَدوا إلى المصلَّى كبَّروا، فإذا جَلَسُوا كَبَّروا، فإذا جاء الإمامُ صَمتوا، فإذا كبَّر الإمامُ كبَّروا، ولا يُكبِّرون إذا جاء الإمامُ إلا بتكبيرِه، حتى إذا فَرَغَ، وانقضتِ الصلاة فقد انقضى العيد.
أخرجه الطبري في تفسيره (2/ 157).
والله تعالى أعلم.
📝 عبدالباري بن حماد الأنصاري
💥 مما ورد في التهنئة بالعيد
1⃣ أثر جبير بن نفير رحمه الله:
كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد؛ يقول بعضهم لبعض: (تقبل الله منا ومنكم).
📗 أخرجه المحاملي في صلاة العيدين (رقم 154).
🔹وقال الحافظ (الفتح 2 /446): (إسناده حسن عن جبير بن نفير).
وهو كما قال.
2⃣ أثر محمد بن زياد الألهاني رحمه الله:
كنا نأتي أبا أمامة وواثلة - رضي الله عنهما - في الفطر والأضحى ونقول لهما: (تقبل الله منا ومنكم)، فيقولان: (ومنكم، ومنكم).
📙 أخرجه الطحاوي في "المختصر"، وبنحوه الشجري في "الأمالي".
وهو حسن لغيره. 🔸قال حرب الكرماني: سئل أحمد عن قول الناس في العيدين: (تقبل الله منا ومنكم). قال: لا بأس به؛ يرويه الناس عن أبي أمامة. قيل: وواثلة؟ قال: نعم.
قيل: فلا تكره أن يقال هذا يوم العيد؟ قال: لا.
🔹ونقل ابن قدامة عن الإمام أحمد أيضا تجويدَ هذا الأثر.
1⃣ أثر جبير بن نفير رحمه الله:
كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد؛ يقول بعضهم لبعض: (تقبل الله منا ومنكم).
📗 أخرجه المحاملي في صلاة العيدين (رقم 154).
🔹وقال الحافظ (الفتح 2 /446): (إسناده حسن عن جبير بن نفير).
وهو كما قال.
2⃣ أثر محمد بن زياد الألهاني رحمه الله:
كنا نأتي أبا أمامة وواثلة - رضي الله عنهما - في الفطر والأضحى ونقول لهما: (تقبل الله منا ومنكم)، فيقولان: (ومنكم، ومنكم).
📙 أخرجه الطحاوي في "المختصر"، وبنحوه الشجري في "الأمالي".
وهو حسن لغيره. 🔸قال حرب الكرماني: سئل أحمد عن قول الناس في العيدين: (تقبل الله منا ومنكم). قال: لا بأس به؛ يرويه الناس عن أبي أمامة. قيل: وواثلة؟ قال: نعم.
قيل: فلا تكره أن يقال هذا يوم العيد؟ قال: لا.
🔹ونقل ابن قدامة عن الإمام أحمد أيضا تجويدَ هذا الأثر.
🔲 تقبل الله منا ومنكم، وأعاده علينا وعليكم في خير وعافية🔲
💫ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ💫
🔴 ﻓﻀﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻋﺸﺮ ﺫﻱ الحجة
🔹 ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ:
"ﻣﺎ ﻣﻦ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻓﻴﻬﻦ ﺃﺣﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﺸﺮ"، ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ: ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﻻ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻠﻪ؟
ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: "ﻭﻻ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻠﻪ، ﺇﻻ ﺭﺟﻞ ﺧﺮﺝ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻭﻣﺎﻟﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﺮﺟﻊ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﺸﻲﺀ".
📗 ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ، ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭﺍﻟﻠﻔﻆ ﻟﻪ.
🌺 يدﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ الصالح ﻓﻲ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺃﺣﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ سائر الأيام.
💦 فعلى المسلم أن يغتنم هذه ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻭﻣﻨﻬﺎ:
1⃣ ـ ﻛﺜﺮﺓ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
🔸ﻭﺃﻓﻀﻠﻪ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻓﺈﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ: "ﻣﻦ ﻗﺮﺃ ﺣﺮﻓﺎ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻠﻪ ﺣﺴﻨﺔ، ﻭﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﺑﻌﺸﺮ ﺃﻣﺜﺎﻟﻬﺎ ﻻ ﺃﻗﻮﻝ: ﺃﻟﻢ ﺣﺮﻑ، ﻭﻟﻜﻦ: ﺃﻟﻒ ﺣﺮﻑ، ﻭﻻﻡ ﺣﺮﻑ، ﻭﻣﻴﻢ ﺣﺮﻑ".
🔹 ﻭﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺢ ﻭﺍﻟﺘﺤﻤﻴﺪ ﻭﺍﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻬﻠﻴﻞ.
🔺 ﻭﺍﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﺍﻹﻛﺜﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺩﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ: [ﻭﻳﺬﻛﺮﻭﺍ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ].
🔹 ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻫﻲ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﻋﻨﺪ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ.
🔸ﻭﻛﺎﻥ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻭﺃﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻳﺨﺮﺟﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﻓﻴﻜﺒﺮﺍﻥ ﻭﻳﻜﺒﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺘﻜﺒﻴﺮﻫﻤﺎ.
والتكبير من أخص الأذكار في عشر ذي الحجة.
ويكثر كذلك من التسبيح والتحميد والتهليل:
🔺 فقد ﻗﺎﻝ رسول ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: "ﻷﻥ ﺃﻗﻮﻝ ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ، ﻭﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻛﺒﺮ، ﺃﺣﺐ ﺇﻟﻲ ﻣﻤﺎ ﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﻤﺲ" ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ.
🔺 وﻗﺎﻝ عليه الصلاة والسلام: "ﻛﻠﻤﺘﺎﻥ ﺧﻔﻴﻔﺘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ، ﺛﻘﻴﻠﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ، ﺣﺒﻴﺒﺘﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ: ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺑﺤﻤﺪﻩ، ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ".
🔺 ﻭﻗﺎﻝ: "ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ، ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻠﻚ، ﻭﻟﻪ ﺍﻟﺤﻤﺪ، ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻗﺪﻳﺮ، ﻋﺸﺮ ﻣﺮﺍﺕ: ﻛﺎﻥ ﻛﻤﻦ ﺃﻋﺘﻖ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻧﻔﺲ ﻣﻦ ﻭﻟﺪ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ"
🔺 ﻭﻗﺎﻝ: "ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ، ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻠﻚ، ﻭﻟﻪ ﺍﻟﺤﻤﺪ، ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻗﺪﻳﺮ، ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﺮﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻋﺪﻝ ﻋﺸﺮ ﺭﻗﺎﺏ ﻭﻛﺘﺒﺖ ﻟﻪ ﻣﺎﺋﺔ ﺣﺴﻨﺔ، ﻭﻣﺤﻴﺖ ﻋﻨﻪ ﻣﺎﺋﺔ ﺳﻴﺌﺔ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﺣﺮﺯﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻳﻮﻣﻪ ﺫﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﺴﻲ، ﻭﻟﻢ ﻳﺄﺕ ﺃﺣﺪ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻣﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﻪ ﺇﻻ ﺭﺟﻞ ﻋﻤﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ"
🔺 ﻭﻗﺎﻝ:"ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺑﺤﻤﺪﻩ، ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﻣﺌﺔ ﻣﺮﺓ، ﺣﻄﺖ ﺧﻄﺎﻳﺎﻩ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺜﻞ ﺯﺑﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮ".
🔹 ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺫﻛﺎﺭ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺍﻟﻠﻴﻠﺔ، ﻭﻣﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﺩﺑﺮ ﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﺫﻛﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭﺓ.
🔹 والإكثار من الاستغفار فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "طُوبَى لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيرًا ".
🌙 ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﺝ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺮ ﻓﺎﻹﻛﺜﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺗﻬﻤﺎ.
2⃣ - ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺒﻜﻴﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ.
ﻭﺍﻻﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺫﺍﻥ ﻭﺍﻹﻗﺎﻣﺔ.
🔺ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻇﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ (ﺍﻟﺜﻨﺘﻲ ﻋﺸﺮﺓ ﺭﻛﻌﺔ)، ﻭﺻﻼﺓ ﺍﻟﻀﺤﻰ، ﻭﺍﻟﻮﺗﺮ.
فقد ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: "ﻋﻠﻴﻚ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﺩ، ﻓﺈﻧﻚ ﻟﻦ ﺗﺴﺠﺪ ﻟﻠﻪ ﺳﺠﺪﺓ ﺇﻻ ﺭﻓﻌﻚ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻬﺎ ﺩﺭﺟﺔ، ﻭﺣﻂ ﻋﻨﻚ ﺑﻬﺎ ﺧﻄﻴﺌﺔ".
3⃣ - ﺍﻟﺤﺞ ﻭﺍﻟﻌﻤﺮﺓ، ﻭﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ.
وعن أبى هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة".
4⃣ - ﺻﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻊ ﺍﻷﻭﻝ - ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﺣﺪﻳﺚٌ ﻓﻲ ﺻﻮﻡ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻬﺎ – إلا ما جاء في صوم ﻳﻮﻡ ﻋﺮﻓﺔ.
🔸 والصوم ﻣﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ، ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: "ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﺍﺑﻦ ﺁﺩﻡ ﻳﻀﺎﻋﻒ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﺑﻌﺸﺮ ﺃﻣﺜﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ ﺿﻌﻒ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﺇﻻ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻲ ﻭﺃﻧﺎ ﺃﺟﺰﻱ ﺑﻪ؛ ﻳﺪﻉ ﺷﻬﻮﺗﻪ ﻭﻃﻌﺎﻣﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻲ".
🔺 وﻳﺨﺺ ﻣﻨﻬﺎ غير الحاج ﻳﻮﻡ ﻋﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻣﻪ، ﻟﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ أﻧﻪ: "ﻳﻜﻔﺮ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ".
5⃣ - ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﻳﺔ: ﻛﺎﻟﺼﺪﻗﺔ، ﻭﺇﻃﻌﺎﻡ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ، ﻭﺻﻠﺔ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ، ﻭﺗﻔﺮﻳﺞ ﻛﺮﺏ ﺍﻟﻤﻬﻤﻮﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﺴﺮﻳﻦ، والدعوة وتعليم العلم:
🔸ﻓﻌﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﺭﺟﻼ ﺳﺄﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﺃﻱ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺧﻴﺮ؟ ﻗﺎﻝ: "ﺗﻄﻌﻢ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ، ﻭﺗﻘﺮﺃ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻋﺮﻓﺖَ ﻭﻣﻦ ﻟﻢ ﺗﻌﺮﻑ".
🔹 ﻭﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ:"ﻣﻦ ﺗﺼﺪﻕ ﺑﻌﺪﻝ ﺗﻤﺮﺓ ﻣﻦ ﻛﺴﺐ ﻃﻴﺐ، ﻭﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﻘﺒﻠﻬﺎ ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ، ﺛﻢ ﻳُﺮﺑﻴﻬﺎ ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻳﺮﺑﻲ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻓَﻠُﻮَّﻩ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺠﺒﻞ".
🔸ﻭﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: "ﻣﻦ ﻓﺮﺝ ﻋﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻛﺮﺑﺔً ﻓﺮﺝ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺑﻬﺎ ﻛﺮﺑﺔً ﻣﻦ ﻛﺮﺏ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ".
6⃣ - ﻭﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﻟﺪﺍﻩ موجودين أو أحدهما، ﻓﻤﻦ ﺃﻋﻈﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺑﺮﻫﻤﺎ، ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻤﺎ، ﻭﺧﺪﻣﺘﻬﻤﺎ.
🔴 ﻓﻀﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻋﺸﺮ ﺫﻱ الحجة
🔹 ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ:
"ﻣﺎ ﻣﻦ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻓﻴﻬﻦ ﺃﺣﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﺸﺮ"، ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ: ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﻻ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻠﻪ؟
ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: "ﻭﻻ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻠﻪ، ﺇﻻ ﺭﺟﻞ ﺧﺮﺝ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻭﻣﺎﻟﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﺮﺟﻊ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﺸﻲﺀ".
📗 ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ، ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭﺍﻟﻠﻔﻆ ﻟﻪ.
🌺 يدﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ الصالح ﻓﻲ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺃﺣﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ سائر الأيام.
💦 فعلى المسلم أن يغتنم هذه ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻭﻣﻨﻬﺎ:
1⃣ ـ ﻛﺜﺮﺓ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
🔸ﻭﺃﻓﻀﻠﻪ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻓﺈﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ: "ﻣﻦ ﻗﺮﺃ ﺣﺮﻓﺎ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻠﻪ ﺣﺴﻨﺔ، ﻭﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﺑﻌﺸﺮ ﺃﻣﺜﺎﻟﻬﺎ ﻻ ﺃﻗﻮﻝ: ﺃﻟﻢ ﺣﺮﻑ، ﻭﻟﻜﻦ: ﺃﻟﻒ ﺣﺮﻑ، ﻭﻻﻡ ﺣﺮﻑ، ﻭﻣﻴﻢ ﺣﺮﻑ".
🔹 ﻭﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺢ ﻭﺍﻟﺘﺤﻤﻴﺪ ﻭﺍﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻬﻠﻴﻞ.
🔺 ﻭﺍﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﺍﻹﻛﺜﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺩﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ: [ﻭﻳﺬﻛﺮﻭﺍ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ].
🔹 ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻫﻲ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﻋﻨﺪ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ.
🔸ﻭﻛﺎﻥ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻭﺃﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻳﺨﺮﺟﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﻓﻴﻜﺒﺮﺍﻥ ﻭﻳﻜﺒﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺘﻜﺒﻴﺮﻫﻤﺎ.
والتكبير من أخص الأذكار في عشر ذي الحجة.
ويكثر كذلك من التسبيح والتحميد والتهليل:
🔺 فقد ﻗﺎﻝ رسول ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: "ﻷﻥ ﺃﻗﻮﻝ ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ، ﻭﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻛﺒﺮ، ﺃﺣﺐ ﺇﻟﻲ ﻣﻤﺎ ﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﻤﺲ" ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ.
🔺 وﻗﺎﻝ عليه الصلاة والسلام: "ﻛﻠﻤﺘﺎﻥ ﺧﻔﻴﻔﺘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ، ﺛﻘﻴﻠﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ، ﺣﺒﻴﺒﺘﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ: ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺑﺤﻤﺪﻩ، ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ".
🔺 ﻭﻗﺎﻝ: "ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ، ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻠﻚ، ﻭﻟﻪ ﺍﻟﺤﻤﺪ، ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻗﺪﻳﺮ، ﻋﺸﺮ ﻣﺮﺍﺕ: ﻛﺎﻥ ﻛﻤﻦ ﺃﻋﺘﻖ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻧﻔﺲ ﻣﻦ ﻭﻟﺪ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ"
🔺 ﻭﻗﺎﻝ: "ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ، ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻠﻚ، ﻭﻟﻪ ﺍﻟﺤﻤﺪ، ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻗﺪﻳﺮ، ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﺮﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻋﺪﻝ ﻋﺸﺮ ﺭﻗﺎﺏ ﻭﻛﺘﺒﺖ ﻟﻪ ﻣﺎﺋﺔ ﺣﺴﻨﺔ، ﻭﻣﺤﻴﺖ ﻋﻨﻪ ﻣﺎﺋﺔ ﺳﻴﺌﺔ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﺣﺮﺯﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻳﻮﻣﻪ ﺫﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﺴﻲ، ﻭﻟﻢ ﻳﺄﺕ ﺃﺣﺪ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻣﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﻪ ﺇﻻ ﺭﺟﻞ ﻋﻤﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ"
🔺 ﻭﻗﺎﻝ:"ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺑﺤﻤﺪﻩ، ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﻣﺌﺔ ﻣﺮﺓ، ﺣﻄﺖ ﺧﻄﺎﻳﺎﻩ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺜﻞ ﺯﺑﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮ".
🔹 ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺫﻛﺎﺭ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺍﻟﻠﻴﻠﺔ، ﻭﻣﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﺩﺑﺮ ﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﺫﻛﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭﺓ.
🔹 والإكثار من الاستغفار فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "طُوبَى لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيرًا ".
🌙 ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﺝ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺮ ﻓﺎﻹﻛﺜﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺗﻬﻤﺎ.
2⃣ - ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺒﻜﻴﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ.
ﻭﺍﻻﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺫﺍﻥ ﻭﺍﻹﻗﺎﻣﺔ.
🔺ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻇﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ (ﺍﻟﺜﻨﺘﻲ ﻋﺸﺮﺓ ﺭﻛﻌﺔ)، ﻭﺻﻼﺓ ﺍﻟﻀﺤﻰ، ﻭﺍﻟﻮﺗﺮ.
فقد ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: "ﻋﻠﻴﻚ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﺩ، ﻓﺈﻧﻚ ﻟﻦ ﺗﺴﺠﺪ ﻟﻠﻪ ﺳﺠﺪﺓ ﺇﻻ ﺭﻓﻌﻚ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻬﺎ ﺩﺭﺟﺔ، ﻭﺣﻂ ﻋﻨﻚ ﺑﻬﺎ ﺧﻄﻴﺌﺔ".
3⃣ - ﺍﻟﺤﺞ ﻭﺍﻟﻌﻤﺮﺓ، ﻭﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ.
وعن أبى هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة".
4⃣ - ﺻﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻊ ﺍﻷﻭﻝ - ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﺣﺪﻳﺚٌ ﻓﻲ ﺻﻮﻡ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻬﺎ – إلا ما جاء في صوم ﻳﻮﻡ ﻋﺮﻓﺔ.
🔸 والصوم ﻣﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ، ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: "ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﺍﺑﻦ ﺁﺩﻡ ﻳﻀﺎﻋﻒ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﺑﻌﺸﺮ ﺃﻣﺜﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ ﺿﻌﻒ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﺇﻻ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻲ ﻭﺃﻧﺎ ﺃﺟﺰﻱ ﺑﻪ؛ ﻳﺪﻉ ﺷﻬﻮﺗﻪ ﻭﻃﻌﺎﻣﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻲ".
🔺 وﻳﺨﺺ ﻣﻨﻬﺎ غير الحاج ﻳﻮﻡ ﻋﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻣﻪ، ﻟﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ أﻧﻪ: "ﻳﻜﻔﺮ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ".
5⃣ - ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﻳﺔ: ﻛﺎﻟﺼﺪﻗﺔ، ﻭﺇﻃﻌﺎﻡ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ، ﻭﺻﻠﺔ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ، ﻭﺗﻔﺮﻳﺞ ﻛﺮﺏ ﺍﻟﻤﻬﻤﻮﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﺴﺮﻳﻦ، والدعوة وتعليم العلم:
🔸ﻓﻌﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﺭﺟﻼ ﺳﺄﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﺃﻱ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺧﻴﺮ؟ ﻗﺎﻝ: "ﺗﻄﻌﻢ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ، ﻭﺗﻘﺮﺃ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻋﺮﻓﺖَ ﻭﻣﻦ ﻟﻢ ﺗﻌﺮﻑ".
🔹 ﻭﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ:"ﻣﻦ ﺗﺼﺪﻕ ﺑﻌﺪﻝ ﺗﻤﺮﺓ ﻣﻦ ﻛﺴﺐ ﻃﻴﺐ، ﻭﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﻘﺒﻠﻬﺎ ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ، ﺛﻢ ﻳُﺮﺑﻴﻬﺎ ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻳﺮﺑﻲ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻓَﻠُﻮَّﻩ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺠﺒﻞ".
🔸ﻭﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: "ﻣﻦ ﻓﺮﺝ ﻋﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻛﺮﺑﺔً ﻓﺮﺝ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺑﻬﺎ ﻛﺮﺑﺔً ﻣﻦ ﻛﺮﺏ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ".
6⃣ - ﻭﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﻟﺪﺍﻩ موجودين أو أحدهما، ﻓﻤﻦ ﺃﻋﻈﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺑﺮﻫﻤﺎ، ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻤﺎ، ﻭﺧﺪﻣﺘﻬﻤﺎ.
🔺ﻓﻌﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ: ﺳﺄﻟﺖ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﺃﻱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﺣﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ؟ ﻗﺎﻝ: "ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺘﻬﺎ"ﻗﻠﺖ: ﺛﻢ ﺃﻱ؟ ﻗﺎﻝ:"ﺑﺮ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ"ﻗﻠﺖ: ﺛﻢ ﺃﻱ؟ ﻗﺎﻝ:"ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻠﻪ".
7⃣ - ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻴﺪ.
🔸 ﻭﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻻ ﻳﺆﺧﺮﻫﺎ ﻋﻨﻪ، ﻟﻜﻲ ﻳﺪﺭﻙَ ﻓﻀﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﺸﺮ، ﻓﺈن ذبح الأضحية ﻣﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑيوم العيد، ﻭﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﻓﻘﺪ ﺿﺤَّﻰ ﺑﻜﺒﺸﻴﻦ ﺃﻣﻠﺤﻴﻦ، ﺫﺑﺤﻬﻤﺎ ﺑﻴﺪﻩ، ﻭﺳﻤَّﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻭﻛﺒَّﺮ.
💡وختاما:
من الآداب الشرعية المستحبة في هذه العشر لمن أراد أن يُضحي ألا يأخذ من شعره أو بشره أو أظفاره شيئا حتى يذبح أضحيته، وذلك لما ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺴﻠﻢ في صحيحه ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﻡ ﺳﻠﻤﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ: ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ: «ﺇﺫﺍ ﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﻌﺸﺮ، ﻭﺃﺭﺍﺩ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﺃﻥ ﻳﻀﺤﻲ، ﻓﻼ ﻳﻤﺲ ﻣﻦ ﺷﻌﺮﻩ ﻭﺑﺸﺮﻩ ﺷﻴﺌﺎ»، ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ: ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺫﺑﺢ ﻳﺬﺑﺤﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻫﻞ ﻫﻼﻝ ﺫﻱ ﺍﻟﺤﺠﺔ، ﻓﻼ ﻳﺄﺧﺬﻥ ﻣﻦ ﺷﻌﺮﻩ، ﻭﻻ ﻣﻦ ﺃﻇﻔﺎﺭﻩ ﺷﻴﺌﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻀﺤﻲ».
ﻭﻓﻘﻨﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﻻﻏﺘﻨﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﻈﻴﻤﺔ، ﻭﺣﺴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ.
🌺 ﻭﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤًﺎ ﻛﺜﻴﺮًا.
7⃣ - ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻴﺪ.
🔸 ﻭﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻻ ﻳﺆﺧﺮﻫﺎ ﻋﻨﻪ، ﻟﻜﻲ ﻳﺪﺭﻙَ ﻓﻀﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﺸﺮ، ﻓﺈن ذبح الأضحية ﻣﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑيوم العيد، ﻭﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﻓﻘﺪ ﺿﺤَّﻰ ﺑﻜﺒﺸﻴﻦ ﺃﻣﻠﺤﻴﻦ، ﺫﺑﺤﻬﻤﺎ ﺑﻴﺪﻩ، ﻭﺳﻤَّﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻭﻛﺒَّﺮ.
💡وختاما:
من الآداب الشرعية المستحبة في هذه العشر لمن أراد أن يُضحي ألا يأخذ من شعره أو بشره أو أظفاره شيئا حتى يذبح أضحيته، وذلك لما ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺴﻠﻢ في صحيحه ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﻡ ﺳﻠﻤﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ: ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ: «ﺇﺫﺍ ﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﻌﺸﺮ، ﻭﺃﺭﺍﺩ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﺃﻥ ﻳﻀﺤﻲ، ﻓﻼ ﻳﻤﺲ ﻣﻦ ﺷﻌﺮﻩ ﻭﺑﺸﺮﻩ ﺷﻴﺌﺎ»، ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ: ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺫﺑﺢ ﻳﺬﺑﺤﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻫﻞ ﻫﻼﻝ ﺫﻱ ﺍﻟﺤﺠﺔ، ﻓﻼ ﻳﺄﺧﺬﻥ ﻣﻦ ﺷﻌﺮﻩ، ﻭﻻ ﻣﻦ ﺃﻇﻔﺎﺭﻩ ﺷﻴﺌﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻀﺤﻲ».
ﻭﻓﻘﻨﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﻻﻏﺘﻨﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﻈﻴﻤﺔ، ﻭﺣﺴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ.
🌺 ﻭﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤًﺎ ﻛﺜﻴﺮًا.
💫بسم الله الرحمن الرحيم💫
❄ التكبير المطلق والتكبير المقيد❄
▪ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد.
🔴 التكبير المطلق: هو التكبير الذي لم يقيد بأدبار الصلوات المكتوبة.
فيُشرع للمسلم إذا دخلت عشر ذي الحجة أن يكبر في كل وقت تيسر له.
💡 لما ثبت عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما: أنهما كانا يخرجان أيام العشر إلى السوق فيُكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، لا يأتيان السوقَ إلا لذلك.
📙 أخرجه الفاكهي في "أخبار مكة" والمروزي في "العيدين" وإسناده حسن.
🔴 وأما التكبير المقيد: فهو التكبير دبر الصلوات المكتوبة، ويبدأ وقته من فجر يوم عرفة، إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق.
🔸 لما ورد:
1⃣ عن علي رضي الله عنه:
أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يومَ عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، يكبر بعد صلاة العصر.
📗 رواه الإمام أحمد في مسائل عبدالله، وابن المنذر في الأوسط والمحاملي في العيدين وهو حسن لغيره.
🔹 قال الإمام أحمد: هذا تكبير علي، ونحن نأخذ به. 📕مسائل عبدالله (2 / 432).
2⃣ ما رواه ابن أبي شيبة وابن المنذر والمحاملي؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما:
(أنه كان يكبر من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق لا يكبر في المغرب: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد).
💥 وإسناده صحيح.
3⃣ ما أخرجه ابن المنذر في الأوسط، والفاكهي في أخبار مكة؛ عن نافع:
(أن ابن عمر كان يكبر بمنى تلك الأيام خلف الصلوات وفي فسطاطه وفي ممشاه - الأيام جميعا).
💡وإسناده صحيح لغيره.
📌 تنبيهات:
1⃣ يَبدأ التكبير المقيد لغير الحاج من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق كما تقدم في أثر علي رضي الله عنه.
2⃣ يَبدأ التكبير المقيد للحاج من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق.
3⃣ للحاج أن يجمع بين التلبية والتكبير يومَ عرفة؛ فعن محمد بن أبي بكر الثقفي: أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يُهل منا المُهل فلا يُنكر عليه، ويكبر المكبر فلا يُنكر عليه.
📗 أخرجه البخاري ومسلم.
🔹والإهلال: رفع الصوت بالتلبية.
4⃣ هل يُقدم التكبير المقيد على الاستغفار، أو يكون بعده؟
📌 فمن يرى أن التكبير يكون بعد السلام مباشرة:
فإنه يقول: إن الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يكبرون بعد الصلوات وخلفها.
والظاهر أنهم لا يفصلون بين الصلاة والتكبير بشيء ... ولو كان لنُقل عنهم.
والتكبير شعار تلك الأيام فيخص بالتقديم فيها على الاستغفار.
📌 ومن أهل العلم من يرى تقديم الاستغفار على التكبير؛ لعموم حديث ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا...الحديث.
▪ والأول أولى؛ لخصوصية التكبير بهذه الأيام.
والله تعالى أعلم.
🖌 عبد الباري بن حماد الأنصاري.
❄ التكبير المطلق والتكبير المقيد❄
▪ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد.
🔴 التكبير المطلق: هو التكبير الذي لم يقيد بأدبار الصلوات المكتوبة.
فيُشرع للمسلم إذا دخلت عشر ذي الحجة أن يكبر في كل وقت تيسر له.
💡 لما ثبت عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما: أنهما كانا يخرجان أيام العشر إلى السوق فيُكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، لا يأتيان السوقَ إلا لذلك.
📙 أخرجه الفاكهي في "أخبار مكة" والمروزي في "العيدين" وإسناده حسن.
🔴 وأما التكبير المقيد: فهو التكبير دبر الصلوات المكتوبة، ويبدأ وقته من فجر يوم عرفة، إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق.
🔸 لما ورد:
1⃣ عن علي رضي الله عنه:
أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يومَ عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، يكبر بعد صلاة العصر.
📗 رواه الإمام أحمد في مسائل عبدالله، وابن المنذر في الأوسط والمحاملي في العيدين وهو حسن لغيره.
🔹 قال الإمام أحمد: هذا تكبير علي، ونحن نأخذ به. 📕مسائل عبدالله (2 / 432).
2⃣ ما رواه ابن أبي شيبة وابن المنذر والمحاملي؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما:
(أنه كان يكبر من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق لا يكبر في المغرب: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد).
💥 وإسناده صحيح.
3⃣ ما أخرجه ابن المنذر في الأوسط، والفاكهي في أخبار مكة؛ عن نافع:
(أن ابن عمر كان يكبر بمنى تلك الأيام خلف الصلوات وفي فسطاطه وفي ممشاه - الأيام جميعا).
💡وإسناده صحيح لغيره.
📌 تنبيهات:
1⃣ يَبدأ التكبير المقيد لغير الحاج من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق كما تقدم في أثر علي رضي الله عنه.
2⃣ يَبدأ التكبير المقيد للحاج من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق.
3⃣ للحاج أن يجمع بين التلبية والتكبير يومَ عرفة؛ فعن محمد بن أبي بكر الثقفي: أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يُهل منا المُهل فلا يُنكر عليه، ويكبر المكبر فلا يُنكر عليه.
📗 أخرجه البخاري ومسلم.
🔹والإهلال: رفع الصوت بالتلبية.
4⃣ هل يُقدم التكبير المقيد على الاستغفار، أو يكون بعده؟
📌 فمن يرى أن التكبير يكون بعد السلام مباشرة:
فإنه يقول: إن الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يكبرون بعد الصلوات وخلفها.
والظاهر أنهم لا يفصلون بين الصلاة والتكبير بشيء ... ولو كان لنُقل عنهم.
والتكبير شعار تلك الأيام فيخص بالتقديم فيها على الاستغفار.
📌 ومن أهل العلم من يرى تقديم الاستغفار على التكبير؛ لعموم حديث ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا...الحديث.
▪ والأول أولى؛ لخصوصية التكبير بهذه الأيام.
والله تعالى أعلم.
🖌 عبد الباري بن حماد الأنصاري.
🔲 تقبل الله منا ومنكم، وأعاده علينا وعليكم في خير وعافية🔲
💫 بسم الله الرحمن الرحيم💫
🔴 كيف يُحصِّل طالب العلم
الفائدة المنشودة من قراءة الكتب
والاطلاع عليها
▪الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحيه أجمعين وبعد.
📌 ونحن في أول شهر من هذا العام الدراسي، ونفوس طلبة العلم تتطلع إلى حسن التحصيل في دراستهم، وسلوكِ أنجع السبل فيما يزيد في علمهم، وتمكنهم من تخصصاتهم.
ومعلومٌ أن المداومة على القراءة والاطلاع في كتب العلماء بمختلف أنواعها = مما يُؤصلُ الطالبَ علميًّا، ويزيدُه معرفة وثقافة، ويُرقيه في مدارج العلم والطلب، بتوفيق الله تعالى.
وإن كنا في عصر قد ابتلي الكثيرُ بوسائل التواصل الحديثة، حتى صارت هي الأنيسَ والجليس، والشغلَ والشاغل، والأعمارُ فيها تمضي، واللحظات والساعات بها تنقضي، فأشغلت العقول وأذهلت القلوب.
إلا أنَّ العاقل لا يسمحُ لنفسه أن يسترسل معها، فتضيعَ عليها أوقاتُه، ويذهبَ عمُرُه دون حاصل ولا طائل.
💡ولستُ هنا بصدد الكلام على مطلق القُرَّاء ومحبي الكتب، ولكن كما جاء في العنوان قصدتُ بهذه المقالة طلبةَ العلم على وجه الخصوص.
فإن أغلبهم يُحب القراءة والاطلاع، ويَشغَف بالكتاب، ويتمنى أن يكون قارئًا مستفيدًا حقَّ الاستفادة، ومحصِّلاً من الكتب عيونَ فوائدها ودُررَ قلائدها.
ولكنَّ نيلَ المطالب لا يكون بالأُمنيات، ولا بمجرد المحبة تتحقق الرغَبات.
🔹🔸 فهذه بعض الأمور المهمة، التي يُرجى بالتوفُّرِ عليها تحققُ الاستفادة من القراءة والاطلاع، فهي - مع حسن القصد والإخلاص لله في الطلب - لها كبيرُ الأثر في تحقق المطلوب وحصول المأمول، إن شاء الله تعالى:
1⃣ـ أن يُعدَّ الطالب نفسه جيدًا للقراءة والاطلاع:
فإن للاستفادة من قراءة الكتب وسائلَ وآلات، فإنِ استعدَّ بها القارئ، وكان امتلاكُه لها أجود = حصل له الفائدة المرجوة بإذن الله.
ومعلوم أنَّ مؤلفاتِ أهل العلم كُتبت بلغة فصيحة، وبيانٍ ربما يكون في بعضها عاليًا، فيلزم الطالب أن تكون معرفته باللغة العربية ـ نحوِها ومفرداتِها وأساليبِها – جيِّدًا.
فيدرسَ النحوَ وأهمَّ قواعده، ويعرف قدرًا صالحًا من علم التصريف، ويعتني بمراجعة مفردات اللغة المشكلة عليه في مظانها من كتب اللغة.
ولا يغفُل عن أن تكون معرفته بأصول الفقه وأهم مسائله ومصطلحاته حسنة، فإنه السبيل إلى التفقه الصحيح في الكتاب والسنة، وفهم كلام أهل العلم واستنباطاتِهم بعد معرفة اللغة العربية وإتقانها.
وكل علمٍ من العلوم له مصطلحاته الخاصة به، فإذا تناول كتابا في علمٍ ما فينبغي أن يكون عارفًا بمعاني أكثر ما يدور على ألسنة أهله من مصطلحات.
وما خفي عليه منها، فتَّش عنه في مظانه وكلامِ أهل ذلك العلم.
وكثيرٌ مما يُشكِل من مصطلحات العلوم يُتعرَّف عليه في حِلَق العلمِ ومن أفواه العلماء والمتخصصين.
فكلما كان تحصيلُ الطالب على شيوخه أقوى وأقعد، كان فهمه لها أصح وأجود.
ولذلك تسربت كثيرٌ من الأخطاء والأغلاط إلى من كان جُلُّ تحصيله من الكتب ولم يلازم حلق العلم، وأغفل تلقيه عن أهله.
2⃣ تحديد أهدافه من القراءة:
فإن هناك فرقا كبيرًا بين من يقرأ للمتعة وتزجية الوقت، فيقرأ في كتب القصص والأخبار، والروايات والأشعار = وبين من يقرأ ليحصل علمًا، ويشحذَ ذهنًا، ويُقوّيَ معارفَه، ويوسِّعَ مداركَه.
فينبغي لطالب العلم أن يعرف هدفه، ليُحقق غرضه من قراءته لذلك الكتاب بحسب نوعه.
فبعض الكتب لا يلزمه فيها استيعابُ قراءتها، بل يكفيها مراجعتها عند الحاجة فقط، كبعض المطولات في الفقه والحديث واللغة.
وإن كان بعض العلماء لجَلَدِهم وعلو همتهم - عُرِف عنهم استقراء عدد من المطولات في علوم مختلفة.
نعم، إذا تمكَّن الطالب علميَّا فله أن يسلك هذا المسلك في قراءة المطولات، لكنها في الواقع مرحلةُ نائيةُ الشَّوْط بعيدةُ الشأْو، لا تُستحسن للطالب المبتدئ، فقد تضره أكثر مما تنفعه، وكان السلفُ يحبون أن يبدأوا بصغار العلمِ قبل كباره. =
🔴 كيف يُحصِّل طالب العلم
الفائدة المنشودة من قراءة الكتب
والاطلاع عليها
▪الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحيه أجمعين وبعد.
📌 ونحن في أول شهر من هذا العام الدراسي، ونفوس طلبة العلم تتطلع إلى حسن التحصيل في دراستهم، وسلوكِ أنجع السبل فيما يزيد في علمهم، وتمكنهم من تخصصاتهم.
ومعلومٌ أن المداومة على القراءة والاطلاع في كتب العلماء بمختلف أنواعها = مما يُؤصلُ الطالبَ علميًّا، ويزيدُه معرفة وثقافة، ويُرقيه في مدارج العلم والطلب، بتوفيق الله تعالى.
وإن كنا في عصر قد ابتلي الكثيرُ بوسائل التواصل الحديثة، حتى صارت هي الأنيسَ والجليس، والشغلَ والشاغل، والأعمارُ فيها تمضي، واللحظات والساعات بها تنقضي، فأشغلت العقول وأذهلت القلوب.
إلا أنَّ العاقل لا يسمحُ لنفسه أن يسترسل معها، فتضيعَ عليها أوقاتُه، ويذهبَ عمُرُه دون حاصل ولا طائل.
💡ولستُ هنا بصدد الكلام على مطلق القُرَّاء ومحبي الكتب، ولكن كما جاء في العنوان قصدتُ بهذه المقالة طلبةَ العلم على وجه الخصوص.
فإن أغلبهم يُحب القراءة والاطلاع، ويَشغَف بالكتاب، ويتمنى أن يكون قارئًا مستفيدًا حقَّ الاستفادة، ومحصِّلاً من الكتب عيونَ فوائدها ودُررَ قلائدها.
ولكنَّ نيلَ المطالب لا يكون بالأُمنيات، ولا بمجرد المحبة تتحقق الرغَبات.
🔹🔸 فهذه بعض الأمور المهمة، التي يُرجى بالتوفُّرِ عليها تحققُ الاستفادة من القراءة والاطلاع، فهي - مع حسن القصد والإخلاص لله في الطلب - لها كبيرُ الأثر في تحقق المطلوب وحصول المأمول، إن شاء الله تعالى:
1⃣ـ أن يُعدَّ الطالب نفسه جيدًا للقراءة والاطلاع:
فإن للاستفادة من قراءة الكتب وسائلَ وآلات، فإنِ استعدَّ بها القارئ، وكان امتلاكُه لها أجود = حصل له الفائدة المرجوة بإذن الله.
ومعلوم أنَّ مؤلفاتِ أهل العلم كُتبت بلغة فصيحة، وبيانٍ ربما يكون في بعضها عاليًا، فيلزم الطالب أن تكون معرفته باللغة العربية ـ نحوِها ومفرداتِها وأساليبِها – جيِّدًا.
فيدرسَ النحوَ وأهمَّ قواعده، ويعرف قدرًا صالحًا من علم التصريف، ويعتني بمراجعة مفردات اللغة المشكلة عليه في مظانها من كتب اللغة.
ولا يغفُل عن أن تكون معرفته بأصول الفقه وأهم مسائله ومصطلحاته حسنة، فإنه السبيل إلى التفقه الصحيح في الكتاب والسنة، وفهم كلام أهل العلم واستنباطاتِهم بعد معرفة اللغة العربية وإتقانها.
وكل علمٍ من العلوم له مصطلحاته الخاصة به، فإذا تناول كتابا في علمٍ ما فينبغي أن يكون عارفًا بمعاني أكثر ما يدور على ألسنة أهله من مصطلحات.
وما خفي عليه منها، فتَّش عنه في مظانه وكلامِ أهل ذلك العلم.
وكثيرٌ مما يُشكِل من مصطلحات العلوم يُتعرَّف عليه في حِلَق العلمِ ومن أفواه العلماء والمتخصصين.
فكلما كان تحصيلُ الطالب على شيوخه أقوى وأقعد، كان فهمه لها أصح وأجود.
ولذلك تسربت كثيرٌ من الأخطاء والأغلاط إلى من كان جُلُّ تحصيله من الكتب ولم يلازم حلق العلم، وأغفل تلقيه عن أهله.
2⃣ تحديد أهدافه من القراءة:
فإن هناك فرقا كبيرًا بين من يقرأ للمتعة وتزجية الوقت، فيقرأ في كتب القصص والأخبار، والروايات والأشعار = وبين من يقرأ ليحصل علمًا، ويشحذَ ذهنًا، ويُقوّيَ معارفَه، ويوسِّعَ مداركَه.
فينبغي لطالب العلم أن يعرف هدفه، ليُحقق غرضه من قراءته لذلك الكتاب بحسب نوعه.
فبعض الكتب لا يلزمه فيها استيعابُ قراءتها، بل يكفيها مراجعتها عند الحاجة فقط، كبعض المطولات في الفقه والحديث واللغة.
وإن كان بعض العلماء لجَلَدِهم وعلو همتهم - عُرِف عنهم استقراء عدد من المطولات في علوم مختلفة.
نعم، إذا تمكَّن الطالب علميَّا فله أن يسلك هذا المسلك في قراءة المطولات، لكنها في الواقع مرحلةُ نائيةُ الشَّوْط بعيدةُ الشأْو، لا تُستحسن للطالب المبتدئ، فقد تضره أكثر مما تنفعه، وكان السلفُ يحبون أن يبدأوا بصغار العلمِ قبل كباره. =
💥 أما أهداف الطالب من قراءته فمتنوعة منها:
🔸🔹 أ- التأصيل العلمي:
ويلزمه فيه مراعاةُ التدرج في الكتب التي يُطالعها، وحُسن الاختيار لها، فيُقدِّم الأقل حجمًا، والأوضح عبارةً، والأكثرَ أصالةً في ذلك العلم.
وإذا مرت به بعض المشكلات العلمية قيدها ولم يُهملها؛ ليراجع حلَّ إشكالها في مطولاتها أو مع أساتذته وغيرهم من المتخصصين.
وكذلك يفعل مع الكلمات الغريبة لغويًّا أو المصطلحات المشكلة.
وهذه القراءة ينبغي أن تكون مع التأمل وحُسن التفهم لكلام المؤلف، وألا تكون على طريقة المرور السريع، إلا إذا كان ينوي قراءة الكتاب مرةً أخرى.
وهنا ننبه على أن بعض الكتب ينبغي تَكرار قراءتها؛ لعظيم أهميتها، وغزارة فوائدها على المتعلم، حتى قيل: إن قراءة كتابٍ جيدٍ ثلاثَ مراتٍ خيرٌ من قراءةِ ثلاثةِ كتبٍ جيدة.
وقرأ المزني كتاب الرسالة للإمام الشافعي خمسمائة مرة.
وقرأ غالب بن عطية صحيح الإمام البخاري سبعمائة مرة.
ولُقِّب بعض العلماء بأسماء بعض الكتب؛ لكثرة تكرارهم لها كـ"الفصيحي" و"المنهاجي" وغيرهما.
🔹🔸 ب - التذوق الأدبي والصناعي:
فقد يكون من أهداف الطالب من القراءة والاطلاع اكتسابُ الملكة الأدبية في الكتابة، والتذوقُ لبيان العلماء والأدباء، وهو مقصد شريف.
فيختار الطالب الكتب التي عُرفت بحسن بيانها وجمال لغتها، فيكثر من مطالعتها، وتكرارِ ما تضمنته من بديع النثر ورائق الشعر.
فإن لذلك أثرًا معروفًا في اكتساب البيان وحسن الأسلوب.
وأما التذوق الصناعي فالمراد به: معرفة كيف يؤلف العلماء كتبهم، ويحسنون سبكها وترتيبها، وكيف يقيمون حججهم العلمية، وينقضون أدلة خصومهم، والأساليب العلمية والبحثية التي يسلكونها في ذلك.
فإنه مع تأمل الطالب لهذه المطالب، وكثرة ما يقرؤه من المصنفات والمؤلفات = يكتسب معرفةً يستطيع بها أن يقتدي بأولئك العلماء ويسلك منهجهم في التصنيف والتأليف.
🔹🔸 ج ـ جمع مادة علمية لأبحاثه ومؤلفاته:
ومثل هذه القراءة ينبغي أن تعم كل ما يخدم موضوع بحثه أو مؤلَّفه.
ولا يقتصر فيها على جمع مادة البحث عن طريق برامج الحاسب، بل يلزمه تتبعها واستقراؤها بنفسه من خلال المطالعة في مظانها، وكما قيل:
الجمع واجبٌ متى ما أمكنا
💡وللحديث بقية إن شاء الله تعالى.
📝 عبدالباري بن حماد الأنصاري
🔸🔹 أ- التأصيل العلمي:
ويلزمه فيه مراعاةُ التدرج في الكتب التي يُطالعها، وحُسن الاختيار لها، فيُقدِّم الأقل حجمًا، والأوضح عبارةً، والأكثرَ أصالةً في ذلك العلم.
وإذا مرت به بعض المشكلات العلمية قيدها ولم يُهملها؛ ليراجع حلَّ إشكالها في مطولاتها أو مع أساتذته وغيرهم من المتخصصين.
وكذلك يفعل مع الكلمات الغريبة لغويًّا أو المصطلحات المشكلة.
وهذه القراءة ينبغي أن تكون مع التأمل وحُسن التفهم لكلام المؤلف، وألا تكون على طريقة المرور السريع، إلا إذا كان ينوي قراءة الكتاب مرةً أخرى.
وهنا ننبه على أن بعض الكتب ينبغي تَكرار قراءتها؛ لعظيم أهميتها، وغزارة فوائدها على المتعلم، حتى قيل: إن قراءة كتابٍ جيدٍ ثلاثَ مراتٍ خيرٌ من قراءةِ ثلاثةِ كتبٍ جيدة.
وقرأ المزني كتاب الرسالة للإمام الشافعي خمسمائة مرة.
وقرأ غالب بن عطية صحيح الإمام البخاري سبعمائة مرة.
ولُقِّب بعض العلماء بأسماء بعض الكتب؛ لكثرة تكرارهم لها كـ"الفصيحي" و"المنهاجي" وغيرهما.
🔹🔸 ب - التذوق الأدبي والصناعي:
فقد يكون من أهداف الطالب من القراءة والاطلاع اكتسابُ الملكة الأدبية في الكتابة، والتذوقُ لبيان العلماء والأدباء، وهو مقصد شريف.
فيختار الطالب الكتب التي عُرفت بحسن بيانها وجمال لغتها، فيكثر من مطالعتها، وتكرارِ ما تضمنته من بديع النثر ورائق الشعر.
فإن لذلك أثرًا معروفًا في اكتساب البيان وحسن الأسلوب.
وأما التذوق الصناعي فالمراد به: معرفة كيف يؤلف العلماء كتبهم، ويحسنون سبكها وترتيبها، وكيف يقيمون حججهم العلمية، وينقضون أدلة خصومهم، والأساليب العلمية والبحثية التي يسلكونها في ذلك.
فإنه مع تأمل الطالب لهذه المطالب، وكثرة ما يقرؤه من المصنفات والمؤلفات = يكتسب معرفةً يستطيع بها أن يقتدي بأولئك العلماء ويسلك منهجهم في التصنيف والتأليف.
🔹🔸 ج ـ جمع مادة علمية لأبحاثه ومؤلفاته:
ومثل هذه القراءة ينبغي أن تعم كل ما يخدم موضوع بحثه أو مؤلَّفه.
ولا يقتصر فيها على جمع مادة البحث عن طريق برامج الحاسب، بل يلزمه تتبعها واستقراؤها بنفسه من خلال المطالعة في مظانها، وكما قيل:
الجمع واجبٌ متى ما أمكنا
💡وللحديث بقية إن شاء الله تعالى.
📝 عبدالباري بن حماد الأنصاري
💥 من أهداف طالب العلم في قراءته واطلاعه:
🔹🔸 د ـ القراءة لترقيق القلب، وتهذيب الأخلاق، والتحلي بالآداب الشرعية:
ولا شك أن أصل ذلك وأعلاه: القراءةُ في كتاب الله جل وعز، وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر معلوم معروف عند طلبة العلم.
إلا أن حديثَنا هاهنا يتعلق بالقراءة في الكتب التي صنفها أهل العلم، في خدمة الكتاب والسنة، ووسائل التفقه فيهما.
💡فالقراءة في كتب الزهد والرقائق، وسيرِ الربانيين من العلماء والزهاد والعباد = مما يفيد الطالب في الاقتداء بهم في إخلاصهم، وحُسن تعبدهم، وعنايتهم بأعمال القلوب، ومسارعتهم في الطاعات، وبعدهم عن المعاصي والسيئات.
📌 فإنَّ العلم غرسٌ يَحتاج إلى تربة صالحة نقية من الشوائب، حتى ينمو ويؤتي أُكَله.
فلذلك صنف أئمة أهل العلم في هذا الباب كالإمام عبد الله بن المبارك والإمام أحمد وأبي داود وغيرهم، وضمنه بعض أهل العلم كتبهم ككتاب الرِّقاق من صحيح الإمام البخاري.
واعتنى بعض العلماء المتأخرين بهذا الباب عناية متميزة، كالإمام ابن القيم والحافظ ابن رجب في تصانيف عديدة لهما.
كما أنَّ كتب التراجم زاخرةٌ بتلك الرقائق والصور المشرقة لأولئك العلماء الذين تعلموا، وعملوا بعلمهم، وعلموه غيرَهم، مع تحليهم بنبيل الأوصاف، ورفيع الأخلاق.
رُوي عن الإمام أبي حنيفة أنه قال: الحكايات عن العلماء ومحاسنهم أحبُّ إليَّ من كثير من الفقه لأنها آداب القوم.
🔸🔹هـ القراءة للاعتبار والاتعاظ:
فطالب العلم لا غنى له عن الاطلاع على كتب التواريخ وأخبار الماضين، فإنها كما قيل: تجارِب المتقدمين مرايا المتأخرين، كما يُبصَر فيها ما كان، يُتَبصَّرُ بها فيما سيكون.
🔹🔸 وـ القراءة لمعرفة آداب طالب العلم، وأخلاق العلماء، وبدايات العلوم وتاريخها، وأهم تصانيفها:
والمؤلفات في ذلك كثيرة، ومن كتب المحدثين المشهورة التي صُنفت في هذا الباب: "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" للخطيب البغدادي، و"جامع بيان العلم وفضله" للحافظ ابن عبدالبر.
وفيما يختص بذكر المؤلفات والمصنفات وابتداء التصنيف فيها، فإن كتب الفهارس والبرامج والأثبات قد حوت مادة وافرةٍ منها.
وفي مقدمات بعض الكتب الكبار تطرقٌ لذلك، كما في مقدمة النووي للمجموع، ومقدمة ابن خَلدون لتاريخه، ومقدمة حاجي خليفة لكتابه "كشف الظنون".
🌀 فهذه ستة أهداف قد يعتني بتحقيقها طالب العلم في أثناء قراءته، أو بتحقيق بعضها، فينبغي أن يراعي كلًا بحسبه، من حيث كيفية القراءة، ومصادرِها، وتقديمِ المهم فالمهم.
🔺 وأما الأمر الثالث من الأمور التي ينبغي مراعاتها لتكون القراءة نافعة ومفيدة فهو:
3⃣ـ تقييد الفوائد والشوارد:
فقد كان من عادة العلماء المتعارف عليها بينهم، ويراها المتصفحون لمقتنياتهم من الكتب = أن يدونوا عناوين ما يقفون عليه من الفوائد النفيسة، والمسائل العلمية المحررة، خصوصًا ما كان منها في غير مظانه، وتمسُّ الحاجة إلى معرفته.
فإنهم يُقيدونها إما في أول ورقة بياض من الكتاب، أو في بطانة غلافه.
وذلك ليقفوا على موضعها بيُسر عند الحاجة إليها.
وتختلف أساليبهم في التقييد، فإضافة إلى ما سبق فإنَّ بعضهم قد يُقيد تلك الفوائد في ورقة مفردة خارج الكتاب، أو في دفتر كناش خاص.
وكل ذلك حسنٌ، فالمهم: ألا يدعَ التقييد، فيقعَ في بلية الإهمال، خصوصًا الفوائد العزيزة، التي وقف عليها في غير مظانها – كما تقدم -، أو ما وجده منها مخبأً في ضمن سفر كبير أو أسفار عديدة، يَعسر عليه استخراجه منها إذا احتاج إليه.
📌 وأنبِّه هنا على أمر قد يغفُل عنه المبتدئون، وهو:
أن حُسن الانتقاء يكون بحسب جودة التحصيل والتأصيل للطالب.
فإذا كان الطالب متمكنًا في تحصيله، متميِّزا في تأصيله، فإنه ينتقي أحسن ما في تلك الكتب وأنفعه، وإذا كان ضعيف التحصيل والتأصيل ظن الزُّجاج لؤلؤا، والنحاس ذهبًا.
فلذلك لا ينبغي أن يَغتر الطالبُ بسوابق منتقياته، فالغالب أنها ضعيفةٌ بقدر ما كان عليه من الضعف في بداياته، لكنها لا تخلو من فائدة، ولو لم يكن إلا أنها دلته على أنه ترقى في العلم وقوي، حتى صار ينظر إلى معرفته السابقة بعين الازدرا، بعد أن كان ينظر إليها بعين الرضا، لو لم يكن إلا ذلك لكفى. =
🔹🔸 د ـ القراءة لترقيق القلب، وتهذيب الأخلاق، والتحلي بالآداب الشرعية:
ولا شك أن أصل ذلك وأعلاه: القراءةُ في كتاب الله جل وعز، وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر معلوم معروف عند طلبة العلم.
إلا أن حديثَنا هاهنا يتعلق بالقراءة في الكتب التي صنفها أهل العلم، في خدمة الكتاب والسنة، ووسائل التفقه فيهما.
💡فالقراءة في كتب الزهد والرقائق، وسيرِ الربانيين من العلماء والزهاد والعباد = مما يفيد الطالب في الاقتداء بهم في إخلاصهم، وحُسن تعبدهم، وعنايتهم بأعمال القلوب، ومسارعتهم في الطاعات، وبعدهم عن المعاصي والسيئات.
📌 فإنَّ العلم غرسٌ يَحتاج إلى تربة صالحة نقية من الشوائب، حتى ينمو ويؤتي أُكَله.
فلذلك صنف أئمة أهل العلم في هذا الباب كالإمام عبد الله بن المبارك والإمام أحمد وأبي داود وغيرهم، وضمنه بعض أهل العلم كتبهم ككتاب الرِّقاق من صحيح الإمام البخاري.
واعتنى بعض العلماء المتأخرين بهذا الباب عناية متميزة، كالإمام ابن القيم والحافظ ابن رجب في تصانيف عديدة لهما.
كما أنَّ كتب التراجم زاخرةٌ بتلك الرقائق والصور المشرقة لأولئك العلماء الذين تعلموا، وعملوا بعلمهم، وعلموه غيرَهم، مع تحليهم بنبيل الأوصاف، ورفيع الأخلاق.
رُوي عن الإمام أبي حنيفة أنه قال: الحكايات عن العلماء ومحاسنهم أحبُّ إليَّ من كثير من الفقه لأنها آداب القوم.
🔸🔹هـ القراءة للاعتبار والاتعاظ:
فطالب العلم لا غنى له عن الاطلاع على كتب التواريخ وأخبار الماضين، فإنها كما قيل: تجارِب المتقدمين مرايا المتأخرين، كما يُبصَر فيها ما كان، يُتَبصَّرُ بها فيما سيكون.
🔹🔸 وـ القراءة لمعرفة آداب طالب العلم، وأخلاق العلماء، وبدايات العلوم وتاريخها، وأهم تصانيفها:
والمؤلفات في ذلك كثيرة، ومن كتب المحدثين المشهورة التي صُنفت في هذا الباب: "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" للخطيب البغدادي، و"جامع بيان العلم وفضله" للحافظ ابن عبدالبر.
وفيما يختص بذكر المؤلفات والمصنفات وابتداء التصنيف فيها، فإن كتب الفهارس والبرامج والأثبات قد حوت مادة وافرةٍ منها.
وفي مقدمات بعض الكتب الكبار تطرقٌ لذلك، كما في مقدمة النووي للمجموع، ومقدمة ابن خَلدون لتاريخه، ومقدمة حاجي خليفة لكتابه "كشف الظنون".
🌀 فهذه ستة أهداف قد يعتني بتحقيقها طالب العلم في أثناء قراءته، أو بتحقيق بعضها، فينبغي أن يراعي كلًا بحسبه، من حيث كيفية القراءة، ومصادرِها، وتقديمِ المهم فالمهم.
🔺 وأما الأمر الثالث من الأمور التي ينبغي مراعاتها لتكون القراءة نافعة ومفيدة فهو:
3⃣ـ تقييد الفوائد والشوارد:
فقد كان من عادة العلماء المتعارف عليها بينهم، ويراها المتصفحون لمقتنياتهم من الكتب = أن يدونوا عناوين ما يقفون عليه من الفوائد النفيسة، والمسائل العلمية المحررة، خصوصًا ما كان منها في غير مظانه، وتمسُّ الحاجة إلى معرفته.
فإنهم يُقيدونها إما في أول ورقة بياض من الكتاب، أو في بطانة غلافه.
وذلك ليقفوا على موضعها بيُسر عند الحاجة إليها.
وتختلف أساليبهم في التقييد، فإضافة إلى ما سبق فإنَّ بعضهم قد يُقيد تلك الفوائد في ورقة مفردة خارج الكتاب، أو في دفتر كناش خاص.
وكل ذلك حسنٌ، فالمهم: ألا يدعَ التقييد، فيقعَ في بلية الإهمال، خصوصًا الفوائد العزيزة، التي وقف عليها في غير مظانها – كما تقدم -، أو ما وجده منها مخبأً في ضمن سفر كبير أو أسفار عديدة، يَعسر عليه استخراجه منها إذا احتاج إليه.
📌 وأنبِّه هنا على أمر قد يغفُل عنه المبتدئون، وهو:
أن حُسن الانتقاء يكون بحسب جودة التحصيل والتأصيل للطالب.
فإذا كان الطالب متمكنًا في تحصيله، متميِّزا في تأصيله، فإنه ينتقي أحسن ما في تلك الكتب وأنفعه، وإذا كان ضعيف التحصيل والتأصيل ظن الزُّجاج لؤلؤا، والنحاس ذهبًا.
فلذلك لا ينبغي أن يَغتر الطالبُ بسوابق منتقياته، فالغالب أنها ضعيفةٌ بقدر ما كان عليه من الضعف في بداياته، لكنها لا تخلو من فائدة، ولو لم يكن إلا أنها دلته على أنه ترقى في العلم وقوي، حتى صار ينظر إلى معرفته السابقة بعين الازدرا، بعد أن كان ينظر إليها بعين الرضا، لو لم يكن إلا ذلك لكفى. =
🔹🔸4ـ تكرار القراءة، والرجوع إلى التقييدات السابقة:
تقدمت الإشارة إلى أن بعض الكتب يحتاج إلى قراءة لأكثر من مرة، وأن تعدد قراءته يزيد الطالب علما ورسوخًا.
ولذلك نجدُ بعضَ العلماء يكرر تدريس كتبًا ومتونًا معينةً مراتٍ عديدة، ولا يسأمُ من ذلك، لما خَبره من جودة تلك الكتب وحسنِ تأليفها وعِظَمِ فائدتها ومنفعتِها.
إلا أنَّ هذا التكرار لا يكون لكل كتاب، نعمْ الكتب التي بالوصف المذكور يستحسن تكرارها وإعادتها ربما مرات ومرات.
وأيضًا لا شك أن قراءة كتاب جديد أخفُّ على النفس وأروح لها، فهي تتشوف للجديد، وترغب في الطريف، وتسأم من التكرار، وتكسل معه.
🌀 وينبغي للطالب من وقت ووقت = الرجوعُ إلى منتقياته من الكتب التي قرأها، فيُعيد النظر فيها، فإن ذلك يجعله أكثر استحضارًا لها، وأحسن معرفة بالكتب التي وردت فيها.
🔹🔸 5ـ الاستمرار مدة طويلة في القراءة ومصاحبة الكتاب:
فإن مواصلةَ الطلب، وعدم الانقطاع عن القراءة والاطلاع، والنَّهمَ المستمر فيهما .. كلُّ ذلك كفيلٌ - بتوفيق الله - أن يغزر معه علم الطالب، وتكثر معلوماتُه، وتتنوع معارفُه.
💡وهذا لا يحصل في الزمان القليل، بل يحتاج إلى مرور سنين طويلة، حتى يرى الطالبُ الثمرةَ الحقيقية لمطالعاتِه، والفائدة المرجوة من قراءاتِه.
ولا شكَّ أنَ الطالب النَّهِمَ المتيَّمَ بالكتب وقراءتها، سيُعرف تميزه بين أقرانه في مدة قصيرة، لأنه صرف غالب وقته في هذا الشأن، فنضجت ثمرته فيه في وقت أقصر.
💥 والعلم كما يقال في العبارة المعاصرة: (تراكمي) فكلما بُذل في تحصيله الوقت والجهد المعتبرين = تحصَّل منه ما يليق بذلك الوقت والجهد المبذولينِ فيه.
📌 ولكن لا يعزب عن الطالب اليقظ أن مقتبل العمر ينبغي أن يَصرِفَ منه حظًّا لا بأس به في حفظ المتون وتعاهدها، ولا يَقصُر وقتَه على القراءة والاطلاع فقط، فليُتفطَّن لذلك، والله الموفق.
🔴 الخلاصة:
تقدم أن مما تتحقق به الفائدة المنشودة من قراءة الكتب والاطلاع لطالب العلم أمورًا خمسة:
1⃣ ـ أن يُعدَّ الطالب نفسه جيدًا للقراءة والاطلاع.
2⃣ - أن يُحدِّد أهدافه من القراءة.
3⃣ ـ أن يُقيِّد الفوائد والشوارد.
4⃣ - أن يُكرِّر القراءة، وأن يعاود الرجوع إلى التقييدات السابقة لانتقاءاته.
5⃣ -أن يستمر مدة طويلة في القراءة ومصاحبة الكتاب.
💥 ولخصنا أهداف الطالب بقراءته في ستة أهداف هي:
1ـ التأصيل العلمي.
2 ـ التذوق الأدبي والصناعي.:
3 ـ جمع مادَّة علمية لأبحاثه ومؤلفاته – إذا تأهَّل لذلك -.
4ـ القراءة لترقيق القلب وتهذيب الأخلاق والتحلي بالآداب الشرعية.
5 ـ القراءة للاعتبار والاتعاظ.
6ـ القراءة لمعرفة آداب طالب العلم وأخلاق العلماء، وبدايات العلوم وتاريخها، وأهم تصانيفها.
🌀 فهذه بعض الأمور المهمة التي يُرجى بتحققها - إن شاء الله - أن يُحصِّل الطالب ما يُؤمِّل من منافع عديدة، ومقاصد سديدة، مِنْ قراءته في مختلف الكتب والمصنفات.
وربما فات بعض المهم من ذلك فذُهِل عنه ولم يُذكر، وعُذرنا أنَّ ما لا يدرك كله لا يترك كله، وما عسر استحضاره اكتُفِي منه بما تيسَّر.
💡والله تعالى الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
📝 عبدالباري بن حماد الأنصاري
تقدمت الإشارة إلى أن بعض الكتب يحتاج إلى قراءة لأكثر من مرة، وأن تعدد قراءته يزيد الطالب علما ورسوخًا.
ولذلك نجدُ بعضَ العلماء يكرر تدريس كتبًا ومتونًا معينةً مراتٍ عديدة، ولا يسأمُ من ذلك، لما خَبره من جودة تلك الكتب وحسنِ تأليفها وعِظَمِ فائدتها ومنفعتِها.
إلا أنَّ هذا التكرار لا يكون لكل كتاب، نعمْ الكتب التي بالوصف المذكور يستحسن تكرارها وإعادتها ربما مرات ومرات.
وأيضًا لا شك أن قراءة كتاب جديد أخفُّ على النفس وأروح لها، فهي تتشوف للجديد، وترغب في الطريف، وتسأم من التكرار، وتكسل معه.
🌀 وينبغي للطالب من وقت ووقت = الرجوعُ إلى منتقياته من الكتب التي قرأها، فيُعيد النظر فيها، فإن ذلك يجعله أكثر استحضارًا لها، وأحسن معرفة بالكتب التي وردت فيها.
🔹🔸 5ـ الاستمرار مدة طويلة في القراءة ومصاحبة الكتاب:
فإن مواصلةَ الطلب، وعدم الانقطاع عن القراءة والاطلاع، والنَّهمَ المستمر فيهما .. كلُّ ذلك كفيلٌ - بتوفيق الله - أن يغزر معه علم الطالب، وتكثر معلوماتُه، وتتنوع معارفُه.
💡وهذا لا يحصل في الزمان القليل، بل يحتاج إلى مرور سنين طويلة، حتى يرى الطالبُ الثمرةَ الحقيقية لمطالعاتِه، والفائدة المرجوة من قراءاتِه.
ولا شكَّ أنَ الطالب النَّهِمَ المتيَّمَ بالكتب وقراءتها، سيُعرف تميزه بين أقرانه في مدة قصيرة، لأنه صرف غالب وقته في هذا الشأن، فنضجت ثمرته فيه في وقت أقصر.
💥 والعلم كما يقال في العبارة المعاصرة: (تراكمي) فكلما بُذل في تحصيله الوقت والجهد المعتبرين = تحصَّل منه ما يليق بذلك الوقت والجهد المبذولينِ فيه.
📌 ولكن لا يعزب عن الطالب اليقظ أن مقتبل العمر ينبغي أن يَصرِفَ منه حظًّا لا بأس به في حفظ المتون وتعاهدها، ولا يَقصُر وقتَه على القراءة والاطلاع فقط، فليُتفطَّن لذلك، والله الموفق.
🔴 الخلاصة:
تقدم أن مما تتحقق به الفائدة المنشودة من قراءة الكتب والاطلاع لطالب العلم أمورًا خمسة:
1⃣ ـ أن يُعدَّ الطالب نفسه جيدًا للقراءة والاطلاع.
2⃣ - أن يُحدِّد أهدافه من القراءة.
3⃣ ـ أن يُقيِّد الفوائد والشوارد.
4⃣ - أن يُكرِّر القراءة، وأن يعاود الرجوع إلى التقييدات السابقة لانتقاءاته.
5⃣ -أن يستمر مدة طويلة في القراءة ومصاحبة الكتاب.
💥 ولخصنا أهداف الطالب بقراءته في ستة أهداف هي:
1ـ التأصيل العلمي.
2 ـ التذوق الأدبي والصناعي.:
3 ـ جمع مادَّة علمية لأبحاثه ومؤلفاته – إذا تأهَّل لذلك -.
4ـ القراءة لترقيق القلب وتهذيب الأخلاق والتحلي بالآداب الشرعية.
5 ـ القراءة للاعتبار والاتعاظ.
6ـ القراءة لمعرفة آداب طالب العلم وأخلاق العلماء، وبدايات العلوم وتاريخها، وأهم تصانيفها.
🌀 فهذه بعض الأمور المهمة التي يُرجى بتحققها - إن شاء الله - أن يُحصِّل الطالب ما يُؤمِّل من منافع عديدة، ومقاصد سديدة، مِنْ قراءته في مختلف الكتب والمصنفات.
وربما فات بعض المهم من ذلك فذُهِل عنه ولم يُذكر، وعُذرنا أنَّ ما لا يدرك كله لا يترك كله، وما عسر استحضاره اكتُفِي منه بما تيسَّر.
💡والله تعالى الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
📝 عبدالباري بن حماد الأنصاري